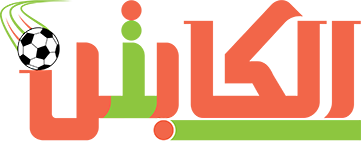جدل الضحية والمغفرة

إن ماضينا وذاكرتنا الإنسانية ترزح تحت وطأة الجريمة، ونعنى «الجريمة» التى لا يمكن أن ننعتها بواقعة قانونية فرديّة، إنما نعنى تلك الجريمة التى تتصل بماهية الوجود الإنسانى، ولذلك فإن هناك الكثير مما لا يقبل الصفح، أو مما لا يسقط بالتقادم، لا سيما الجرائم التى ينتمى معظمها إلى ما نعته «جاك دريدا» بوحشية الشر الجذرى. هذا الشر الذى أنتج الصدمة يدفعنا إلى معنى التأمل فى هذا المأزق، ومن هنا فقد أمست الصدمة أو آداب الصدمة مجالًا معرفيًا يدرس التمظهرات النصية لتجربة إنسانية من الصعب أن تتلاشى تداعياتها، وآثارها، وكما هو معلوم، فإن الصدمة تنهض على مركزية الحدث، أو ذلك الحدث المركزى الذى يحتمل صِيْغة مأساوية تنتج عنها ردة فعل شديدة الأثر قد تصل إلى حد الإنكار، كما يمكن إضافة عدم القدرة على التفسير، فضلًا عن معاودة استذكار الحدث فى صيغ مختلفة، ونعنى التمظهرات اللغوية التى يعكسها استرداد الأحداث عبر تقنية التذكر، كما صيغ الأحلام، والكوابيس، والشهادة، والسرد. يمكن تفسير ذلك بما تناوله «بول ريكور» فى كتابه «الذاكرة والتاريخ النسيان» من حيث البحث فى تداعيات الصّدمة انطلاقًا من إشكالية الذاكرة التى يرى فيها نوعًا من أنواع الصراع مع النسيان. إن إشكالية الصدمة تتصل حسب مفهوم ريكور بمسلكيات تتعلق بثنائية الجلاد والضّحيّة، بالتجاور مع ضرورة اعتراف المجرم بجريمته من أجل تحقق الغفران أو المسامحة.
تتخذ دراسة «بول ريكور» أهمية مضاعفة فى سِياق التاريخ والألم، بالتجاور مع جَدليتى التذكر والغفران، ومع أن «ريكور» يؤكد صعوبة تحقق الغفران قياسًا على بشاعة الجريمة، بَيد أنه ينطلق من تصور ذهنى يرتبط بفظاعات الحربين العالميتين، بالإضافة إلى الهولوكوست، إذ يقول: «يمكننا أن نشعر ببعض التفهم للمجرم لا أن نصفح عنه. إن الخطيئة فى ماهيتها غير قابلة للغفران ليس كواقع فقط، بل كحق كذلك»، غير أنه سرعان ما يقرن هذا الغفران بجَدلية الذاكرة، أو التذكر، لا سيما عبر المنظور الجمعى، وهذا ما يقودنا إلى إشكالية الصدمة بالتوازى مع الذاكرة، والنسيان، وما يَكمُن بينهما من جَدل، فالنسيان يمكن أن يُوصف بأنه «طعن فى وثوقنا بالذّاكرة» كما يقول.
ومن هنا، يحتمل التاريخ مقولات متعددة عن فعل التطهير العرقى أو الدينى، كما الاضطهاد والقتل العبثى، فهنالك الكثير من الضحايا الذى ينتظرون القصاص من جلاديهم، فى حين أن هنالك من يطالب بالصفح- إذا طُلب- ولكن هل يمكن أن يتحقق الصفح؟ وهل يكفى الاعتذار عن جريمة تتعالى عن وصفها الفردى؟ ونعنى تلك الجريمة التى تصيب المفهوم الإنسانى برمته لينتج عن ذلك ما يعرف بالصدمة بغض النظر عن تمظهرها! وكيف يمكن للإنسان أن يحتمل هذا القدر من البشاعة فى ظل تلاشى ملايين البشر الذين قتلوا، ورحلوا، وعذبوا لقرون بداعى الاستعباد، فى حين هنالك الملايين سقطوا فى حروب عبثية! كما ثمّة عقود من الاستعمار الذى دمر أصقاعًا كبيرة من العالم، وما زال يحدث أثره على البلدان التى احتلت، فى حين ما زالت تَرزح شعوب تحت نِير حكم ديكتاتوريات تختطف الأوطان من أجل أن تبقى فى السلطة، كما ثمّة أجيال فقدت أوطانها ضمن تسلسل توريث الهجرة والشتات، ولكن كيف يمكن تعويض عشرات الملايين من الضحايا الذين ذهبوا جراء أكذوبة صنعتها دوائر السياسة الأمريكية من أجل غزو العراق! أو كيف يمكن تعويض شعب تعيش أجيال منه وأجيال فى اللاوطن نتيجة نظام استعمارى كولونيالى؟ وهل يكفى أن تعتذر الدول الاستعمارية عما ارتكبته فى الحقبة الاستعمارية؟ وهل يمكن أن تصفح الشعوب عما قامت به النظم السلطوية، لا سيما تلك التى نتجت بعد مرحلة الاستقلال؟ وهل يمكن أن نصفح عن كيانات محتلة تطالب المحتَل بالتعايش والسلام بعد أن سلبت منه كل شىء؟
لا شك أن العقل الغربى، ونظامه الخِطابى التاريخى لا ينفك أن يبقى عالقًا باستدعاء ويلات الحربين العالميتين، بالإضافة إلى التمحور حول المحرقة والإبادة النازية التى فتئت تستعاد فى الذاكرة كونها أصابت الوعى الغربى، ومنطقه الحداثى، غير أن هذه العقلية عينها، لا تكاد تحفل بقراءة تداعيات ما فعلته العملية الاستعمارية على شعوب العالم الآخر، وتتجاهل عذابات الشعوب التى ترزح تحت نير أنظمة سلطوية.
فى كتابين للفيلسوف الفرنسى «فلاديمير جانكليفيتش» (١٩٠٣-١٩٨٥) الأول حمل عنوان «الصفح» ١٩٦٧ والثانى «ما لا يقبل التقادم» ١٩٨٦ خطاب يتناول مفهوم الصفح الذى بدا متسما بالكثير من الجَدل تجاه قابلية تحققه أو استحالته، غير أن «جانكليفتش» يُطلق نوعًا من التّعميم والمجانسة التى تطاول الوجود الألمانى برمته، كونه المسئول عن المحرقة، بل إن هذا الفيلسوف ينطلق من وضعية تقطر بالحقد والحسد على من يسألون الصفح، لا سيما من يتمتع منهم بالوفرة، والغنى، كما الصحة- على الرغم من الإدانة الكاملة للمحرقة- غير أن الغرب يتجاهل فى المقابل ممارسات الكيان الصهيونى بكل ما حملته من تداعيات تتصل بالجرائم والتهجير، وطرد شعب بأكمله من أرضه... ولكن هل يمكن لملايين الضحايا أن يصفحوا عما ارتكب فى حقهم؟ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك ما لم تُعاد الحقوق، ويُعترف بالجريمة!
لا شك أن مصطلحات المغفرة، والغفران، والصّفح، والعفو.. وغيرها من المترادفات قد شغلت مفكرى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومنهم بول ريكور، بالإضافة إلى الفيلسوف الفرنسى «فلاديمير جانكليفيتش»، كما حنة آرنت، وآخرين، غير أن جاك دريدا يختبر موقف «جانكليفيتش» من الصّفح عبر محاضرة ألقاها فى عدد من الجامعات، ونشرت فى كتاب بعنوان «الصّفح: ما لا يقبل الصّفح وما لا يقبل التقادم»، وفيها يحاول «دريدا» أن يختبر مفردة «الصّفح» ضمن متتالية من السّياقات التى تحيل الكلمة إلى تموضعها أو تحركها بين الذّات والمخاطب، إذ تتلاشى الدلالة المثبتة عندما تتنازع فعل الاعتذار ( عن / إلى/ ممن). هكذا تبدو مقاربات «دريدا» أقرب إلى نزعة جَدلية ذات طابع إرجائى، أو ربما عبثى للوهلة الأولى... إلا أنه سرعان ما يقيم حواراته حول موضوع الصّفح فى حضرة قيم التّاريخ، والمواجهة التى تنهض على إحالات لمفاهيم متدرجة تقع بين مستويات منها القانونى والأخلاقى والفلسفى، والدينى، وهنا يقيم دريدا مقاربة فوق نقدية لما جاء به «جانكليفيتش» الذى شن هجومًا على الألمان الذين أنتجوا المحرقة، وهنا ينطلق دريدا من نقد نموذج متطرف نهض به «جانكليفيتش» حين يبدد أى أمل للصفح عن شعب ارتكب جريمة لا يقبل التكفير عنها.
إن مفهوم الصّفح مفهوم بَينى مراوغ أو لزج، فهو يتراوح بين موقفين متناقضين: الضّحيّة والجلاد، فجاك دريدا يراوغ فى مجال متحرك، حيث ينقل (الاعتذار أو الصّفح) من الجلاد على ما اقترفه من ذنب كى يكون منوطًا بالضّحيّة التى يجب عليها أن تبرر وجودها، بمعنى آخر أن تعتذر عن وجودها؛ أى أن يتحول وجود الضّحيّة إلى فائض ينبغى أن يبرر، فالضّحيّة أصبحت مصدر إزعاج وتكدير صَفو الجلاد.
ناقد فلسطينى