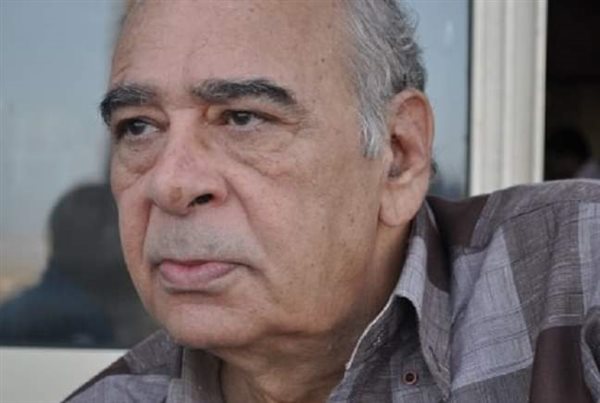الفن التحريضى والفن الثورى
نشر مكسيم جوركى روايته الشهيرة «الأم» بعد قيام الثورة الروسية الأولى عام ١٩٠٥، وعرى فيها النظام القيصرى القائم على الاضطهاد والقهر من خلال قصة العامل الروسى ميخائيل فلاسوف، وأمه، التى تتطور شخصيتها لتصبح مناضلة ورمزا لوطن ينتقل من التردد إلى الثورة، لكن الكاتب «مارك سلونيوم» كتب أن تلك الرواية «واحدة من أضعف روايات جوركى وأكثرها شعبية»، كما قال ناقد روسى كبير آخر لجوركى إن الرواية «قد تكون ضعيفة لكنها مطلوبة جدا». كانت الرواية الضعيفة مطلوبة جدا فى وقتها لأن المزاج الشعبى الثورى كان آخذا فى التراجع بعد أن اقتصرت مكاسب الثورة على دستور وبرلمان، فأشعلت الرواية الروح الثورية مجددًا بين فئات واسعة من الشعب الروسى، ومعظم الأعمال الفنية الضعيفة والمطلوبة جدا، تجسد جانبا معينا من الفن: فن التحريض.
المشكلة فى الفن أننا ننظر إليه على أنه طبقة واحدة، أو نوع واحد يشتمل فى الأدب على أعمال رفيعة لكتاب عظام مثل يوسف إدريس، ويحيى حقى، وتشيخوف، وفوكنر، وكورتاثر، وغيرهم من الفئة نفسها، لكن الحقيقة أن الفن تعبير يحيط بمجمل ظواهر الحياة، من أبسطها إلى أكثرها تعقدا، من نداءات الباعة، والأمثال الشعبية، وشعارات المظاهرات التى لا بد أن تكون مقفاة وموزونة بدءا من شعار ثورة ١٩ «الاستقلال التام أو الموت الزؤام» حتى «بنكررها جيل ورا جيل.. احنا بنكره إسرائيل». والنكتة أيضا فن، وتكاد كل نكتة أن تحتوى على عناصر السرد والموقف والحوار اللازم للقصة القصيرة. ولا يمكن مقارنة مؤلفى شعارات المظاهرات «المطلوبة جدا» بقصة يوسف إدريس «لا وقت للحب». الفن هنا يحيط بمجالين وموضوعين مختلفين، ومن ثم فإنه مرة يصبح فنا تحريضيا كما فى أزجال أحمد فؤاد نجم، ومرة يصبح فنا ثوريا عميقا كما فى رواية أبوالمعاطى أبوالنجا «العودة إلى المنفى». والفن التحريضى حالة معروفة، يكاد يشبه الفن الثورى، يتقاطع معه فى نقطة ثم يفترقان. وقد كانت أزجال أحمد فؤاد نجم لوقت طويل عملا تحريضيا متصلا وناقوسا وطنيا لا يكف عن التنبيه للمخاطر التى تحدق بالوطن، لكن ذلك لا يرفع تلك الأزجال إلى مرتبة العمل الفنى الثورى، مع محبتى البالغة وتقديرى لدور نجم الوطنى وموقفه الشريف الذى لم يهدأ. والفن التحريضى لا يحتاج إلى قدر كبير من الفن، ولا إلى قدر كبير من العمق، لأنه يخاطب طبقة سطحية من العقل. لهذا فإن رواية «الأم» قد تكون عملا تحريضيا يتقاطع بدرجة ما مع العمل الثورى، لكن قصة جوجول الشهيرة «المعطف» تظل عملا فنيا ثوريا يتضمن التحريض وليس تحريضا مكسوًا بالفن، أيضا رواية دوستويفسكى «المذلون المهانون» تبقى عملا فنيا ثوريا وتشتمل مثل كل عمل فنى ثورى على درجة من التحريض على رفض استمرار حياة البؤس. وهناك فى الأدب العربى والعالمى حالات قليلة ينصهر فيها الجانب الفنى والتحريضى فى روح واحدة، كما هى الحال مع أعمال بريخت، وأشعار أمل دنقل، وغيرهما.
وفى فترة ما امتلأ ميدان التحرير أيام انتفاضة يناير بكثيرين ممن يهتفون وينشدون ويرقصون ويطلقون الشعارات بأصوات خشنة وكلمات فظة وغناء أقرب إلى الصراخ، وظهر عدد من «الشرائط المرئية» الغنائية الكثيرة تجسد تلك الحالة فى حينها، وكان كل ذلك «مطلوبا جدا» فى حينه، لكن دور أولئك الفنانين المحرضين كان مرتبطا بتلك اللحظة التى ما إن غربت حتى غربت معها فنونهم التحريضية، وأمسى على من يريد أن يصبح «فنانا» أن يبحث عن منطقة أخرى أعمق يغترف منها الفن. فنون التحريض وليدة لحظة أو ظرف تاريخى وتخاطب القشرة السطحية من العقل والانفعال، أما الفن الثورى فإنه يتجاوز اللحظات والسنوات ويبقى يؤرق الفكر، ويثير الأسئلة، ويحرض ضمنيا، كما هى الحال فى واحدة من أعظم القصص العالمية وهى قصة تشيخوف «العنبر رقم ٦».
الفن الثورى يغير النفوس ليس بإشعال النار فيها، بل بإنضاجها ببطء ومد أشواقها إلى التغيير. وقد تكون قصة حب، كما فى روميو وجولييت، فنا ثوريا عميقا أعمق من مئات الشعارات الصارخة، ما دامت القصة تدفعك للرغبة فى تبديل الأوضاع التى تهدم غرام العشاق وتفرق بينهم. الفن الثورى يغرس الثورة بعيدا فى أعماق الشعور، أما فن التحريض فإنه يحرك الرغبة فى التغيير بالانفعال السريع. وهذا فن، وذاك فن، لكن من مناطق مختلفة وبأدوار مختلفة وبصلاحية زمنية وإنسانية مختلفة.