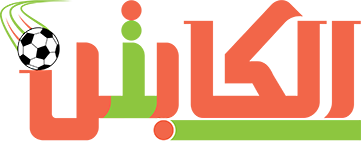التجديد الذى نريده «الأخيرة»
د. عثمان الخشت يكتب: تجديد المسلمين لا الإسلام

القسم الثانى من الفصل الخامس
٤- وحدة البنية الحاكمة للتفكير الأسطورى فى الدين والسياسة:
إن العلاقة بين «المتناهى» و«اللا متناهى» من أهم الفروق الحقيقية بين الإسلام الأول برؤيته للعالم والرؤية السحرية اللاهوتية التى تعد إحدى سمات الخطاب الدينى فى عصور التراجع؛ حيث إعادة بناء العالم طبقًا للتفكير العقلانى فى الرؤية الأولى أو إعادة بنائه طبقًا للخرافة والأسطورة فى الرؤية الثانية.
فالعلاقة بين «المتناهى» و«اللا متناهى»، أو بين الإنسان والله، تقوم فى الرؤية السحرية اللاهوتية على العلاقة بين «المتناهى» و«متناهٍ آخر» وإن كان ذا قدرة أكبر، أى العلاقة بين الإنسان من جهة والساحر والجن أو الأرواح أو الأولياء أو رجال الدين أو الأئمة من جهة أخرى.
فهى علاقة تقوم على الوساطة، وقد تكون هذه الوساطة ساحرًا أو مشعوذًا أو حتى رجل دين أو وليًا من الأولياء، وعندما يتعلق الأمر بالسياسة، فهى تقوم على وسيط سياسى يحدد معالم الحق والباطل ويحدد الصواب والخطأ، أما الفرد فهو مجرد منفذ للتعليمات والأوامر دون تفكير مستقل ودون حرية شخصية ودون رأى شجاع أو متفرد.
فالبنية الحاكمة للتفكير الأسطورى فى الدين هى نفسها البنية الحاكمة للتفكير الاتباعى الأعمى فى السياسة. ففى التفكير الدينى القائم على الرؤية السحرية اللاهوتية يكون الإنسان الفرد منسحقًا أمام الوسطاء بينه وبين الله، وفى التفكير السياسى القائم على الرؤية السحرية اللاهوتية، يكون الإنسان الفرد منسحقًا أمام المتحدث باسم الله على الأرض!
إن التفكير الدينى الأسطورى يضع «وسطاء» يشغلون المسافة الكائنة بين الإنسان والله، والتفكير السياسى الأسطورى يضع «وسطاء من نوع آخر» بين الإنسان والحق العملى.
ونجد فى التفكير الدينى الأسطورى وفى التفكير السياسى الأسطورى معًا، أن «الحق يُعرف بالرجال». فرجال محددون هم مقياس الحق والحقيقة، وليس الحق قيمة فى ذاته، ولا تنبع معاييره من داخله ولا من تطابقه مع الواقع أو مع الكتاب؛ فرجال معينون إن قالوا فقد أصابوا حتى لو كان قولهم مخالفًا لكل كتاب، وحتى لو صرخ الواقع ببطلانه!
والقداسة ليست لكتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة، بل للمزايدين على الدين، والذين يرفعون شعاراته لفظًا ومظهرًا لا سلوكًا ولا عملًا ولا دولة.
فى التفكير الدينى الأسطورى نرى القرآن للزينة المقدسة، وفى التفكير السياسى الأسطورى نرى القرآن على أسنة السيوف، وهو كلمة حق يراد بها باطل.
وفى التفكير الدينى الأسطورى يتم تقديس «الدين» أكثر من «رب الدين»، وفى التفكير السياسى الأسطورى يتم تقديس التفسير السياسى للدين على حساب مقاصده الكلية الأكثر رحابة.
وعلى عكس التفكير الدينى الأسطورى والتفكير السياسى الأسطورى، نرى الإسلام الأول لا يعطى أى مجال للوسطاء. فالعلاقة مباشرة بين «المتناهى» و«اللا متناهى»، أو بين الإنسان والله، ولا مجال لسلطة ساحر أو عفريت أو ولى أو رجل دين أو مرشد، ولا وجود لوسيط سياسى يحدد معالم الحق والباطل ويحدد الصواب والخطأ، ولا مجال للاتباع الأعمى. والحق يعرف بتطابقه مع الكتاب والواقع الخارجى المتعين، ولا وجود للمتحدثين باسم الله على الأرض، وكل البشر يصيبون ويخطئون.
إن التفكير الدينى الأسطورى والتفكير السياسى الأسطورى، كليهما يقوم على حيلة فكرية سلبية مخاتلة، أى مخادعة. والخَتْل أَى الخِدَاع.. وخَتَلَ الذِّئبُ الصَّيدَ: تَـخَفَّـى له؛ وكلُّ خادع خاتلٌ وخَتُولٌ. والـمُخاتَلة: مَشْىُ الصيّاد قلـيلًا قلـيلًا فـى خُفْـية لئلا يسمعَ الصيدُ حِسَّه، ثم جُعل مثلًا لكل شىء وُرِّى بغيره وسُتِر علـى صاحبه. «ابن منظور الإفريقى المصرى: لسان العرب». وهذا عين ما يحدث فى الرؤية السحرية اللاهوتية للعالم، حيث الوقائع العينية خافية، وأقوال قادة القطيع ترتفع وتصول وتجول وتتخفى وراء أقنعة كلمات حق يراد بها باطل، ولذا تنجح فى أن تخفى الواقع عن أعين الأتباع!
فلا فرق بين سحر السحرة بالمعنى الحرفى، وسحر قادة القطيع فى بعض المذاهب الدينية المؤدلجة، وسحر الخوارج الجدد فى السياسة؛ فكلهم «سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ»، (الأعراف: ١١٦).
لكن نجاح السحرة فى إرهاب أو استرهاب الناس، لم ينه القصة! فللقصة نهاية أخرى «فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ»، (الأعراف: ١١٨- ١١٩).
ولا يمكن أن نستعيد فى عصرنا «عصا موسى»، لكن يمكن أن نستعيد الإسلام الأول، والعلم الحديث والوطنية ووحدة الصف والأخذ بالأسباب والتخطيط الاستراتيجى والعمل الجاد، وهى كلها «عصا موسى الجديدة» التى ننتظرها ضد الرؤية السحرية اللاهوتية للعالم، وأتباعها الذين خضعوا لأكبر عملية «تغييب» ضد الدين والوطن؛ نتيجة وقوعهم فى الرؤية السحرية اللاهوتية للعالم التى تصنع التقليد الأعمى والتعصب المطلق الانتحارى، غافلين عن أن رؤية الإسلام الأول للعالم هى التى صنعت رجالًا نبذوا التقليد واتباع البشر للبشر دون دليل أو تعقل أو برهان.
وتلك الرؤية للعالم عندما أثرت فى أوروبا فى نهاية العصور الوسطى، صنعت الإصلاح الدينى على يد مارتن لوثر الذى رفض الوساطة بين الإنسان والله، ورفض التفسيرات المغلقة الثابتة المتحجرة التى قدمها الكهنوت للكتاب والكون.
ومن هنا كانت نقطة انطلاق أوروبا نحو عالم جديد انكسرت فيه الرؤية السحرية اللاهوتية للعالم، وبدأت رويدًا رويدًا تشكل لنفسها رؤية جديدة للعالم.
٥- تغيير طريقة إدراك المسلمين لـ«مفهوم الدين»:
من الخطوات اللازمة لتغيير «رؤية العالم Worldview» الجهولة التى أنتجت كل الظواهر السلبية عند المسلمين المعاصرين، تغيير طريقة إدراك المسلمين لـ«مفهوم الدين»؛ لأن المسلمين شئنا أم أبينا، تتكون عندهم رؤية العالم من خلال الدين، حتى لو كانوا مُفْرِطين أو مُفرِّطين فى الدين.
وهذا التغيير لا يمكن أن يتم دون تغيير «مفهوم الدين» فى عقولهم؛ لأن المفهوم هو شرط أولى قَبْلى بلغة الإبستمولوجية أو نظرية المعرفة، وأى تجديد لاحق لطرق فهم العقائد والشرائع وفق معناها النقى، سيفشل فشلًا ذريعًا إذا لم يكن المفهوم الكلى للدين منضبطًا فى عقول الناس. فالمفهوم الكلى الأولى يلون كل ما يتلوه بلونه الخاص، فهو بمثابة العدسة التى ينظر منها المرء، فإذا كانت حمراء سيرى كل شىء أحمر، وإذا كانت صفراء سيرى كل شىء أصفر، وإذا كانت سوداء سيرى كل شىء أسود وهكذا.
إن مفهوم الدين هو ببساطة «المعنى العام» للدين. فما المعنى الذى يسود فى عصور التخلف والتراجع؟ وما المعنى النقى الذى يجب أن يسود إذا أردنا تجديدًا حقيقيًا للخطاب الدينى وتغييرًا حقيقيًا فى مسلمى المستقبل؟
المعنى الضيق للدين هو مجموعة من الطقوس والشعائر إذا أداها المرء ضمن الخلاص ودخول الجنة حتى لو أهمل فى عمله أو خدع الناس أو خان أو كذب أو مشى بالنميمة، «وفى عصرنا: حتى لو انتخب بالباطل أو قتل أو حرق أو دمر أو نهب أموال الشعب أو الحكومة أو الدول الأخرى أو أصحاب الديانات أو الآراء المخالفة». فأداء بعض الشعائر عند المخادع لنفسه يمكن أن يطهره من كل الحقوق التى نهبها أو أضاعها أو تعدى عليها، لا فرق عنده بين الحق الخاص والحق العام ولا حتى حق الله! فبمجموعة من الطقوس ُيمكن- فى تصوره- أن يُرضى الله!
إن هذا المخادع يتصور أن الدين شىء والمعاملات شىء آخر، الدين مجرد نوايا وأقوال ومظاهر، وهذا المخادع ليس هو فقط المتزمت الجهول الذى يزايد على خلق الله بل هو أيضًا الفنان المفرط الذى يعتبر الدين مجرد عمل قلبى، وهو أيضًا المجاهد الزائف الذى يعتبر الدين قتلًا وسفكًا وإجبارًا على الإيمان، وهو أيضًا رجل الدين الذى يتعامل مع الدين كوظيفة و«سبوبة»، وهو أيضًا متصوف عصور التراجع الذى يعد الدين مجرد حلقة ذكر، وهو أيضًا الإعلامى الذى يرى فى الدين مادة خصبة للإثارة!
وتكوين خطاب دينى جديد بالمعنى الذى نفهمه، لا بد أن يقوم على تغيير فهم المسلمين للدين، وهنا سوف نكتشف أن تجديد «مفهوم الدين» ليس تجديدًا بقدر ما هو عودة إلى المعنى الأصلى للدين قبل أن يتلون بثقافات بدائية وعقول مغلقة ونفوس مخادعة وجماعات تطلب السلطة بالدين، وترفع المصاحف على السيوف لحسم صراع الكراسى والنفوذ والغنائم!
إن تجديد «مفهوم الدين» إذن يكون بالرجوع إلى المعنى الأصلى للدين، وهذا المعنى لا يمكن الوصول إليه إلا بتحليل فلسفى لمفهوم الدين فى علوم اللغة والنفس والاجتماع، وأيضًا فى تاريخ الفلسفة التى اقتربت من الدين أحيانًا، وابتعدت عنه أحيانًا أخرى، وعادته فى قطاع منها، واحتضنته فى قطاع آخر، وأخيرًا تحديد مفهوم الدين فى النص الدينى ذاته، أى كيف يحدد الدين ماهيته بنفسه؟ وماذا يقول عن نفسه؟ وكيف يرى ذاته فى مرآته هو لا فى أى مرآة أخرى؟!
إن إحدى مهام تكوين خطاب دينى جديد، تستلزم تعيين وتحديد جوهر وماهية الدين من حيث هو دين، ومن ثم معرفة وظيفة الدين وتخليصه من النظرة الجزئية والضيقة وأيضًا من الاستغلال السياسى أو الاجتماعى.
ولن نصل إلى هذا الهدف من طريق قصير، بل عبر طريق طويل بعض الشىء من التعقب والتحليل.
ولنبدأ بتحليل فلسفى للمفهوم اللغوى للدين، وأرجو أن يتحملنى القارئ بعض الشىء، فليست هذه الأفكار للاستهلاك الصحفى، وإنما هى رغبة حقيقية فى تغيير معانٍ راسخة فى عقول تكونت فى مدارس التقليد والاتباع الأعمى، وتمت تربيتها على السمع والطاعة وإلغاء العقل، وتحصيل «المعلومات المعلبة».
عرّف الرازى الدين لغويًا فقال: الدِّينُ بالكسر: العادة والشأن. ودَانَهُ يدينه دِينًا بالكسر: أذله واستعبده، فَدَانَ. وفى الحديث: «الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». والدِّينُ أيضًا: الجزاء والمكافأة، يقال: دَانَ يدينه دِينًا أى جازاه، يقال: «كما تُدِينُ تُدَانُ»، أى كما تُجازِى تُجازَى بفعلك وبحسب ما عملت. وقولـه تعالى: «أَئِنَّا لَمَدِينُونَ» أى لمجزيون محاسبون. ومنه: الدَّيَّانُ فى صفة الله تعالى. والمَدِينُ العبد، والمَدِينةُ الأمة، كأنهما أذلهما العمل، ودَانَهُ ملكه، وقيل: منه سمى المصر مَدِينةً. والدِّينُ أيضًا الطاعة، تقول: دَانَ له يدين دِينًا، أى أطاعه. ومنه الدِّينُ. والجمع الأَدْيَانُ. ويقال: دَانَ بكذا دِيَانَةً، فهو دَيِّن وتَدَيَّنَ به فهو مُتَدَيِّنٌ، ودَيَّنَهُ تَدْيِينًا: وكّله إلى دينه.
وإذا حللنا فلسفيًا هذا التعريف اللغوى للدين، فماذا يمكن أن نجد؟
٦- معنى الدين فى خصوبته الأولى ضد التراث الدينى الذى صنعه البشر:
أصبحت الجماعة والحرف والنقل أوثانًا تعبد من دون الله! وصار الدين المزيف قناعًا لإجبار خلق الله على نمط رجعى للحياة، وأداة لأغراض التمكين السياسى، ووسيلة لجمع الأموال، ومرتعًا لأهواء المفتين، وتبريرًا لسلوكيات اجتماعية متخلفة من عصور الانحطاط الحضارى، وتغلفت به «عادات» موروثة، وتلونت به جماعات المصالح، ورفعته شعارًا جموعٌ تحركها العاطفة وحماس القطيع، من دون غطاء من العقل أو الإرادة الحرة.
إن إحدى مهام تكوين خطاب دينى جديد- كما أشرنا فى موضع سابق- تستلزم تحديد «جوهر الدين» من حيث هو دين، ومن ثَمَّ معرفة «وظيفة الدين» وتخليصها من النظرة الجزئية والضيقة وأيضًا من الاستغلال السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى. وربما يساعد تحليل معنى الدين فى اللغة، فى تحديد ماهية الدين، وهو ليس تحليلًا على طريقة القدماء فى البدء بالمعنى اللغوى ثم المعنى الاصطلاحى، بل تحليلًا عقليًا للغة والاصطلاح، وهذه أولى مهام «فلسفة الدين» التى لا تزال غامضة فى ثقافتنا، ومختلطة بحقول أخرى مثل الفلسفة الدينية وعلم الكلام والفلسفة الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية، لدرجة أن بعض المختصين يقعون فى هذا الخلط بين الحقول المعرفية، شأنهم شأن العوام الذين يرون كل شىء مثل الآخر لمجرد التشابه اللغوى!
وإذا حللنا عقليًا المعنى اللغوى للدين يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
من معانى الدين فى اللغة: «العادة». وربما اُعتبر الدين عادة؛ لأنه عندما يتغلغل فى حياة الناس يصبح عادة؛ لكن مأساتنا أن العادات أصبحت دينًا! والمطلوب هو تغيير تلك العادات بكشفها وفضحها وكيف أنها ليست دينًا، بل مجرد عادات اجتماعية موروثة. ثم تكوين عادات تصبح سلوكًا للتقدم والبناء وليس للاستهلاك اليومى أو التوظيف الأيديولوجى، وفى الوقت نفسه استعادة الدين ليصبح هو العادة. فالدين فى أحد معانيه فى اللغة هو العادة، لكن أى دين؟
هل هو دين الإسلام فى نقائه وخصوبته الأولى.. أم هو التراث الدينى الذى صنعه البشر ليلائم زمانهم ومشاكلهم.. أم دين علماء السلطان الذين أفتوا فى عصورهم لحسم معاركهم هم لا معاركنا نحن.. أم دين الخوارج فى كل العصور الذين فهموا الدين بوصفه جبرًا وإجبارًا وجبروتًا؟
كذلك يكشف التعريف اللغوى للدين عن أنه «شأن»، والدين شأن، ربما لأن الدين شأن إنسانى محض، وحالة إنسانية بحتة. فالدين نظام اجتماعى، والحيوان بلا دين؛ لأنه ليس لديه هذا النظام، كما أنه لا يرتفع - فيما يشير الفيلسوف الألمانى هيجل- عن مستوى الإحساس والغريزة، إلى مستوى العقل والتفكير، ولا يصعد إلى مستوى «المطلق» عن طريق الفكر، بل يظل عند مستوى الإحساس والغريزة.
إذن الدين- هكذا ينبغى أن يكون- ارتفاع عن مستوى الإحساس والغريزة «وهو المستوى الذى تقف عنده قطعان الحيوان وأيضًا قطعان البشر»، إلى مستوى التفكير، لكن أى تفكير؟
إنه التفكير العقلى المنضبط فى الاستدلال، وليس التفكير الذى ينتهجه هواة القفز على المقدمات، أو أنصار التفكير الجزئى الذى يقتطع كل شىء من سياقه الكلى، التفكير العقلى لا التفكير التبريرى! ولا شك أن هذه نقطة تحتاج إلى توضيح، نرجو الوقوف عندها فى موضع آخر، حتى لا نبعد هنا عن تحليل المعنى اللغوى للدين.
تشتق كلمة الدين فى بعض الأحيان من فعل متعدٍ بنفسه «دان يدينه دينًا بالكسر»، أى «أذله واستعبده»، والمراد: أخضعه وحكمه وملك أمره وقهره. وينطوى الدين بهذا المعنى على نوع من إخضاع أتباعه لنظام وقواعد، والتحكم فى سلوكهم، وامتلاك أمور حياتهم بتدبيرها وتصريفها.
ومع أن هذا المعنى موجود فى قواميس اللغة، فلا أظن أنه مقصود فى أى من آيات القرآن الكريم. فالإسلام لم يأت للقهر ولا للاستعباد، بل جاء لتحرير الإنسان، وتحرير اختياره، والدين بلاغ وليس إكراهًا، والرسول مذكر وليس جبارًا، «وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ»، (العنكبوت: ١٨).. «نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ»، (ق: ٤٥).. «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٩٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (يونس: ١٠٠).
فالدين اختيار، وهذا الاختيار مرتبط بالحرية، وهذه الحرية قائمة على التعقل، والله يحب أن يأتيه عبده طوعًا لا كرهًا، ولو كان رب الكون- أستغفر الله- يريد ما يريده المتعصبون لأجبر أهل الأرض كلهم على الإيمان، لكنه سبحانه ترك الحرية للإنسان؛ «وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، «الكهف: ٢٩».
إذن المسألة تتعلق بتبليغ الحق وليس بالإجبار عليه، ومن هنا فهذا المعنى اللغوى الذى ذكره الرازى، «دَانَهُ يدينه دِينًا بالكسر: أذله واستعبده، فَدَان»، هو فقط مجرد معنى لغوى عند بعض الناس وفى بعض الاستخدامات التى تحرك جماعات العنف، ولا شأن له بالدين الخالص الذى يتأسس على الاختيار والحرية والتعقل، لا الجبر ولا الإجبار ولا الجبروت!
«وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار».. هكذا حسم القرآن الأمر برمته.
٧- تجديد مفهوم الطاعة فى الدين:
إن «الرؤية اللاهوتية غير العلمية للعالم» تجد أقوى زخم لها فى التقليد والاتباع الأعمى، وفى زعم امتلاك الحقيقة المطلقة فى الدين والفقه والتفسير والسياسة. وسبب أصيل من أسباب حالة التراجع العامة، والتطرف الدينى والسياسى يكمن فى هذه الرؤية المحكومة بالتقليد والتبعية المطلقة- دون عقل نقدى- لبعض العلماء أو الدعاة، والطاعة العمياء لقادة الجماعات، والحفظ دون العقل، دون تحمل مسئولية التعامل المباشر مع القرآن والسنة الصحيحة. وذلك فى حالة غريبة من مخالفة التعاليم القرآنية الواضحة، وتوجيهات النبى الحاسمة التى ترفض التقليد واتباع ما سوى الله ورسوله!
وهذا أمر يدخل فى لب مفهوم الدين، وفى التعامل الخاطئ مع هذا المفهوم، فمن معانى الدين «الطاعة»؛ حيث تؤخذ كلمة الدين- من بين ما تؤخذ- من فعل متعدٍ باللام «دان له»، أى خضع له وأطاعه، ولذا فإن اللغويين يذكرون من معانى الدين «الطاعة»، يقول الرازى: «الدِّينُ أيضًا الطاعة، تقول: دَانَ له يدين دِينًا، أى أطاعه». ولذلك فإن الجرجانى فى «التعريفات» رأى أن الشريعة تسمى دينًا لأنها تطاع، يقول: «الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينًا».
والإشكالية الكبرى هنا: طاعة مَنْ؟ طاعة الله ورسوله مباشرة دون وسيط.. أم طاعة عبر وسيط؟
نصوص القرآن والسنة الصحيحة واضحة فى طاعة الله ورسوله مباشرة دون وسيط من رجال الدين أو الكهنوت أو المتحدثين باسم الحقيقة المطلقة من أى نوع، لكن شيوخ وقادة عصور التراجع يؤولون النصوص ويفسرونها بما يضمن لهم التدخل كوسطاء بين عامة المسلمين والإسلام! ومن تلك اللحظة التى نجحوا فيها فى السيطرة على عقول الناس، دخلت الحضارة الإسلامية فى حالة تراجع أمام العالم كله. وعلى الرغم من هذه النتيجة السيئة، فلا أحد يستطيع أن يستنبط أن هذه أفكار باطلة، بدليل أن النتائج الملموسة فى الواقع شديدة الوضوح على وجود خلل، ولا يسأل أحد منهم سؤالًا واضحًا وبديهيًا: إذا كان ما أؤمن به من أفكار بعض الزعماء الدينيين يأتى دائمًا بنتائج سلبية فى الواقع، أليس هذا دليلًا على بطلانها؟
ألم أقل لك عزيزى القارئ من قبل: إنها عقول مغلقة لا ترى حولها، عقول تربت على الطاعة العمياء للآباء والمتحدثين باسم الله، عقول منفصلة عن الواقع المعاش ومنفصلة عن القرآن والسنة الصحيحة؟!
إن الطاعة كجزء أصيل من مفهوم الدين هى طاعة للقرآن والرسول مباشرة، وليست طاعة لأى متحدث باسمهما، فلا أحد يحمل «صكًا إلهيًا» يستوجب الطاعة؛ لأن المسئولية فى القرآن الكريم مسئولية فردية وشخصية، ولا يجوز أن يرمى الشخص مسئولية ما يفعل على شخص أفتاه أو أرشده. فالإسلام ضد التبعية العمياء، يقول القرآن الكريم «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ»، (البقرة:١٦٥-١٦٧).
إذن واضح أن الإسلام نبذ التقليد والاتباع الأعمى، وحمل كل فرد المسئولية بشكل شخصى. فهو المسئول عن اختياره، وهو المسئول عن قراره، والمرجعية فقط هى مقاييس الحق، وليست أقوال الرجال، حتى ولو كانوا فى حجم وقامة الأئمة الأربعة أو غيرهم من القامات التاريخية. ولذلك يقول صديق حسن القنوجى فى كتابه «أبجد العلوم الوشى المرقوم فى بيان أحوال العلوم»: «الأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم، ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها، فضلًا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم، لأن التقليد من صنيع الجاهل».
وعلى الرغم من موقف القرآن الحاسم من قضية التقليد، وموقف علماء الأمة الأوائل، فإن المتعصبين يتحدثون كما لو كان موقفهم قائمًا على براهين محكمة ونهائية! أى أنهم يخدعون غيرهم، بل يخدعون أنفسهم دون أن يشعروا، بأنهم أصحاب الحق فى اتباع رجال بأعينهم بوصفهم حاملى أختام الحقيقة المطلقة ذات البراهين المحكمة، مع أن براهينهم مليئة بجوانب الخلل التى تدل عليها النتائج السيئة فى الواقع المعاش!
وما هذا إلا لأن «الرؤية اللاهوتية للعالم» تنطوى على موقف «منغلق» غير قائم على التفكير النقدى، ومن ثم لا يستطيع المتعصب أن يخرج وراء ذاته فيرى عيوب تفكيرها. إن هذا الموقف متهافت؛ خاصة أن أصحابه يؤكدون معتقداتهم غالبًا بسلطة الآباء أو القدماء أو قادة الجماعة دون برهان عقلى، ودون مراعاة الظروف المتغيرة، ودون أى احتمال لكونها ناقصة أو خاطئة أو معارضة للنصوص القرآنية المحكمة وقطعية الدلالة!
ومن هنا فالمطلوب هو تجديد فهم المسلمين للدين، عن طريق ثورة فى التعليم والإعلام، حتى تحل الرؤية العلمية للدين والعالم محل الرؤية اللاهوتية السحرية القائمة على النقل والحفظ والاتباع الأعمى للذين وضعوا أنفسهم كوسطاء بين الإنسان والله، وبين المسلم والقرآن، وبين الأمة ورسولها الكريم.