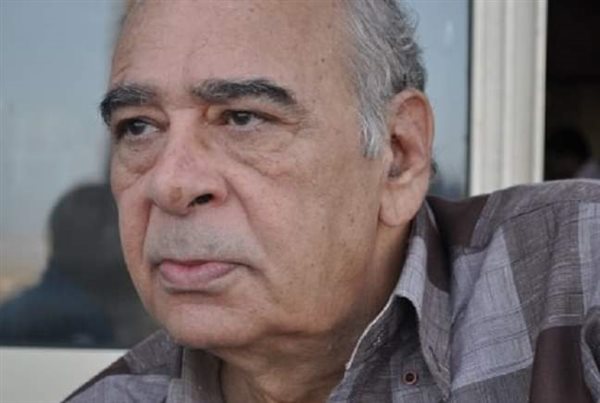أتذكرك
فى عيد الأم، كما يحدث للجميع، أتذكر أمى. كانت شابة بسيطة على قدر من الجمال، تعرف إليها والدى فى كلية الآداب عام ١٩٤٦وكتب لأجلها: «حولى عينيك عنى إنى لا أطيق.. ما تصبان بنفسى من حريق». وحين تقدم والدى لطلب يدها سأله أبوها: «ماذا تعمل؟». قال له: «شاعر وصحفى»، فمط جدى شفته بازدراء، وقال له: «لست موظفًا إذن؟. شوف لك يا ابنى شوفة تانية غير بنتى». لكنها قررت الهروب معه، وعقد القران فى بيت خالتها بحدائق القبة.
وعندما اعتقل أبى عام ١٩٥٣ وجدت نفسها بطولها معنا أطفالها الستة بلا سند ولا معين ولا حتى ما يكفى لسداد أجرة الشقة فى العباسية، فجمعتنا وجرتنا إلى بيت جدى. ولم تكن قد أنهت تعليمها الجامعى، وبعد أن أنهته اشتغلت معلمة فى مدرسة نائية فى مدينة طوخ، فلم نعد نراها إلا مرة فى الأسبوع.
كنت أنتظر عودتها من طوخ ظهر كل يوم خميس. أصعد إلى سطح البيت، أشب بقدمى وأرتكز بمرفقى على السور. أحدق يسارًا بنهاية الطريق أترقب ظهورها. يطن رأسى من الوقوف طويلًا فى هواء ملون بوهج الشمس. أخيرًا تلوح أمى على الطريق من بعيد. ترفع رأسها ناظرة إلى السطح لأنها تعلم أنى أنتظرها، أنتظر ولا أفقد الأمل أبدًا، وعندما لا يفصلها عن البيت سوى أمتار قليلة أهبط مسرعًا زاعقًا فى أخواتى: «ماما جاءت». ترانا تحتضننا وهى تمر ببصرها علينا بلهفة كأنما تطمئن على كل ضلع فينا. تلمنا بين ذراعيها وتغوص رءوسنا فى بطنها شاعرين بالطمأنينة. تلمع عيناها وهى تحدق بنا مثل قطة تتطلع إلى أبنائها فى ألسنة الحريق. شابة حُرمت من زوجها، أمٌ حُرمت من أطفالها، مع ذلك لم نسمعها تشكو مرة واحدة.
كنا فى بيت جدى نأكل فى الإفطار والعشاء أنصاف أرغفة، وإذا تسللت أصابع أى منا لأكثر من نصف رغيف لسعه جدى بكفه الثقيلة على أصابعه الممتدة. كان جدى يراقب الجميع بعينين مفتوحتين وهم يأكلون ليضمن أن الخبز سيكفى الأفواه الجائعة، وأن عدالة الفقر ستتخذ مجراها. يحدث هذا أمام عينيها. تكز على ضروسها ولا تنطق. علمنا صبرها وصمتها أن ننهض جوعى مبتسمين كأنما شبعنا. مشينا حفاة فى الشارع فلم يطرف لها جفن، ولم تُظهر ضعفًا أمامنا أبدًا. فقط كان الصداع النصفى يهاجمها بضراوة. ترقد على جنبها فى حجرة نصف معتمة. تربط رأسها بمنديل تعقد طرفيه بمفتاح باب الحجرة. تطلب منى أن أجلس على السرير بالقرب منها وأضغط رأسها بجماع يدى الاثنتين. كانت روحها من القوة بحيث لم تجد الطبيعة فيها منفذًا للبكاء، فراحت تلطم بدنها بالصداع العنيف عوضًا عن دمع لا ينهمر.
عندما خرج والدى من المعتقل عام ١٩٥٦، كنت أراه يملى عليها مقالاته، يروح ويجىء ويملى وهى جالسة تكتب، فأردت أن أقلده وأنا طفل مع ابنة الجيران التى كانت من سنى فى نحو التاسعة، لكنها قالت إنها لا تحسن الكتابة أصلًا، ومع ذلك بدأت أكتب القصص الصغيرة الساذجة، فلما انتبهت أمى إلى ذلك قالت لى: «سأعطيك خمسة قروش عن كل قصة». وكانت الخمسة قروش فى وقتها ثروة لطفل، يمكنك بها أن تدخل السينما وتأكل كشرى وتشرب عصيرًا. هكذا انفتح أمامى فجأة باب الثراء، فصرت أشخبط أى كلام لأحصل على القروش الخمسة، إلى أن حل يوم فلاحظت ذلك وقالت لى: «إذا كنت ح تشخبط أى حاجة مش ح تآخد منى حاجة»!، وكان راتبها الشهرى عماد حياتنا المنتظمة، كما كانت ترجع يوميًا من عملها فتغسل ملابسنا، تكوى، تطبخ، تنظف، وفى المساء تراجع معنا الدروس. لم أرَها مرة واحدة تشكو، أو تئن، ولا لمحت دمعة فى عينيها، رغم حياتها الشاقة الطويلة، وتوفيت رافعة الرأس كما عاشت، كانت جالسة بيننا ثم طلبت جرعة ماء شربتها ومالت برأسها فى صمت على كتفها، بالكبرياء نفسها التى عاشت بها، أتذكرها باعتزاز وزهو، ويرن اسمها «شفيقة» فى وجدانى يقيم الأبنية والقصور الفارهة، ويشق الأنهار، ويغرس الزهور، ويزيح السدود من طريقى.