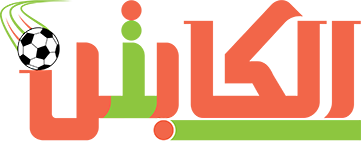إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!
فى كتابه الأول «تولستوى أم دوستويفسكى» حاول الناقد الفرنسى الأمريكى جورج شتاينر المقارنة بين كاتبىّ روسيا الكبيرين ليو تولستوى وفيودور دوستويفسكى من حيث الأفكار والأيديولوجيات ورؤية العالم والكتابة، وعمق الاختلاف فى تصورات ومنطلقات كل منهما فى كتاباته وتفاصيل حياته وأثره الممتد فى محيطه.. وهو سؤال أظن أنه لا يزال يشغل الكثير من المشتغلين بالنقد الأدبى، خصوصًا مع الشهرة الطاغية لكل منهما حول العالم، والتأثير الكبير لمنجزيهما فى كثير من الكتاب والمفكرين فى عصرنا الحديث، حتى إن الكاتبة والمخرجة اللبنانية نجوى بركات ذهبت فى مقال لها بنفس عنوان كتاب شتاينر إلى أنك «إذا سألتَ روائيًا بمن تأثر أو إلى أى سلالة أدبية ينتمى، من النادر ألا تسمعه يقول اسم دوستويفسكى.. بعضهم سيتحدث عن تولستوى ولو بدرجة أقل، ربما لأن الأخير أكثر تفاؤلًا بالإنسان عندما يكون متناغمًا مع الطبيعة، من مواطنه المُغرق فى تشاؤمه من تناقضات النفس البشرية ومقدرتها على ارتكاب الشرور».. وهو ما حاولت الحديث عنه بشكل أوضح فى العدد الجديد من جريدة «حرف» الإلكترونية الثقافية المتخصصة، على أننى هنا أود السير فى اتجاه آخر يخص المقارنة بين اثنين من كبار المشهد الثقافى والأدبى المصرى والعربى، فهذه الحالة لن تجدها بذات الوضوح فى الأدب العربى سوى عند المقاربة بين الكبيرين نجيب محفوظ ويوسف إدريس، حتى إنه يمكنك أن تحصل على ذات الإجابة إن سألت ذات السؤال مستبدلًا الأسماء، فإذا سألت روائيًا مصريًا أو عربيًا بمن تأثر، لن تخرج الإجابة عن ذكرٍ لأحدهما، وفى الغالب سيكون هو نجيب محفوظ، خصوصًا أن الشبه بين الكُتّاب الأربعة لا يخلو من طرافة تخص مساحات التشابه بين كل من يوسف إدريس وتولستوى من جهة، وبين نجيب محفوظ ودوستويفسكى فى الجهة المقابلة..
ولعله من المناسب أن أذكر هنا العبارة التى قالها الكاتب الدكتور أحمد الخميسى فى ندوة «منتدى أوراق»، الذى يعقده الناقد الكبير الدكتور يسرى عبدالله يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر بمقر جريدة «الدستور»، وكانت الندوة لمناقشة المنجز الكبير للدكتور الخميسى، ومنه ترجمته كتاب «نجيب محفوظ فى مرآة الاستشراق السوفيتى»، عندما جاء أحد الحضور بمقارنة بين إبداع الكبيرين نجيب محفوظ ويوسف إدريس، معيدًا السؤال الذى يبدو أنه أصبح سؤالًا مزمنًا فى الثقافة العربية، بشأن أيهما كان أحق بجائزة «نوبل» ١٩٨٨، فأشار الخميسى إلى نقطة اختلاف جوهرية، أظنها فى غاية الأهمية للمقارنة بين عالمى المصريين الكبيرين، بمثل أهميتها بالنسبة لتجربة كل من تولستوى ودوستويفسكى، إذ كان نجيب محفوظ يتعامل مع الحياة فى عمومها باعتبارها مادة للأدب، يرى الوجود كله فى خدمة الكتابة الروائية، ومشروعه الأدبى، فيما كان يوسف إدريس يوظف الأدب لخدمة الحياة، فكل كتاباته للتعبير عن أفكاره وتصوراته عما ينبغى أن يحدث، أو ما يراه أفضل لحياة الإنسان، وربما كان ذلك هو السبب فى أننى أظن أن يوسف إدريس أنفق الكثير من وقته فى الفتنة بذاته، وبما يمكنه إنجازه، وفى الحديث عما تمثله كتاباته من إضافات إلى الحياة فى مصر والعالم، حتى عندما أعلنت الأكاديمية السويدية عن فوز نجيب محفوظ بجائزة «نوبل» للآداب، راح يملأ الدنيا كلامًا عن حظه وحقه المهضوم لصالح محفوظ، وعن الخديعة التى تعرض لها من قبل لجنة الجائزة التى قال إنها أخبرته بترشحه لها، وقيل إنه كان الأحق بها.. بينما لم ينشغل نجيب محفوظ طوال حياته بغير فن الرواية وما يمكنه أن يضيف إلى ذلك الفن فى مصر والعالم العربى، فعاش يكتب، ويجدد دماءه، ويعدل من طرقه فى الكتابة والإبداع، وإن لم يلتفت إليه أحد، وهو ما تحدث عنه الشاعر والمؤرخ الأدبى شعبان يوسف باستفاضة، فكتب قبل أيام على صفحته بموقع «فيسبوك» تحت عنوان «فتنة الشهرة والمكاسب الأدبية المغتصبة» ما نصه إن «نجيب محفوظ ظل يعمل طوال عشرين عامًا فى الظل، دون أن ينتبه له ناقد بشكل قوى، عدا بعض الكتابات السيارة التى كتبها بعض نقاد محبين له فى عقد الأربعينيات، ولم يتوقف عندها كثيرون، وبالتالى لم تشكل تلك المقالات تيارًا قويًا أو جارفًا للاهتمام بإبداعاته التى وضعت تأسيسًا ثانيًا لرواية عربية رصينة»، ويضيف شعبان يوسف: «حصل نجيب محفوظ على جائزتين فى تلك المرحلة الأولى من حياته، وهما جائزة قوت القلوب الدمرداشية، والثانية جائزة دار المعارف، ماعدا ذلك لم ينل محفوظ مجدًا نقديًا أو احتفاليًا مثلما كان يحدث لآخرين، ولكنه كان يعمل فى محرابه، عاشقًا وناسكًا ودءوبًا ومستشرفًا وقارئًا عظيمًا، ولم يشكُ من ذلك التجاهل المتعمد أو العفوى، وجاء ذلك الدأب بثماره العظيمة».
وأغلب ظنى أنه ربما كان يوسف إدريس فى كتاباته أكثر طموحًا وجرأة، خصوصًا فى ناحية تفرده فى كتابة القصة القصيرة، وجرأته فى الكتابة للمسرح والمقالات الصحفية، من حيث الاشتباك الدائم مع كثير من القضايا الاجتماعية والسياسية، فما خاضه من معارك ثقافية وفكرية، فى ظنى، يفوق إنتاجه الأدبى شهرة وحضورًا، وكما كان تولستوى مفتونًا بذاته وبقدراته الاستثنائية، كان الدكتور يوسف إدريس أكثر فتنة، واستعدادًا لفعل أى شىء حتى يسمعه الناس، ويمتثلوا لما يراه من أفكار وتصورات، وإن كانت هذه التصورات تنطوى على مخالفة صريحة لقواعد اللغة العربية البسيطة، كما حدث فى القصة المشهورة بشأن إصراره على عنوان «أرخص ليالى» لمجموعته القصصية التى اضطر ناشرها إلى طباعتها بذات العنوان على ما فيه من خطأ لغوى واضح وصريح، يراه دراويش الدكتور ثباتًا على الموقف، وانتصارًا لجماليات العامية المصرية، وكلام آخر كثير وفخيم.. لكنه فى تصورى كلام فارغ، فالعنوان به خطأ لغوى، والانتصار له هو ترسيخ لذلك الخطأ، أو لمجرد الدفاع عن كاتب لم يجد فى اللغة التى يكتب بها ما يعبر عما يريد دون ارتكاب أخطاء، ولعيب فيه هو لا فى اللغة.