سر مجدى يعقوب.. كيف وصل طفل يجلس فى آخر الفصل إلى قمة العلم؟

صدر حديثًا عن الدار المصرية- اللبنانية مذكرات «جرَّاح القلوب» الدكتور مجدى يعقوب، تحت عنوان «جرَّاح خارج السرب».
المذكرات حررها اثنان من أبرع صحفيى «التايمز»، هما: سيمون بيرسن، وفيونا جورمان، حيث أجريا حوارات مطولة مع مجدى يعقوب، استغرقت نحو ٣ سنوات، حتى ترى «سيرة السير» النور، عبر شهادات حية من عشرات الأشخاص، بينهم د. مجدى نفسه، الذى روى قصته على مدار ٢٥ ساعة فى ١٧ مقابلة، وكذلك أبناؤه الثلاثة، وفريقه الطبى، وزملاؤه السابقون والحاليون، وبعض مرضاه وعائلاتهم، وشخصيات عامة، ومسئولون.
صدرت المذكرات فى نسختها الإنجليزية عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبرعاية من مكتبة الإسكندرية، لتقدم الوجوه المتعددة لمجدى يعقوب، الطبيب الماهر، الذى فتح عشرات القلوب، واطلع على آلامها، وأعاد إليها الحياة من جديد، دون أن يطلع أحد على قلبه هو، وما يطويه من أسرار.
«الدستور» تنشر جانبًا مما جاء فى المذكرات حول طفولة الدكتور مجدى يعقوب.
كان مجدى يعقوب «مختلفًا» منذ البداية، وتلك سمة سوف تصطبغ بها حياته فى رشده، وتتشكل بها حياته العملية جرَّاحًا وعالمًا. ولد فى السادس عشر من نوفمبر سنة ١٩٣٥ ببلبيس، وهى بلدة صغيرة كانت موقع قلعة عتيقة من قلاع المملكة المصرية. أقيمت على ضفاف أحد فرعى نهر النيل فى الشمال بعيدًا عن أضواء حاضرتى القاهرة والإسكندرية. وقد ولد لأسرة من الأقباط، وهم أقلية فى بلد غالبيته من المسلمين.
كان والد مجدى، واسمه حبيب، جراحًا عامًا يعمل فى الحكومة، وعمل فى وقت لاحق من حياته فى الصحة العامة. وكان رجلًا سمحًا. أما والدته مادلين فكانت ابنة قاض، وكانت أما صارمة فرضت النظام على حياة الأسرة، وأصرت على أن يكون أبناؤها من الناجحين، وكانت تعزف على البيانو مقطوعات قليلة منها سوناتا نور القمر، وترسم بألوان الزيت على التوال.

كان مجدى ثالث أُخوة أربعة، تكبره أخته مهجة، ويكبره أخوه جمال المدلل باسم جيمى، أما الأخ الثالث سامى فقد ولد بعد مجدى بأربع سنوات. وكانت الأسرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى، ويمتاز أفرادها بالوسامة، فضلًا عن الثقافة والطموح.
كان دأب حبيب أن يُلقن أبناءه القيم فيقول: «إننى لا أريد أن أورّثكم مالًا، وليس لدىّ منه الكثير أصلًا، ولكننى أريد لكم قدرًا طيبًا من التعليم والمعرفة. ولن يخذلكم هذا أبدًا. فأموت راضيًا وقد تركتكم قادرين على تولى أمور أنفسكم».
كان يعمل فى وزارة الصحة، فظل يتنقل كل بضع سنوات منذ ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته بين بلدات مختلفة فى مختلف مديريات مصر، فترك هذا التجوال أثرًا عميقا فى ثانى أبنائه الذكور، إذ وصف مجدى يعقوب طفولته لاحقًا بـ«العهد الغجرى من حياتى». وقال إنه «كلما كانت الحكومة تحتاج إلى جرّاح، كانت الأسرة كلها تنتقل، ويتكرر ذلك كل سنوات قلائل».
ومع أن أبويه كانا يؤسسان لأبنائهما فى كل مرة بيتًا حانيًا مستقرًا، فقد أحدثت كثرة التنقل اضطرابًا وارتباكًا. فحينما كان مجدى فى الثالثة من العمر وجهه أبواه إلى مدرسة خاصة ذات إدارة أمريكية، ولما لم تطب له التجربة- وتلك المشكلة سوف تتكرر مرات- فقد التحق بعدد من المدارس الحكومية، لولا أنه صعب عليه الاستقرار فى أى منها. قال مجدى إن «المدارس آنذاك كانت محترمة وجيدة، ولكن فاجعة واحدة ظلت تتكرر، فقد كنت أكون صداقات فى نهاية المطاف، ثم يتحتّم علىّ أن أنتقل من المدرسة تلو المدرسة مع انتقال أبى من الوظيفة تلو الوظيفة. لقد كنت طفلًا خوَّافًا للغاية. فكلما نظر لى شخص حدثتنى نفسى أن: يا إلهى، إنه يكرهنى. والحق أنهم ما كانوا يكرهوننى، ولكنهم فقط كانوا لا يعرفوننى».

فى بلبيس بدأ مجدى على استحياء فى مدرسته الحكومية الأولى برز وسط أطفال الصف الأول بضخامة بنيانه، فنقلوه إلى فصل آخر متقدم بسنتين، وبدا هنالك أنه قد انطوى على نفسه. كان ولدًا هادئًا دائم الجلوس فى آخر الفصل، لا يبدو عليه مطلقًا الانتباه إلى معلميه، ويرفض المشاركة فى الحصص.
فكان المعلمون يقولون- حسبما يحكى- إن ذلك الولد متأخر عقليًا. لا يطرح أسئلة، ولا يتكلم مع أحد. فلا بد من عرضه على معالج أو طبيب نفسى. ويسألوننى: لماذا لا تتكلم؟ فأجيبهم ليس لدى ما أقوله».
ومع أن الانتقال من فصل إلى فصل لم يكن مريحًا، فقد كانت له منفعة واحدة لمجدى الذى كان لديه حتى وهو فى الرابعة من العمر- وعى لافت بذاته، فكان نفعه الوحيد من النقل أنهم وضعوه فى فصل واحد مع أخيه جيمى الذى يكبره بثمانية عشر شهرًا، وكان الأخوان وفيين لأحدهما الآخر، وصديقين حميمين.
كان مجدى أضخم بنيانًا من أخيه جيمى، ويبدو فى الصور العائلية أشد جدية- أو ربما أوعى بحضور العدسة- من أخيه الأكبر الذى طالما ارتسمت على وجهه ابتسامة مرح لم تكد تغيب عنه.
كانت لمجدى، والعهدة عليه، الريادة على أخيه فى جميع مراحل التعليم، «فجيمى يجد ويكدح، وأنا أحصل على الدرجات الجيدة وأفوز بالجوائز، ولكننا كنا قريبين من أحدنا الآخر. فلم يحقد علىّ قط. وكان دائمًا يقول: أنا فخور بأخى».
كانا لا يفترقان تقريبًا، فى المدرسة، وفى البيت، وفى اللعب. ثم التحقا فى نهاية المطاف بكلية الطب فى وقت واحد، وبعدها سافرا إلى بريطانيا، فكان ذلك أمرًا فريدا، حسبما روى مجدى. فقد كان جيمى سنده.
دأب الصبيان فى كل يوم على الاجتماع مع بقية الأسرة على الغداء، وذلك عادة فى الثالثة عصرًا، بعد رجوعهما من المدرسة. وكانت وجبة الغداء شبه رسمية، يحضرها الأولاد فى هندام حسن، مراعين تصرفاتهم، ويحكى لهم حبيب طرفًا من أخبار عمله فى المستشفى، وما صادفه من مصاعب مع المرضى، وما خطر له من خواطر ويحكى لهم مجدى ما كان فى يومه بالمدرسة، أو ما رآه فى جولاته الكثيرة، وكانت عنده كاميرا، وكان به ولع بالطبيعة.
فى غضون أشهر قليلة من التحاقه بفصل أخيه، إذا بالولد الصغير، الجالس فى آخر الفصل، الذى لا ينطق بحرف، يصبح الأول على الفصل. ذُهل الجميع من ذلك، وذهب البعض إلى أنه يغش لكن نتائجه تحدثت عن نفسها. وكانت العائلة قد شهدت مأساة وهو فى الخامسة من العمر ملأت مجدى بأسًا داخليًا أعانه على قهر اضطرابات التغيير الدائم، وغرس فى نفسه إحساسًا استثنائيًا طاغيًا بالإصرار على تحقيق هدفه.
فقد حدث فى عام ١٩٤٠ أن توفيت أخت أبيه الصغرى يوجين من جراء مرض فى القلب، وكانت طالبة فى الجامعة لم تتجاوز من العمر اثنين وعشرين عامًا، إذ تضور صمامها التاجى المتحكم فى تدفق الدم من الأذين الأيسر فى القلب إلى البطين الأيسر بسبب إصابتها بروماتيزم فى القلب. وقد نجمت تلك الحالة عن الحمى الروماتيزمية المتوطنة آنذاك فى مصر، ولم يكن لها فى حينها علاج فعال.
اغتم حبيب وأصابه الإحباط من عجزه عن مداواتها وصعب عليه لفترة العمل فى المستشفى، وخيم الغم على الأسرة. وبرغم صغر سن مجدى آنذاك، لم تزل لديه ذكريات قوية عن وفاة يوجين التى ملأت نفسه إصرارًا، فعقد العزم على أن يصبح جراح قلب، وعلى أن يجد علاجًا للمرض الذى أودى بحياتها. وأفضى بنواياه تلك إلى أبيه فاستخف بها. «قال لى أبى: لا يمكن أن تفعل ذلك وأنت على ما أنت عليه من فوضى. لا يمكن أن تصبح جراح قلب. تركيبتك المزاجية لا تلائم ذلك».
كان الولد يُكن لأبيه إعجابًا دائمًا، ويرقبه فى خروجه إلى العمل مبكرًا من كل يوم وقيادته الشيفرولية الصغيرة، لكنه قرّر أن يُثبت لوالده خطأه. قال يعقوب: «ابتداء بتلك اللحظة، ازددت عزمًا على عزم».
فى مكان آخر من العالم فى بريطانيا والولايات المتحدة، كان التقدم يتحقق ليساعده فى قابل الأيام على تحقيق طموحاته. فقد كانت تكنولوجيا تظهر فى أمريكا من شأنها أن تقود إلى جهاز القلب والرئة الأول، وهو الجهاز الذى يتولّى وظائف هذين العضوين خلال الجراحة، كما كان التقدم يتحقق على كلا جانبى الأطلنطى فى جراحة القلب.
وقد شهد العالم آنذاك تغيرات أخرى من شأنها أن تترك أثرًا عظيمًا على أسرة يعقوب، ولم تكن تلك التغيرات أقل من اندلاع الحرب العالمية الثانية. تذكر يعقوب أباه وهو جالس إلى مذياعه الصغير فى يأس، منصتًا إلى الأخبار، معلنًا لمن حوله أن الصراع سوف يشمل العالم كله.

أعلنت مصر- الخاضعة لسيطرة بريطانيا منذ عام ١٨٨٢- الأحكام العرفية فى عام ١٩٣٩، وقطعت علاقاتها الدبلوماسية بألمانيا وإيطاليا. واتخذت بريطانيا من مصر قاعدة لعملياتها فى البحر المتوسط، وواجهت قوات المحور فى شمال إفريقيا. ومع ما شهده القتال من جزر خلال سنوات ثلاث، نُقل حبيب إلى مدينة الفيوم على بعد مئة كيلو متر إلى الجنوب الغربى من القاهرة. ولما اقتربت القوات الألمانية- أو «الفيلق الإفريقى» حسب تسميته بالألمانية- من العاصمة المصرية فى خريف عام ١٩٤٢، كان مجدى فى السابعة فحسب. ووقعت مأساة ثانية، انطبعت فى ذاكرته انطباعًا، ورسخت فى نفسه طموحه إلى أن يكون طبيبًا. إذ قصفت القوات الجوية الألمانية مصنعًا على مقربة من بيته، ما أدى إلى إصابة كثير من الناس.
حكى يعقوب أنه كان مصنعًا ضخمًا، يُنتج كميات ضخمة من القطن. بعضه كان يستخدم فى الصناعة، وأكثره كان يُخزن للتصدير، وكان ذلك المصنع جيد الإضاءة. فلما وصل الألمان إلى العلمين، وقد أوشكوا على احتلال مصر، أخطأت قاذفاتهم وظنته تابعًا للبريطانيين ومخصصًا للسلاح».
وبرغم مرور قرابة ثمانين سنة، كان لا يزال بوسعه أن يصف الأصوات المختلفة، المحركات، الطائرات الألمانية والبريطانية. فقد تذكر أن الألمان دأبوا على الطيران فوق بيتنا، فكنا نعرف طائراتهم ونصيح: المخبأ، المخبأ.
«وإذن فقد قصفوا المصنع، وكان فيه المئات من الناس. كنت طفلًا، ولكننى أتذكر. كثيرون جدًا أُصيبوا».
وتذكر فى فخر دور أبيه. «قدم مساعدات كثيرة. وقلت لنفسى: سأصبح طبيبًا مثل أبى. وكان على الجبهة وظل أيامًا دون أن يرجع إلى البيت، ولما رجع أخيرًا رجع وهو فى غاية الإنهاك».
وبمضى السنوات، اكتسب مجدى ثقة فى نفسه. بدأ أترابه يدركون خصاله وسجاياه فيعرفون فيه نضجه وشدة بنيانه القرينة بوداعته. فانتخبوه فى إحدى المدارس رئيسًا لفريق كرة القدم، وحكى أن الأولاد دأبوا على قولهم إنه «إذا حدث مكروه، فمعنا مجدى ينزل بهم العقاب».
كما كان سباحًا ماهرًا. ففى أوقات مختلفة من طفولته، كان حبيب ومادلين يصطحبان الأسرة إلى رأس البر عند ملتقى النيل بالبحر المتوسط. كنا نقيم فى أعشاش مقامة على الشاطئ نفسه، فكأننا فى دنيا الأحلام. هكذا كانت السباحة والبحر طرفًا من قصتى، أما البحر المتوسط فسحر خاص.
بدأ معلمو مجدى يدركون ملكاته التعليمية ويستشرفون له مستقبلًا واعدًا. «كان معلم رياضيات يأتينى قائلًا أعرفك، وأعرف أنك ستعرف جميع الإجابات، فهل تسمح بأن تبقى صامتًا؟ فيبعث ذلك فى نفسى الإلهام وأقول: لن أقول شيئًا يا أستاذ».

فى عام ١٩٤٨، ومجدى فى الثالثة عشرة، انتقلت أسرته لتعيش قرابة سنتين فى أسوان، وهى مدينة على ضفة النيل الشرقية، تبعد أكثر من ثمانمائة كيلو متر إلى الجنوب من القاهرة.
ولأسوان أهمية استراتيجية عريقة، لكونها البوابة الجنوبية إلى إفريقيا، ولما فيها أيضًا من مواقع أثرية. وهى اليوم مركز سياحى يُقدَّر عدد سكانه بمليون ونصف المليون نسمة، ولو أن العدد فى أواسط القرن العشرين كان أقل كثيرًا من ذلك.
انبهر مجدى بأسوان والتحق هناك بمدرسة صغيرة، اشتهر فيها لدى المعلمين، لكن المناظر الطبيعية وطبيعة الناس هما اللتان تركتا فيه أعمق الأثر وأدومه.
قال إن أسوان «فى تلك الأيام كانت أهدأ مما هى الآن، فعندك النيل، والخضرة على جانبيه، ومن ورائها الصحراء. الألوان وحدها فتنة، فليست للصحراء تلك الصفرة الحارقة، ولكنها صفرة رقيقة، والأخضر هناك من أدنى درجات الأخضر، فاللونان فى غاية الخفوت بينما النيل أزرق هائل».
أدهشه أيضًا التعدُّد العرقى فى أسوان، ففيها المصريون والنوبيون وأبناء الصحراء. «بدا لى جلال فى تنوُّع الناس. وفتننى بحق. وتلك هى الخلفية التى رأيت عليها بقايا مصر العتيقة، من معابد أقامتها المحبة والتفانى والفن، ومن أطلال التماثيل الهائلة. بل لقد كانت فى معبد كوم أمبو على مقربة من أسوان، رسوم لأولى الأدوات الجراحية، ضمن الرموز الهيروغليفية».
«فى طفولتى» - كما قال- كان يلهمنى كثيرًا أن أرى كل ذلك الذى يُذكِّر بالحضارة القديمة، وأن أكون على مقربة من جمال النيل. لم نعش هناك إلا عامين فقط، بل أقل وقد قلت لنفسى إننى سأرجع يومًا ما».
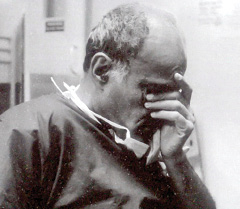
وذلك عهد وفّى به يعقوب فى نهاية المطاف، بأن أقام مركز القلب لعلاج الأمراض المستعصية التى تعترى الفقراء، ولتوفير مئات من فرص العمل فى صعيد مصر. غير أن ترکیز مجدى فى صباه انصب على دراسته وعلى الظفر بمكان فى كلية الطب. اطلاعه، وخاصة فى الطب والعلوم، وشاهد للمرة الأولى جرَّاحًا يعمل، وإن لم تكن بالتجربة السعيدة.
فقد دعاه خاله- الذى تدرب على يدى والد مجدى- للحضور معه فى غرفة العمليات. يقول مجدى: «فذهبت واغتسلت وخلال العملية، بعد رؤيتى كثيرًا من الدم أُغشى على ووقعت على الأرض». فوجئ خاله بعض الشىء، وسارع يسخر منه قائلًا: « وتريد أن تصبح جراح قلب!».
وبعد سنين فسَّر يعقوب ذلك بقوله: «إننى لا أطيق منظر الدم. ولعلك تسألنى كيف يكون ذلك وقد أنفقت عمرك غارقًا فى الدم؟ فى غرفة العمليات أكون فى أتم تركيزى لكننى أشعر أيضًا بأننى أسيطر سيطرة تامة فإن تمزق شىء فما هى بمشكلة. سأسيطر على ذلك. لكن خارج غرفة العمليات فى الشارع، عندما أرى حادثًا، لا أكون أنا المسيطر». لم يُثنه ضعفه أمام منظر الدم، فعقد مجدى العزم على الفوز بمنحة فى جامعة القاهرة المعروفة آنذاك بجامعة الملك فؤاد الأول. إذ استقرَّ لديه أنه لا يريد أن يستعين بأبيه فى دفع مصاريف السنوات السبع التالية.
ظهرت ملكاته الدراسية المبكّرة وخاض الامتحان وهو فى الخامسة عشرة من عمره، وهو لا يزال صبيًا. وكان من الأوراق المطلوبة للمنحة مقالة عن مستقبل العلم، فكتب مجدى عن النشاط الإشعاعى معتمدًا على قراءاته الواسعة وعلى منجزات النيوزيلاندى إرنست روذرفورد، وهو فى نظر الكثيرين أبوالفيزياء النووية، وعالمة الفيزياء الفرنسية مارى كورى. وقد أجازه الممتحنون بتكريم فضلًا عن المنحة.
من بين آلاف الطلاب المتقدمين فى عام ١٩٥١ جاء مجدى ضمن العشرة الأوائل. وحظى جيمى أيضًا بمكان فى كلية الطب فى العام نفسه. وبذلك، لم تنقض إلا سنوات عشر على وفاة عمته الصغيرة يوجين، إلا والغريب ابن بلبيس الذى قرر أن يصبح جراح قلب وهو فى الخامسة من العمر، قد وضع قدمه على الطريق.






















