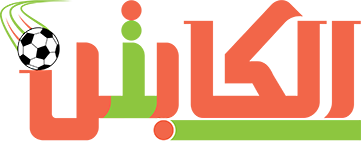آبار الصمت المتواطئ
وأنا أطالع التفاسير القرآنية الكثيرة، والنصوص التاريخية والإسلامية، اكتشفت أن هناك مزالق ارتكبت فى لحظة تاريخية محددة، مازلنا نعيد إلى اليوم إنتاجها بكثير من السعادة.
تحْضرنى الآن ملامح «زولا» وهو يستعد لكتابة رسالته الشهيرة «إنى أتّهم» التى وجّهها لرئيس الجمهورية سنة1889، فى الدفاع عن الضابط دريفوس الذى اتّهم زوراً بتواطئه مع الألمان والتجسس لصالحهم. أتساءل فى ماذا كان يفكّر وهو ينكفئ على ورقة بيضاء كان يعرف جيداً أنها يمكن أن تؤدى إلى المنفى وربّما الموت؟ ما هذه القوة الاستثنائية التى تدفع برجل مثله لأن يذهب نحو الخطر والقلق؟ أعتقد أن الذهاب نحو الحقيقة أو على الأقلّ ما نراه حقيقة هو العامل الحاسم فى عملية مثل هذه. الرجال الاستثنائيون وحدهم يذهبون نحو هذه المخاطر. لأنه عندما كان زولا يصرخ بأعلى صوته، كان آخرون فى موقع الارتباك، أندرى جيد وحتى مارسيل بروست وغيرهما بقوْا فى أفق التساؤل قبل أن تدفعهم الأحداث المتعاقبة للانخراط فى البحث عن الحقيقة مثلما فعل أولا قبلهم بسنوات. ماذا يفعل الكاتب فى نهاية المطاف، سوى البحث المحموم عن الحقيقة.
الحقيقة التى يراها بصدق، قد يخطئ ويتحمّل تبعات خطئه مثلما فعل دْرؤو لاروشيل عندما رأى فى النازية جوانب حسنة، وهو الشخصية اللاّمعة وعندما اكتشف فداحة الانحراف وضع حدّاً لحياته بنفسه ولكنّ الخطأ يناهض الصمت.
فالصمت ليس من فضّة فى الظروف القاسية، ولكنه من أردأ أنواع المعادن التى يمكن أن نتخيلها. الحياة تعلّمنا الكثير فى صوغ هذه الحقيقة وإعطائها هوية تشبهنا وفى أحيان كثيرة تناقضنا، ومع ذلك نذهب نحوها ونتبنّاها وندافع عنها وعن إبداعها فى المؤسسات القاهرة للإبداع والخلق:الدينية، والاجتماعية والعسكرية.
من هنا تصبح الكتابة مجموعة من الجراحات المتواترة. وكلما حملنا قلماً، ازددنا غوراً فى مجاهيلها واقترابا حارقاً منها وتريثاً أمام مشاقها. والدى لم يعد ولكن أختى التى ظلت تنتظره بجدّ أكثر، لحقت به ولم تستطع أن تتحمّل غيابه المزمن. يمكننا أن ننتظر عزيزاً قرناً من الزمن، ونحن نحسب الأيام وكلما صارت المسافة التى تفصلنا عنه ضئيلة، ازدادت سعادتنا، لكننا عندما نفقد أمل اللقاء نخسر الحياة ونفضل أن نختصر كل شىء فى نهاية مستعجلة.
الثورة هى التى أنصفته لأنه كان من المطالبين المحمومين بضرورة الفصل بين المؤسسة المدنية الممثلة فى الحكومة المؤقتة والمؤسسة العسكرية الممثلة فى قيادة الأركان.. شىء من العبثية؟ الجنون واللا عقل؟ هذه الأسئلة تجعل من الحقيقة التى تتوخاها الكتابة مستعصية وصعبة وتجعل من طريقها، معابر مستحيلة.
الحقيقة ليست مسطحة، وليست خطّاً مستقيماً والكتابة الكبيرة هى التى تدخل هذه التعرجات وتتجاوز ما يمكن أن تشى به الحقيقة فى تمظهراتها الخارجية فقط. لم تكن رواية «ضمير الغائب» إلاّ رغبة أخرى فى التمادى نحو جرح الحرب للخروج منه. كانت حقيقة أخرى على الصعيد الاجتماعى قد بدأت تفرض نفسها، فقد بدأ أثرياء الحرب يكشفون عن هوياتهم المختلفة وينشئون مزيداً من خطابات الانفتاح مع الحفاظ على الخصوصية الاشتراكية الوطنية.
إلى اليوم لم أفهم هذه الخصوصية. المعادلات التى كنت أفهمها بسيطة بلد نشأ على خيارات اقتصادية كانت وراءها البيروقراطية الثقيلة التى عشعشت فى المؤسسات، أفرغت كل القيم التى مستها من عمقها، حوّلت الاشتراكية فى الخطاب إلى رأسمالية متوحشة فى الممارسة. والليبرالية المفتوحة إلى قحط ثقافى وممارسة بدائية فى الربح لتنتهى إلى زمر مافيا، تتقاسم اقتصاد البلد وخيراته وحولت الدين بوصفه قيمة متعالية مشتركة للخير، إلى حالة توحّش يصبح فيها المختلف عدوّاً وجبت تصفيته ومحوه.
الاشتراكية التى ينتصر فيها «العامل» دائماً ضد صاحب المؤسسة ويجبره على الانصياع للمطالب النقابية إلى فتوحات «الشخصية الليبرالية» العقلانية والمتفتحة إلى حكمة وتفقه «البطل المتدين، الإسلامى» فى بعض الأعمال الأخيرة. ماذا بقى من وراء هذا التمجيد؟ لا شىء سوى الحقيقة العارية التى لم يستطع الأدب أن يقبض عليها فى الوقت المناسب لأنه لم يطرح الأسئلة الصعبة التى تجعل من الأدب ليست فقط إجابات جاهزة ولكن ديمومة من المساءلات التى كثيراً ما تفضى إلى بعضها البعض بدون القدرة على ترتيب أجوبة صحيحة ومقنعة. لقد ارتبك كل شىء، والكتابة وحدها قادرة على فهم حالة الارتباك هذه شرط أن لا تظل رهينة المظاهر الأولى للحقيقة الموضوعية.
ولهذا فالكتابة لا تنشأ فى الفراغ ولكنها كذلك لا تنشأ داخل حقيقة منجزة ومغلقة.. لم تكن هناك قدرة كافية لالتقاط ما هو جوهرى داخل هذه العملية، حتى ولو كان هذا الجوهرى يناقض قناعاتنا المترسخة والتى توفّر لنا طمأنينة كبيرة. من هنا كان لا بدّ من قتل الأب الشرعى (بالمنطق الفرويدى) والأب غير الشرعى. أى الأب الآتى من وطنك ومن لغتك، أى من فراشك والأب المتأتى من لغة أخرى، هو كيفية تهديم هذه المطلقات لرؤية ما يتخبّأ وراءها من تفاصيل وصراخات وتواريخ صغيرة، طحنها هذا الخطاب.
وأنا أطالع التفاسير القرآنية الكثيرة، والنصوص التاريخية والإسلامية، اكتشفت أن هناك مزالق ارتكبت فى لحظة تاريخية محددة، مازلنا نعيد إلى اليوم إنتاجها بكثير من السعادة.
لغة تقول ولكن فى الوقت نفسه ومن خلال الكلمة ذاتها هناك معنى يتسرسب من بين الأصابع وعلينا أن نقبض عليه بقوة وألا نتركه ينفلت بسهولة مثلما فعل الجيل السابق الذى اعتبر اللغة مادة كاملة ومنجزة. أليست الرواية لغة، ولغة بامتياز، ولهذا وجب العمل بقوة داخل هذا الحقل المعقّد وغير المضمون. يجب أنّ نؤمن بمجموعة من المسلمات وأنّ لكّل زمن لغتَه ولا يمكن نقل لغة إلى عصر غير عصرها لأن هذا سينشئ حواجز بين اللغة ومستهلكها، أى القارئ الذى يتلقّاها. الكتابة لا تعوّض اغترابا باغتراب آخر. فالعصر والدراسات الحديثة والتجارب الخاصة تمنح لنا فرصاً كبيرة لتغيير العلاقة باللغة بحيث تصبح تنتمى إلينا، أى إلى العصر الذى نعيشه.
■ أستاذ القانون الدولى