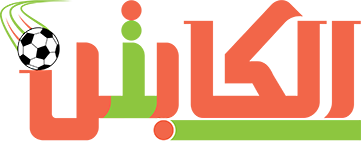الناقد يسرى عبدالله: أصحاب «العقول الأُحادية» رفضوا عمليات التحديث طوال الـ10 سنوات الماضية

طالب الكاتب والناقد الأدبى يسرى عبدالله، بتغيير معايير اختيار المعيدين والترقيات الأكاديمية داخل الجامعة، بحيث تعتمد بشكل أكبر على فكرة الكفاءة، لافتًا إلى أهمية تطوير الأستاذ الجامعى لأنه مسئول عن صناعة أجيال جديدة.
وخلال حواره مع الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز، عبر برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»، قال «عبدالله» إن الشخصية المصرية هى خليط بين مجموعة من الثقافات الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، ويجب تصديرها كهُوية متعددة وليست هُوية أحادية، لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة هى التى حاولت تصدير ثقافتها وطمس بقية الثقافات المصرية.
■ ما أكثر ما يزعجك فى الشخصية المصرية؟
- السؤال يعيدنى إلى فكرة التراكم الحضارى المصرى، والحضارة المصرية أهم مميزاتها أنها متعددة الجذور والهويات، نحن لسنا هوية أحادية، والجين الحضارى المصرى هو من نجح فى عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣ فى مواجهة البرابرة وعصابات التطرف ممثلة فى الإخوان.
وهذا الجين المصرى يعتمد على جذور الهوية المصرية المتعددة، فرعونى وقبطى وإسلامى وحديث، وصولًا إلى إجماع ما يسمى بالشخصية المصرية التى تكون قادرة على خلط كل هذه المؤثرات والكيانات فى سبيكة واحدة، ورغم أنها متنوعة فإنها متناغمة، والهويات المتعددة للإنسان الفرد تعنى أنه ليس له دور واحد بل ينهض بأدوار متعددة، فنحن نمارس أدوارًا مختلفة ومتعددة، فنحن كتّاب وأزواج وآباء، وفكرة الهويات المتعددة هى فكرة أصيلة فى العالم الحر، فيما يسمى باللحظة الحاضرة.
كلامى عن الهوية محاولة للإجابة عن سؤال «ما أكثر ما يزعجنى فى الشخصية المصرية»، والإجابة تكمن فى اختزال هذه الهوية الحضارية المتنوعة فى هوية أحادية، فى محاولة قولبة الشخصية المصرية ودفعها فى اتجاه أحادى متمايز مُعادٍ للتنوير والحداثة والتقدم، وهى كلها أفكار حملتها الجماعات المتطرفة، التى شكلت وباء على الوطن العربى كله، وليس مصر فقط.
■ ما تجليات وانعكاسات العقول الأحادية على الواقعين الاجتماعى والسياسى؟
- أصحاب العقول الأحادية يكرهون فكرة التغيير والتحديث، ولهذا انعكاسات على الواقعين الاجتماعى والسياسى، وهناك رفض لعمليات التحديث التى تنهض عليها الدولة المصرية، خلال الـ١٠ سنوات الماضية، ونجد أنها حالة رفض مجانى دون فتح نقاش حول الأمر، وهو رفض مسبق، لأن الرافض ينظر من زاوية واحدة، إذ يرى أن التغيير فى حد ذاته يمكنه كسر هذه الأيقونات والتصورات القديمة. وهناك هواجس للتغيير، والأمر مركب، حيث تلعب الشائعات دورًا مركزيًا فى ذلك المسار، لأنها تقود العقل العام وتخضع للخيال الشعبى، فنجد أسئلة استنكارية وهى فى فحواها ساذجة، خاصة عند الكلام عن مشروعات التحديث والبناء والتطلعات للجمهورية الجديدة، فينظر إليها دائمًا بحالة من حالات الريبة والقلق.
وينظر إلى مثل هذه التحديثات بشىء من الشيطنة، ويصبح أى شىء إيجابى شيطانًا، والنظر إليه من زوايا أخرى، وهذا ليس فقط نتاج المعنى الكلاسيكى القديم، ولكن يتم دعم هذه الآراء من دول وأجهزة استخبارات دولية، ومنصات ومراكز أبحاث، وانجرّ هذا الطوفان إلى منصات «السوشيال ميديا» التى أصبحت رأس الحربة فى هذا السياق.
وتجليات العقل الأحادى ضيق الأفق، وتأثيراتها على المستويين السياسى والاجتماعى، واضحة جدًا، وأى شخص يتأمل واقعنا يرى آثار محاولات قولبة العقل المصرى العام وتنميطه، فهناك محاولات لـ«صنامية الأفكار القديمة»، إذ ننظر إلى الأفكار القديمة على أنها مقدسة.
أحيانًا يأتى إلينا أحد فلاسفة الفكر ويقول إن الماضى يمثل «النوستالجيا»، أى الحنين إلى الماضى، وكأنه يتكلم عنه من منظور نفسى فقط، وأنا لا أمانع أن يكون الماضى جميلًا، لكن فى الأساس أنا ابن الآن والحاضر، وأنا متطلع إلى المستقبل وهذا ما يجب تعزيزه.
وهنا تجب التفرقة بين مسارين، الأول هو «أدلجة الماضى»، أى النظر إلى الماضى باعتباره «أخنوم» ومقدسًا، وتصوراتى عنه «صنمية»، وأضفى عليها قدرًا هائلًا من القداسة، وتحويله إلى سياق يُتعبد به، ومن الممكن أن ينظر إلى الماضى على أساس كونه تربية لحاجة نفسية وجمالية، ونحن ليست لدينا مشكلة فى المسار النفسى، خاصة بما يتصل بالفن والثقافة، وهو مسار غير مزعج ولكنه تعبير عن فكرة فقدان الوهج فى الحاضر والتحقق الآنى ووجود النماذج المقابلة.
وهناك محاولة لتقديس ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، والحديث طوال الوقت بأن ثورة يوليو هبطت من السماء، والهدف من كل هذا السيناريو هو الهجوم على فكرة الجيش المصرى أو ما يسمى الدولة الوطنية، والهجوم على ثورة ٥٢ يخفى داخله محاولة الهجوم على الدولة الوطنية والجيش.
والدولة الوطنية هى التى استقرت أدبياتها وخلقت منظوماتها، وهى ليست مفهومًا جامدًا، بل هو مرن ويتطور باستمرار، بدليل أنه من أدبيات اللحظة الراهنة أننا نتحدث عن الجمهورية الجديدة، ونحن نتحدث عن جمهورية جديدة نتكلم فيها عن القدرة الشاملة التى تحوى قدرات مادية ومعنوية، وأنت تتكلم عن أن هذا مرتبط بسردية مستقرة تتصل بما يسمى الهوية الوطنية، والتى تعكس الهوية المركزية لجموع المواطنين.
فكرة الدولة الوطنية هى فكرة مركزية، خاصة فى عالم مسكون بالعواصف والتوتر، وأنا هنا لا أتحدث عن تذويب الهويات الوطنية، أو أننى أملك مخاوف زائدة من فكرة الكونية والعولمة الزائدة، ولكن ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة يقول إن هناك محاولة لاستغلال تلك الأفكار، تحت مظلات تحاول أن تأخد أبعادًا فكرية، فنتكلم عن فكرة الخوف ونظرية المؤامرة، ولكننا نمتلك شواهد على كل المستويات، خاصة الاجتماعية والسياسية، تغذى هذه الحالة من التوجس.
ويجب ألا تكون الهواجس محركة للعقل العام، ولكن علينا الانتباه باستمرار وأن نكون متيقظين، فالشعوب اليقظة يمكنها أن تتقدم، ولدينا تاريخ نستعيده فى أدبيات الثقافة حول العالم.
■ يقال إن العقل المصرى أقرب للفكر الأحادى وهو مصاب بحالة سطحية تجعله غير قابل للتحديث.. ما الأسباب التى أدت لذلك؟
- هناك روافد متعددة تؤدى لما يسمى صناعة العقل، وهذه الروافد تشمل روافد معرفية وعلمية وأكاديمية وثقافية، وهذه الروافد تنهض على فكرة التعامل مع الثقافة بمعناها الواسع، وهناك محور مركزى يتصل بالروافد الإعلامية.
ولدينا روافد ثلاثة: التعليم والثقافة والإعلام، وتوجد فيها مشكلات حقيقية، ولكن محور الإعلام فى الفترات الأخيرة عند تحليله نجد أن هناك ما يسمى عقلًا خلف الرسالة الإعلامية، وأستشف ذلك من هذا البرنامج أو برامج أخرى ضمن الروافد الثلاثة.
وعند تحليل الرافد المعرفى، ننظر إلى حال الجامعات المصرية، فنجد أن هناك توسعًا أفقيًا فيها، وتوجد جامعات أهلية وحكومية، تم التوسع فى إنشائها، وكذلك الجامعات الخاصة والدولية.
والتوسع الأفقى هو دور الدولة، ويجب أن يصاحبه توسع رأسى، أى لا بد أن تنهض هذه الجامعات بدورها، ويجب أن تتعامل مع نفسها كمراكز بحثية وعلمية، وليست أماكن لمناقشة الرسائل والماجستير والدكتوراه فقط.
■ ما سبب تراجع الجامعات المصرية بعدما كانت تقود المجتمع؟ ولماذا كان اختراقها أمرًا سهلًا؟
- تراجع الجامعات المصرية، هذا الموقف استدعى واقعة فى الأدبيات القديمة، وهى أن فرنسا عندما خرجت كسيرة من الحرب العالمية الثانية جمع شارل ديجول، رئيس فرنسا وقتها، المسئولين وسألهم: كيف حال الجامعة، قالوا: بخير، قال: «إذن فرنسا بخير»، وهذا يبين دور الجامعة الذى تلعبة فى أى أمة من الأمم.
الجامعة المصرية عندما أنشئت كانت أهلية وتضم النخبة، وعندما تآكلت النخبة حدث تآكل للمؤسسة، وهذا أحد أسباب تراجع فكرة الجامعة، ونرى أن الجامعة تحولت إلى أماكن لبيع الكتب وشرائها وللحصول على الماجستير والدكتوراه دون تدقيق ودون استحقاق أحيانًا، والجامعات هى مراكز أبحاث ومصباح حقيقى للنشر والمعرفة، ومكان لإبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب بالأنشطة الطلابية، وهى مهمة جدًا فى إبعادهم عن فخاخ التطرف.
■ كيف اُخترقت الجامعات من الأفكار المتطرفة؟
- ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة افتتاحية مهمة خلال المنتدى العالمى للتعليم العالى، ودارت حول تحرير التعليم من قبضة الأطراف المتطرفة.
وهناك تقارير أفرجت عنها المخابرات الأمريكية تتحدث عن اختراق المنظومات التعليمية، سواء الجامعات أو المراحل السابقة لها، والهدف من ذلك بناء قواعد دعم للتطرف، والذى يتم من خلال المدرسين بالمدارس، والأكاديميين داخل الجماعات، الذين من الممكن أن يكونوا صفًا ثالثًا أو رابعًا للتطرف، ويكون اختراقًا ناعمًا ويتحول لسطوة.
وسبق وكتبت مقالًا بعنوان «لماذا يخترقون الجامعة»، فالجامعة هى صانعة العقل العام، كما أنه على مستوى السكان فإن الشباب يمثلون قوة هائلة، وبهذا لا يغيب عن حسابات من يحاول اختراق الجامعة هذه الفئة، وفكرة الشائعات عندما توجه تكون موجهة لقطاعات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية.
■ هل حدث تحول فى شخصية أستاذ الجامعة؟ وهل فقد تأثيره ووضعه؟
- أصيبت شخصية أستاذ الجامعة بتحول، مثل تآكل النخبة وانحصار دورها داخل المؤسسة التعليمية، فيجب على أستاذ الجامعة أن يكون له دور ثقافى واجتماعى، ولكن من منهم يستطيع الوصول لقطاعات من الجماهير؟ فطه حسين كان يصل للناس العادية، والأجيال التى تلته فعلت ما فعله.
والناس هى التى تمثل همزة وصل مع هذا الكيان الكبير، فالجامعات بحالتها الراهنة والأكاديميون أيضًا لا يستطيعون أداء هذا الدور لأنه يحتاج لمجهود كبير، وفكرة «المروحة الواسعة»، أى أن يكون الأستاذ مُلمًا بكل الحقول المعرفية المتنوعة وليس تخصصة فقط، أمر خاطئ، كما أن الناقد لا بد أن يكون مُلمًا بكل أمور السياسة والنقد والفن.
والتطرف هو كل ما هو شاذ ومعادٍ لفكرة التقدم والتطور والوعى الخلاق، ونحن ضده، ولا بد من تنفيذ عملية فلترة حقيقية، ولا بد من مراجعة اللوائح داخل الكليات وتوصيفات البرامج الدراسية التى تقدم.
■ هل نحتاج لكل هذا العدد من الطلاب الذى يدخل الجامعات؟
- كانت هناك محاولات تمت على استحياء قبل ٢٠١١، لتقليل عدد الجامعات والاهتمام بالتعليم الفنى، وفى آخر ١٠ سنوات عادت المحاولات ثانية، ولهذا زادت الكليات التكنولوجية التى تصل بين سوق العمل والاحتياجات الفعلية ومدخلات العملية التعليمية، وهذا يجعل الجامعة مصفاة حقيقية حتى يكون الخريج جديرًا بهذا الأمر، ويجد فرصة عمل حقيقية.
الاهتمام بالبرامج الدراسية ومراجعة توصيفات المناهج أمر مهم، ولدينا توصيف للإصلاح، وعلينا معرفة هل التأخير فى تطوير التعليم فى الجامعات ناتج عن أزمة إرادة أم أزمة إدارة، ونعرف أن هناك إرادة سياسية فى الحكومة لإصلاح أحوال الجامعات، وهناك أزمة إدارة فى ملف التعليم الأكاديمى، ونحتاج لخيال جديد فى ملف التعليم وملف الثقافة.
والجماعات المتطرفة حاولت اختراق الجامعات لأنها مصنع العقل العام، ولا بد أن يكون هناك تعزيز لإرادة القوة، ومصر بها إرادة حقيقية، ولا بد من صياغة ملف للتقنين، وأن يكون هناك اهتمام باختيار القيادات الجامعية، ونحن نتحدث عن جمهورية جديدة ونتكلم عن القدرة الشاملة التى تحوى قدرات مادية ومعنوية.
■ هل نحتاج لشروط جديدة فى اختيار المعيدين فى الجامعة؟
- هذا ملف شائك، والاقتراب منه كالاقتراب من الجحيم، وهناك مخاوف من هذا الاقتراب، ولكن لا بد من وضع شروط جديدة للترقيات، ولا بد من وضع معايير لاختيار القيادات الجامعية، وأن تكون هناك قواعد دقيقية وليست قواعد إذعان، وأن يكون شرط الترقيات والاختيارات فى المحاور الأساسية معتمدًا على الكفاءة والنزاهة وفكرة الجدارة، ونحن أبناء فكرة الجدارة، وأزمة الإرادة تحتاج لخيال جديد، بمعنى الاحتفاء الأصيل بفكرة الجدارة، وأن تكون هناك اختيارات نوعية، وتعزيز لفكرة الموهبة، ولا بد من الخروج خارج الأسوار الضيقة، لأن المجتمع الجامعى نخبة حقيقية، وأن يكون هناك تعزيز لفكرة النقد، وأن يتم تعزيزها داخل مجتمعاتنا، لأن هذه مؤسساتنا ولا بد أن تكون أفضل، ونحتاج لأن يرتقى هذا الملف لمرحلة الطموح السياسى للدولة المصرية التى لا بد أن تكون لها علاماتها داخل ملفى التعليم والثقافة، وهذا لا يحدث بأشخاص ليس لديهم الخيال الجديد.
■ هل لدينا طلاب مهتمون بوظائف المستقبل أم أنهم يذهبون للجامعة للحصول على الشهادة وفقط؟
- بالطبع الأجيال الجديدة أصابها ما أصاب المجتمع، وهذا أمر متعارف عليه، ولكن فكرة النظر لأى جماعة بشرية من زاوية أنها كتلة واحدة، وأن الطلاب شىء واحد أمر غير صحيح، ولكن هناك تنوع، وفى المحاضرات تجد أشخاصًا منتبهين وغير منتبهين، وما عليك غير إيقاظ النائم، وهذا يقتضى الرجوع للأساسيات المركزية للجامعة، لأنها فى النهاية توصل الرسالة العلمية وتبنى داخل الطالب أولًا ما يسمى شخصية الفرد الجامعى، والذى يتم على مستويات عديدة.
ولا بد من انتقال الطالب من خانة الحفظ والتركيز والتلقين، إلى خانة التحليل والابتكار والتمييز، والانتقال بالعقل من الخانة المعرفية والعقلية البسيطة البدائية إلى العمليات المعقدة والمركبة، لمواجهة العالم الجديد، ليتم الخروج من فخ العقلية الأحادية المصفحة لمواجهة العالم بتعقيداته وتشابكاته بشكل طبيعى.
ويجب أن نفهم جيدًا أن هذا العالم متغير باستمرار، وأنه يجب تعزيز فكرة الانتماء من الجامعات دون شعارات داخل الطالب والطالبة، لأنهم من سيقودون الدولة المصرية فيما بعد.
ويجب ألا تكون فكرة الوطن ملتبسة، وللأسف الشديد فكرة الوطن عند قطاعات من الأكاديميين ملتبسة، وهذا معنى خطير، والإخوان قدموا فكرة الجماعة على فكرة الوطن، وكل الجامعات بها إخوان، ويتم ذلك من خلال الاختراقات الناعمة غير الظاهرة، وتجد فجأة طوفانًا يعصف بكل شىء، فلا بد على الجامعات من الارتفاع لمستوى هذه اللحظة، ولا بد من إزالة هذا اللبس فى معنى الوطن لأنها قضية أمن قومى.
■ بشكل «مُبسط».. ما صفات «العقل الأحادى»؟
- العقل الأحادى يرى الأمور من وجهة نظره فقط، ويرفض الآخر، وهو عقل إنشائى وينطلق من تصورات يقينية عن العالم وليست نسبية، فهو عقل ضيق الأفق لا يرى التركيب المعقد للعالم من حوله.
ومن الصعب أن ننظر إلى العالم بشكل أحادى، أو من زوايا مثالية، لأن العقل الأحادى سيتحول بالضرورة إلى عقل مسطح، لأنه ابن لفكرة ثابتة غير قابلة للتغير.