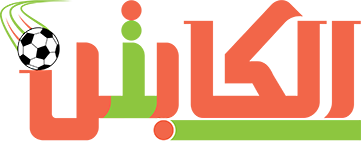بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل
على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وفى جميع أنحاء العالم تقريبًا، قابلت العديد من الأكاديميين العرب والأجانب. وما كان من حوار يجرى، إلا ويبرز فيه اسم العميد طه حسين دون سابق إنذار، فيما يبدو وكأنه اعتراف منهم بأن طه حسين هو أهم وأخطر شخصية عربية خلال المائة عام الماضية. وما زلت أذكر مقولة المترجم الراحل، الدكتور جمال شحيد، الذى قال لى ودون أى تردد: «طه حسين هو الوحيد فينا الذى رأى الحقيقة».
هكذا دائمًا كانت تتقاطع طرقى مع طه حسين، ربما كانت أعمق نقطة فى حياة العميد الفكرية هى التزامه بمبدأ «الشك» منذ نعومة أظفاره وقبل أن يتعرف إلى ديكارت فى دراسته، هذا الشك الذى جعل منه مشعلًا هائلًا للضوء والاستشراف فى مصر الحديثة، وصنع منه قناة للأفكار والرؤى المتعلقة بالحداثة إجمالًا، فى زمن كانت الحداثة فيه لا تزال تتحسس أولى خطواتها فى هذا العالم. لكنه أيضًا، وببساطة متناهية، كان يخوض معاركه وهو أعزل حاسر، حتى من بصره، متسلحًا ببصيرة ووعى نادرين، باعثًا فى حياة المصريين الأمل فى هذا الزمن البعيد، مدافعًا شرسًا عن الحقوق فى مواجهة الإنجليز والقصر، وغيرهم من فئة قطاع الطرق فى بدايات القرن العشرين. كان طه حسين رافدًا ثَرًّا من روافد النيل، واهبًا للحياة والأمل.
لا يمكن لأحد منا أن يزعم بأنه يعرف طه حسين حق المعرفة، ربما قرأنا أفكاره ومنهجه وحقائقه وخيالاته فى أعماله الأكاديمية والأدبية، وربما قدمت لنا «الأيام» (1926-1967) لمحات عميقة من طفولته. ومع ذلك، فما كان لنا أن نعرف طه حسين كما عرفته «مارى»، بغض النظر عن العدد المحدود الذى تسنى لى أن أقرأه من أعماله: كحديث الأربعاء «1925»، والشعر الجاهلى »1926»، وحافظ وشوقى «1933»، وعلى هامش السيرة «1933»، ودعاء الكروان «1934»، وأديب «1935»، ومستقبل الثقافة فى مصر «1938»، وشجرة البؤس «1944»، ومع أبى العلاء فى سجنه «1944»، والمعذبون فى الأرض، مجموعة قصصية «1947»، والوعد الحق «1950»، والشيخان «1960».
ربما ظننت نفسى أعرف هذا الكاتب، والأديب، والأكاديمى، وهذا «المتسقرط» العتيد، نسبة إلى سقراط كما تقول عنه مارى، هذا المتهور، خائض الحروب والمعارك، الذى لم يكن يكل ولا يمل عن أن يكون لبلده مصر مثل ذبابة الخيل، مثلما كان سقراط لأثينا. وربما هناك من يعرف أن الدولة المصرية قد رشحته لجائزة نوبل مرتين، وهو يستحقها، لكنهم لا يعرفون الجانب الآخر الخفى من حياته، وأعنى علاقته بزوجته وابنه وابنته وأحفاده، وعلاقته بأصدقائه، وماذا كان يدور فى عقله قبل معاركه. ربما لا يعرفون أنه انصرف من إحدى هذه المعارك غاضبًا، وكان مريضًا فسافر إلى فرنسا، وفى تسعة أيام فحسب أملى على سكرتيره كتاب «الأيام»، تلك التحفة المعمارية، أدبًا وملامسة واستشرافًا لأجواء بداية القرن العشرين فى القرى المصرية، الغائصة، آنذاك، فى ظلمات الفقر والجهل والعدم.
كيف كان يمكننى أن أعرف طه الإنسان، الحبيب والعاشق والصديق؟! لا يمكن لإنسان، مهما ظن فى نفسه، أن يقترب من جوهر روحه الذاتية مهما كتب. لكن.. أن يكتب الآخر عنك، فهذا أمر يحتاج إلى استعارة عينين جديدتين من أجل قراءة رؤية شاملة لهذا الإنسان.
قررت مارى «سوزان طه حسين» أن تكتب بعد رحيله بعام، نتيجة ضغوط مورست عليها، فكانت رائعتها كتاب «معك»، الذى قدمت فيه رؤية شديدة العذوبة، مرهفة التعبير عن الفقد، لهذه اليد التى ظلت ممسكة بيدها ما يقرب من نصف قرن من الحب، ولتمنحه نورًا يقف به على حافة الليل الذى كان تحوطه دائما، لكنه كان ليلًا خارج روحه، أما روحه الحقيقية فكانت متقدة تشع بأنوارها على الناس فى كل مكان. هذه المرأة الفرنسية السويسرية، التى كانت تذهب إليه لتقرأ له وتعلمه اللغة الفرنسية واللاتينية، وبعد أقل من عامين اقترنا بالزواج. كيف لامرأة فرنسية مسيحية أن تتزوج ضريرًا مسلمًا مصريًا أزهريًا؟! لكن، كما قالت إحدى صواحبها لها، «إنه القدر يا مارى».
«معك»، عمل مترجم، صدر منذ عدة سنوات عن المركز القومى للترجمة، تأليف سوزان طه حسين، وترجمة فى غاية العذوبة والرهافة عن الفرنسية، نهض بها بدر الدين عرودكى، واضطلع بمراجعتها العلامة محمود أمين العالم.
كان ذلك إبان الحرب العالمية الأولى، هذا الرجل الضرير، الذى رحل إلى باريس مغتربًا، يتخبط فى الظلام، ويشكو نقص المعرفة، والتجاهل، وعدم إتقان اللغة، هذا الرجل، بعد سنوات قلائل، يحوله الحب خلقًا آخر، لكنه لم يسلب منه قط الحساسية ولا العطف ولا التعاطف ولا الوعى، ولا الثورة، وقبل كل ذلك وبعده لم يسلبه بلاغة التعبير العربى المبين.
وقد اضطرته الظروف المالية، وسوء صحة سوزان، أن يرسلها وطفليها إلى فرنسا لثلاثة أشهر، كتب فيها تسعين رسالة، وكانت تلك المرة الأولى التى يفترقان فيها. يقول فى إحدى رسائله إليها: «فأنت تمنحيننى كل شىء.. كل شىء، أتسمعين؟! كل شىء دون استثناء.. لقد رحلت فلحق بك كل ذكائى، كل قلبى، كل نفسى، كل شىء فى هذه الرسالة.. ماذا أقول؟! أو لم تحملى كل ذلك معك؟!».
وفى رسالة أخرى يكتب: «ثلاثة أشهر.. ثلاثة أشهر.. فترة رهيبة. لقد استيقظت على ظلمة لا تطاق، وكان لا بد لى من أن أكتب لكِ لكى تتبدد الظلمة.. أترين كيف أنك ضيائى، حاضرة كنت أم غائبة؟!». وفى مقطع آخر يقول: «كانت الزهرة قد ذبلت، فوضعتها فى العلبة التى تركتها لى لأضع فيها رسائلك.. سأقبلها كل يوم، لقد استحالت الغرف معابد، وعلىَّ أن أزورها كل يوم، ولو أنك رأيتنى أخرج من غرفة لأدخل أخرى، ألمس الأشياء، وأنثر القبلات هنا وهناك..».
وها هو ذا يعترف لها فى إحدى رسائله فيقول: «وها هى ذى رسائلك.. رسائلك التى تشفى، فقد شفيت، وأرسلت أخيرًا مقالى. إنه أفضل مقال كتبته منذ رحيلك حول طبيعة المعارضة، ففيه من الفلسفة، ومن علم الاجتماع، ومن السياسة، ومن الهزل، ومن السخرية، كل ذلك مجتمعًا. ألم أقل لك أنا لا أساوى شيئا بدونك؟!». ويستمر فى اعترافه فيقول: «لم أعد أتعرف على نفسى أبدًا.. فلدىَّ شخصيتان، واحدة للعالم، وأخرى لكِ، لى أنا، وفكرتكِ وحدها هى التى تجعلها تعيش.. ولكنْ.. أترين يا سوزان؟! أنا لا أتحدث إلا عنى، إننى أنانى.. وكل الصوفيين أنانيون».
كذلك تلعب الخصومة والمعارك دورهما فى حياة طه حسين، فيخصص لذلك كتبًا. وهنا توضح لنا سوزان بعضًا من الأسباب، فتقول إن طه حسين كان دائمًا شجاعًا، يشبه فى ذلك سبارتاكوس وسقراط؛ فها هو سقراط يقول لحظة تجرعه السم «سأشعر بالمهانة أمام نفسى إن تمسكت بالحياة «، وتناول السم فى هدوء، حين حُكم عليه بالإعدام بعد ان اتُهم بالتجديف فى الآلهة وإفساد عقول الشباب. هكذا كان طه. انظر إليه حين يقول لرئيس الجامعة بعد أن قرروا زيادة ضئيلة لأساتذة الجامعة، فرفض الأساتذة هذه الزيادة، واعتبروها صدقة من الجامعة، وفوضوا طه متحدثًا باسمهم، فكان أن قال لرئيس الجامعة: «إن مجلسكم يقود الجامعة إلى الخراب، إننا سنقوضه، وربما الجامعة أيضًا، ونحن معها، لكن الجامعة لن تبقى بين أيديكم».
ولننظر كيف تصف سوزان زيارة مريديه له فى بيته بعد أن أجرى عملية جراحية صغيرة، تقول: «ثم كانت المسيرة العاطفية التى قام بها الطلبة وموظفو الجامعة من أدناهم إلى أعلاهم، والذين سبق لهم أن جاءوا إلى المستشفى قلقين للاطمئنان عليه، كانوا يدخلون البيت بهدوء، وكان أكثرهم فقرًا يصر على أن يحمل معه السجائر.. كان كل ذلك فى نظرى فى منتهى الرقة». ولم يكن بعد إلا أستاذًا جديدًا، أى أستاذ هذا الذى يجتذب كل هؤلاء باسم الحب الذى استشعروه جميعًا لهم فى محاضراته، ودفاعه عن التعليم وتطويره، ودفاعه عن حقهم فى حياة أفضل؟! ببساطة.. لقد تحول طه فى الحياة المصرية إلى أيقونة للأمل.
أما عن معرفة مصر به، فتقول: «لم يكن طه، قبل سفره إلى فرنسا، نكرة فى بلده، فقد كان يكتب فى صحيفة لطفى السيد «الجريدة»، كما كان يكتب قليلًا فى صحيفة «العلم»، وفى مجلة «السفور». كما أنه كان أول خريج فى الجامعة الجديدة يحمل درجة الدكتوراه، التى نالها عن رسالته عن «أبى العلاء المعرى»، وقد طلب الخديو أن يرى الفائز، واستقبله بحرارة.. وسرعان ما بعث طه فى التعليم روحًا جديدة. ومنذ عام 1920 كان الفرح يغمر قلبه؛ فطلابه «يعضون» (بنواجذهم) على التاريخ الإغريقى، وتلك ثورة فى التعليم كما كان يُنظر إليها آنذاك.
يعلم الجميع العداوة بين العميد طه حسين والرئيس سعد زغلول، لقد كان طه يكتب المقالات ضد سعد زغلول معترضًا على مواقفه. ومن المعروف أن طه حسين كان ينتمى لحزب «الأحرار الدستوريين»، وهو حزب معارض لسياسات سعد زغلول، فى الفترة التى كان فيها سعد رئيسًا للوزراء بين أعوام 1919 و1924، ليس كراهية فى سعد، وانما كراهية لأى تراخٍ من الحكومة فى سبيل تحقيق مطالب الشعب. ومع ذلك تكتب مارى: «حين علم طه حسين بوفاة سعد عام 1927، وكان يقضى الإجازة بلبنان بدلًا من فرنسا، تجهَّم وقال «هذا فظيع».. وقد لاحظ صديق إنجليزى تعرف عليه طه أثناء إقامته هناك، لاحظ وجهه المتشنج حزنًا، فقال له «لا بد أنه صديق عزيز هذا الذى فقدته!»، فأجابه طه «لم يكن لى من هو أكثر عداوة منه». فنظر إليه الرجل طويلًا نظرة لا أستطيع التعبير عن الاحترام الذى كان يُشع منها، ودون أن يلفظ أى كلمة، وضع يده على كتف طه، وربت عليه بقوة».
تحكى مارى عن علاقاته خلال المؤتمرات والرحلات التى كانا يقومان بها معًا إلى ليدن وبيروت، وفيينا فى النمسا، وبروج ولوفان فى بلجيكا، وأكسفورد فى إنجلترا، وعن كل هؤلاء العلماء الذين كان على علاقة وطيدة بهم، عن أحاديثه، وعلاقة الحب والإكبار التى كانت تجمعه بهم، وإلى أى حد كان سريع التأثر بسماع أخبار حزينة عن رحيلهم المفاجئ.
وتحدثت عن تلك الفترة التى تلت نهاية الحرب العالمية الأولى، حين حصل على وسام الأرز، وتحدث عدة مرات فى بيروت، حيث كانت القاعات غاصة بالمستمعين من كل مكان، يستمعون إليه بحب، كانت عالمية طه حسين تفوق أى خيال.
لا تنسى مارى رسالته إليها، حين اضطر للسفر إلى فيينا، بينما تركها مع طفليها فى باريس، فكتب إليها: «علينا ألا نكرر على الإطلاق هذا الفراق الحكيم الأحمق، فبدونك أشعر أنى أعمى حقًا، أما وأنا معك، فإننى أتوصل إلى الشعور بكل شىء، وإلى أن أمتزج بكل الأشياء التى تحيط بى»، مستشهدًا لها ببيت شعر قديم يقول «ناقتى فى البيد تجرى». وتصف كيف أنها كانت تتذوق عباراته بشكل ملهم وبهيج وممتلئ بالإحساس، على الرغم من أن ذلك كان غريبًا عليها فى البدايات.
ثم تذكر كيف تعرض الدكتور طه حسين إلى محنة جديدة فى مارس عام 1932، فتقول: « كان طه يدفع غاليًا ثمن جريمته فى أن يكون إنسانًا حرًا، والحق أنه لم يكف إطلاقًا عن دفع هذا الثمن. غير أنهم كانوا يريدون سحقه حقًا هذه المرة، إذ لم يكتفوا بطرده من الكلية التى كان عنوانًا لعزتها وكرامتها وقوة نابضة فيها، بل أغرقوه بالشتائم، وحاولوا أن يحرموه من كل وسيلة للعيش، بمنعهم، مثلًا، بيع الصحيفة التى كان يُصدرها، وبإنذارهم البعثات الأجنبية فى مصر بالكف عن أن تقدم له عروضًا للعمل. ولا بد لى هنا من الثناء على الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التى تحدت هذا الإنذار، وطلبت إلى طه تقديم مجموعة من المحاضرات، الأمر الذى قدم له دعمًا لا يقدر بثمن».
وحين عُرض عليه الذهاب إلى أمريكا رفض، وكتب لها: «إننى أستاذ معزول، وعالم ممنوع من العمل، ومن واجبى ألا أشتغل بالسياسة، وإنما أؤلف الكتب وأسعى وراء الرزق. أما فى أمريكا فإننى سأكون أجنبيًا، وسأنظر إلى حياة البلد دون أن أشارك فيها». وعلى هذا الأمر تُعلق سوزان بقولها: «نعم.. أيها المناضل، فأنت لم تكتف قط بواجب محدود».
هذا هو طه حسين، حتى أن أحمد لطفى السيد، رئيس الجامعة فى ذلك الوقت، استقال من الجامعة بسبب موقف القصر من طه حسين. وينبغى فى هذا الصدد أن نذكر أن يوم استقلال الجامعات فى مصر مرتبط بتاريخ هذه الاستقالة، التى حدثت فى يوم 9 مارس عام 1932، حين اعترض الدكتور أحمد لطفى السيد على تدخل السلطة التنفيذية فى شئون الجامعة، عقب صدور قرار وزير المعارف بنقل الدكتور طه، عميد كلية الآداب المنتخب، دون الرجوع إلى الجامعة ولا مشاورتها، بل كتب يقول: «إن ما حدث سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وأغيارها». وتحولت مسألة رفض نقل طه حسين إلى إضرابات للطلاب والأساتذة ومجالس الكليات فى كليات الآداب والطب والحقوق.
صحيح أن طه حسين لم يعد للجامعة إلا بعد ذلك بعامين، مع وزارة محمد توفيق نسيم باشا، غير أن قانون الجامعات فى ذلك الوقت قد تم تعديله بناء على شرط أحمد لطفى السيد لوزير المعارف. وحتى حين هتف طلاب الإخوان بسقوط العميد طه حسين عام 1939 رفض لطفى استقالة طه حسين. أما طه ولطفى فقد أسسا وعملا معًا فى مجمع اللغة العربية، وتولى رئاسته طه حسين بعد أحمد لطفى السيد. وبعد كثير من الإحباطات فى جريدته «الوادى»، وصل إلى درجة اليأس والقنوط، وقال لها: «فلتحيا الحرية! ولكن فقط مع من هم جديرون بها».
ولننظر إلى طه حسين كما يصفه أحمد لطفى السيد فى ود وإكبار نادرين الآن: «أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة المعارف، لأن هذا الأستاذ لا يستطاع، فيما أعلم، أن يعوض الآن على الأقل، لا من جهة الدروس التى يلقيها على الطلبة فى الأدب العربى ومحاضراته العامة للجمهور، ولا من جهة البيئة التى خلقها حوله، وبث فيها روح البحث الأدبى، وهدى إلى طرائقه». هذا رأى رئيس الجامعة فى العميد طه حسين.
وها هى ذى سوزان تنقل من خطاب لويس ماسينيون، الذى لم يتخلف عن الكتابة عن طه فى عيده السبعينى عام 1962، واشترك مع بعض الكتَّاب العرب والأجانب، وقد كتب رسالة إلى مارى فى أكتوبر عام 1952 قال فيها: «أكتب لكِ اليوم لأعبر عن مدى إعجابى وفرحى بمشاريعكم، ففى عالم المبتزين والجبناء تتألق شجاعتكم، لتواسى بعض من لا يتوصلون إلى قتل أنفسهم فى الشهادة من أجل العدالة، شأنهم فى ذلك شأنى. إننى أدعو الله أن يبارك طه حسين لقاء الزكاة الروحية التى يؤديها للشعب المصرى، أقبلك يا صديقى.. وليبارك الله زوجتك العزيزة.. بل حتى أعداءك الذين، لولاهم، ماكنت لتنتبه إلى المهمة الملقاة على عاتقك».