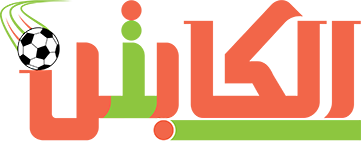زيارة جديدة لـ«نصر حامد أبوزيد» 7
محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. «تصنيع عقل نقدى».. رحلة نصر أبوزيد تنطلق من مدرجات آداب القاهرة

- الاهتمام بالأدب قاد نصر أبوزيد إلى القراءات الفكرية، فبدأ التعرف على العقاد وطه حسين من خلال أعمالهما الإبداعية، التى نقلته بدورها إلى أعمالهما الفكرية
- كان للجامعة وما جرى فيها فضل كبير على نصر، بدأ يدرس قضايا ومشكلات معاصرة مع أساتذة تجديديين حداثيين، بخلاف أساتذة التقليد
لم يكن دخول نصر أبوزيد جامعة القاهرة أمرًا سهلًا.
بعد أن حصل على الثانوية العامة فى العام ١٩٦٨ كان عمره خمسة وعشرين عامًا، كان كبيرًا نوعًا ما، ولذلك عندما ذهب إلى المسئولين فى وزارة المواصلات التى يعمل بها، يطلب منهم الموافقة على أن يلتحق بآداب القاهرة بنظام الانتساب، سخروا منه، لم يمنحوه التقدير الذى يستحقه إنسان يصر على مواصلة طريق العلم والتعليم والمعرفة.
ربما وجدوا الفارق كبيرًا بين عمله كفنى لاسلكى وما يتلقاه الطلاب فى كلية الآداب من علوم وفنون، وربما أدركوا أنه ليس عاقلًا، فمَن هذا الذى يمكن أن يضحى بوظيفة مضمونة تدر عليه دخلًا، ليبدأ دراسة من جديد، فى الغالب نتائجها ليست مضمونة، فهو يعيش فى المحلة وينفق على أشقائه بالكاد، فما الذى يجعله يذهب إلى القاهرة مخاطرًا بكل ما حصل عليه؟
أمام إصرار رؤسائه فى وزارة المواصلات اضطر نصر إلى أن يتقدم إلى مكتب التنسيق، لم يفعل ذلك بنفسه، فقد خاف أن يذهب بأوراقه، فيكتشفوا أنه كبير فى السن فيرفضوا أن يأخذوا منه أوراقه، فى النهاية أصبح طالبًا منتظمًا، ويجب أن يحضر، لكن عانده رؤساؤه مرة أخرى، فأصبح يتأخر عن حضور المحاضرات لبُعد المسافة بين القاهرة والمحلة، ولم يستقر إلا بعد أن تدخلت أستاذته التى كان والدها مسئولًا فى وزارة المواصلات.
المعاناة لم تكن جديدة على نصر، تعود ألا يحصل على شىء بسهولة، لا بد أن يبذل مجهودًا مضاعفًا ليحصل فى النهاية على ما هو مفروض أنه حقه.
لا يهمنى كل هذا هنا، فقد جربناه مع نصر كثيرًا، ورأينا فى كل مرة كيف كان يتغلب على الصعاب التى تقابله، ما يهمنى هو كيف تمت صياغة نصر أبوزيد مرة أخرى بعد أن أصبح طالبًا فى كلية الآداب، وبعد أن استقر فى قسم اللغة العربية، بعد أن أدرك أن قسم الفلسفة لا فائدة منه، فمن يدرسون فيه ليسوا فلاسفة، بل مجرد مدرسين يعلّمون طلابهم الفلسفة.
كيف تكوّن هذا العقل الناقد لدى فنى اللاسلكى الذى اعتقد كثيرون أنه استسلم لمصيره، فإذا به ينفض التراب عن نفسه، ويبدأ حياته من جديد، يقرأ ويعرف ويقرر إعادة صياغة الحياة على أساس ما يرى أنه صحيح وحق وخير ويحقق مصلحة الإنسان بعيدًا عن القهر والظلم؟
عبر نصر فى طريقه إلى العقل الناقد طريقًا طويلًا.
بدأ بالقراءات الحرة خارج إطار المقررات الدراسية فى سن مبكرة نسبيًا، وكان من الطبيعى أن يبدأ بالفن القصصى والروائى، كانت ترجمات «مصطفى لطفى المنفلوطى» لبعض عيون الأدب الفرنسى، وهى ترجمات أشبه بالتمصير، من أهم القراءات الأولى التى أقبل عليها، تلتها روايات جُرجى زيدان التاريخية التعليمية.
لم يتوقف نصر عند المنفلوطى وزيدان طويلًا، فقد عبرهما إلى روايات يوسف السباعى وإحسان عبدالقدوس، ثم كانت النقلة الكبرى عندما قابل نجيب محفوظ على الورق.
فتحت روايات نجيب محفوظ فى عقل نصر عوالم جديدة، أسهمت فى إنضاج وعيه، بدأ معه برواياته التاريخية أولًا، ثم بـ«خان الخليلى» و«زقاق المدق» و«القاهرة الجديدة» والثلاثية «بين القصرين وقصر الشوق والسكرية»، والمجموعة القصصية الأولى «همس الجنون» ثم «دنيا الله».
كان لنجيب محفوظ أثر بالغ فى توجيه نصر أبوزيد إلى العالم القرآنى من مدخل التفسير الأدبى.
قرأ نصر رواية «أولاد حارتنا» لأول مرة مسلسلة فى جريدة الأهرام، لم يكن وقتها يعرف أن ما فعله نجيب هو التعبير الإبداعى عن التداول الأدبى للقصص القرآنى، لكنه أحس أن هناك شيئًا مختلفًا، وأن هذا الشىء المختلف نفسه هو الذى ظل معه حتى تبلور فى دراسات أكاديمية وبحوث لم يسبقه أحد إليها بجرأتها وشجاعتها وما وصلت إليه.
لم يمنح نصر نفسه لأصحاب الروايات والقصص فقط، كان للشعر نصيب، فقد تفتح وعيه الشعرى بأغانى الرومانسية إبراهيم ناجى وعلى محمود طه وجبران خليل جبران وأبوالقاسم الشابى، وتلا ذلك الاهتمام بالإحيائيين محمود سامى البارودى وأحمد شوقى وحافظ إبراهيم، وفى مرحلة لاحقة تعرف على أشعار صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطى حجازى.
امتلأ نصر بتجليات الأدب، فكان من الطبيعى أن يفيض، ولذلك كان طبيعيًا أن يكتب الشعر والقصة القصيرة أيضًا، وظل يفعل ذلك حتى عامه الثالث فى الجامعة- عمره وقتها كان ٢٧ عامًا- حصل على بعض الجوائز الجامعية فى الشعر والقصة، لكنه توقف بعد أن وجد نفسه يميل إلى البحث والدراسة وإلى ما هو فكرى أكثر مما هو إبداعى.
لم يجتهد أحد من الباحثين والدارسين الذين حاموا حول نصر فى جمع أشعاره أو قصصه القصيرة، كان الأمر مهمًا، على الأقل كان يمكننا أن نعرف من خلال عمله الإبداعى كثيرًا عن تكوينه النفسى، وهو الأمر الذى كان سيمدنا بمسارات عديدة تساعدنا فى فهم هذه الظاهرة الخارقة للعادة التى اسمها نصر أبوزيد.
لدينا نموذج من أشعار نصر، قصيدة عثر عليها الشاعر والباحث والمؤرخ الثقافى شعبان يوسف منشورة فى العدد الأول من مجلة «الثقافة الجديدة» وهو العدد الذى صدر فى أبريل ١٩٧٠.
القصيدة عنوانها «من قلب الريف» وفاز بها نصر بالمركز السابع فى المسابقة التى نظمتها الثقافة الجماهيرية، ويشير شعبان إلى أن نصر فى الغالب كان يهجو بقصيدته الشاعر نزار قبانى.
من بين ما قاله نصر فى قصيدته: تتلون أغنيتى بحفيف النخل/ وأنين الساقية الثكلى/ وصراخ الطفل الجائع فى الليل المظلم/ والأرض استلقت كقتيل يلفظ آخر نبضات/ ليس هناك غير الحسرة والأحزان/ وتموت الأغنية على شفة الشاعر.
ويقول نصر ما يؤكد لنا بالفعل أنه كان يقصد نزار قبانى: لكنك يا شاعرنا الأكبر ما زلت تغنى/ لعشيقتك السمراء بقاعات الهيلتون/ ولذات النهد الرجراج بباريس/ وللساق الأخرى فى مدريد/ وغناؤك رغم الأحزان يدق الباب/ يدخل دون استئذان ردهات الدار/ ليعكر صفو الحزن الجاثم فى الأعماق.
يضع نصر نفسه فى مواجهة نزار مباشرة، يقارن بين نفسه وبينه، وينتصر لأشعاره هو بالطبع، حين يقول: معذرة يا سيدى الشاعر/ فأنا أيضًا شاعر/ لكنى من أعماق الريف أغنى/ للأرض لكى تنبت عودًا أخضر/ يأكله الأطفال الجوعى/ أحمل قيثارى وأدور مع الليل الصامت/ علّى أدفئ مقرورًا/ أو أحمل همًا عن محزون/ أو- حتى- أرفع حجرًا كان يسد طريقًا، معذرة يا سيدى الشاعر/ فالليل طويل وحزين/ وبهية ما زالت تبكى ياسين/ ما زال الأطفال جياعًا/ نوقد تحت القدر لنلهيهم/ فيناموا من غير غطاء.
وعندما يرتد نصر إلى نفسه مرة أخرى يهوّن من الأمر على نفسه، يقول: يا سيدى الشاعر/ أعلم أنى ما زلت صغيرًا/ لكنى أحمل فى قلبى هم الأجيال/ ونضال الشهداء العظماء/ من أجل البسطاء المطحونين/ فرجال القرية صفر مهزولون/ يأكلهم دود البلهارسيا/ ونساء القرية يمضغهن السل/ لا حب هناك ولا لمسات ملتهبة/ لا شىء سوى الحزن الجاثم فى الأعماق/ تسخر منه أغانيك المشتعلة بلهيب الجنس/ ولهذا فأنا أرجوك/ باسم الشهداء العظماء/ باسم البسطاء المطحونين أن تصمت لحظة/ حتى تنتهى مراسم الحزن.
أغلب الظن أن نصر كان يحتج على ما كتبه نزار قبانى فى قصيدته الشهيرة «هوامش على دفتر النكسة»، فإذا كان هناك من يجب أن يغضب فهو نصر ومَن هم مثله من شعراء الأرض، أما نزار قبانى الذى كان يصفه نصر بأنه شاعر الأميرات والمترفات، فليس عليه إلا أن يصمت.
كان نصر فى منطقه وفى شعره ساذجًا، جاء ما كتبه تعبيرًا عن دفقة شعورية خالية من المعانى العميقة، ولم تعكس حتى موقفًا واضحًا مما يحدث، ولا أدرى كيف أقنع نصر نفسه بأن يطالب نزار قبانى بأن يصمت، وهو الشاعر الذى ما جاء إلى الدنيا إلا ليتكلم.
لم يكن نصر يعلم أنه وبعد مرور السنوات الثقيلة، وأثناء منفاه الإجبارى، سيجد نفسه يقف أمام قبر نزار قبانى فى سوريا.
فى حواره المطول معه سأله محمد على الأتاسى الذى كان يتحدث معه على هامش زيارته إلى سوريا: ما سبب إصرارك على زيارة قبر الشاعر نزار قبانى فى مقبرة باب الصغير بدمشق؟
يومها قال نصر: إن موت شاعر كبير كنزار قبانى فى إنجلترا، وعودته فى نعش إلى وطنه ليدفن فيه، وما حدث فى لندن، عندما رفض بعض المتطرفين إدخال جثمانه للصلاة عليه فى الجامع، كان له أثر فى نفسى، فحدث نوع من التماهى، تخيلت فيه أن الأمر يحدث مع زوجتى إن هى قررت أخذ جثمانى إلى مصر، طبعًا هناك أيضًا الألم لفقدان شاعر كبير أغنى وعينا بشعره الإنسانى العميق جدًا والبسيط جدًا، شاعر عظيم عاش فى الغربة، وعندما مات باتت السلطة مهتمة بالجثمان، وعرضت طائرة عسكرية من أجل نقله إلى وطنه، هذه الحادثة مست ألمًا فى داخلى.
ألم أقل لكم إن التجارب هى التى تغيّرنا وليست المعرفة فقط.
أعرف أننا تركنا حديثنا عن تكوين نصر الفكرى والثقافى قليلًا، والآن يمكننا أن نعود إليه.
فى المحلة الكبرى شارك نصر فى النشاط الثقافى الذى كانت تحتضنه قصور الثقافة الجماهيرية التى أنشاتها الثورة فى كل المدن المصرية تقريبًا، وأصبح عضوًا فيما يُعرف بشلة المحلة التى كانت تضم عددًا من الشباب الذين أصبحوا فيما بعد نجوم الحياة الثقافية فى مصر، وهم جابر عصفور ومحمد المنسى قنديل وجار النبى الحلو وسعيد الكفراوى وصنع الله إبراهيم وفريد أبوسعدة.
فى كتابه «الصبى الذى كنت» وهو سيرته الذاتية يقول محمد فريد أبوسعدة: تعرفت على المنسى قنديل وجار النبى الحلو، كانوا يكتبون القصص فكتبت قصصًا، وحاولوا هم أيضًا أن يكتبوا الشعر، ثم تعرفنا على فصيل سبقنا إلى تكوين نادى الأدب فى عام ١٩٦٥، سعيد الكفراوى وجابر عصفور ومحمد صالح ونصر حامد أبوزيد ورمضان جميل وبكر الحلو، وكانت مناقشاتنا أشبه بتدريبات عسكرية شاقة لفصيل مهمته غزو العاصمة، وإعداده للتصرف الصحيح فى كل الظروف.
وعن هذه المجموعة نفسها يقول نصر: فى مدينة المحلة الكبرى حيث عملت فنى لاسلكى من ١٩٦١ حتى ١٩٦٨ كونا نادى الأدب فى قصر الثقافة أيضًا، كنا مجموعة من الهواة الجادين تتفاوت اتجاهاتنا واهتماماتنا السياسية والفكرية، ولكن يجمعنا الاهتمام بالأدب بصفة خاصة وبالثقافة بشكل عام، كنا نختلف ونتفق يمينًا ويسارًا أو محافظة وتجديدًا، وكانت قضية الشعر العمودى وشعر التفعيلة من القضايا الساخنة فى الحياة الأدبية، خاصة بعد البيان الذى نُشر آنذاك يتهم الشعراء الجدد بإفساد اللغة العربية وهدم الإسلام.
الاهتمام بالأدب قاد نصر أبوزيد إلى القراءات الفكرية، فبدأ التعرف على العقاد وطه حسين من خلال أعمالهما الإبداعية، التى نقلته بدورها إلى أعمالهما الفكرية، فقرأ «الله» للعقاد، كما قرأ كل عبقرياته، وقرأ لطه حسين «على هامش السيرة» «والفتنة الكبرى»، كما قرأ «فى منزل الوحى» و«حياة محمد» لمحمد حسين هيكل، كذلك قرأ كتابات نظمى لوقا عن الإسلام، وكانت كتابات خالد محمد خالد «من هنا نبدأ» و«هذا أو الطوفان» و«حتى لا تحرثوا فى البحر» و«مواطنون لا رعايا» و«الديمقراطية أبدًا» تثير كثيرًا من النقاش والاختلاف خاصة مع الشيخ محمد الغزالى.
أمسك نصر أبوزيد من هذه القراءات ما يريد أن يكون عليه، يقول: من هنا بدأ اهتمامى بالفكر الدينى، وبدأت قراءة كتابات سيد قطب ومحمد قطب فى الستينيات، فى الوقت الذى كانت كتبهما ممنوعة، وأثار إعجابى بصفة خاصة كتابا «العدالة الاجتماعية فى الإسلام» و«معركة الإسلام والرأسمالية» لسيد قطب، كان الخطاب الدينى فى ذلك الوقت، وقت إنتاج تلك الكتب فى بداية الخمسينيات، جزءًا من مجمل الخطاب الوطنى، تحركه هواجس التحرر الوطنى والعدل الاجتماعى، لا فى مصر وحدها بل على العالم العربى كله، وتجاوب مع اهتماماتى الأدبية منهج التحليل الأدبى للقرآن فى كتابى «مشاهد القيامة فى القرآن» و«التصوير الفنى فى القرآن» لسيد قطب، هذا بالإضافة إلى التساؤل الذى أثاره محمد قطب فى كتابه «منهج الفن الإسلامى»، حول إمكانية استخلاص نظرية جمالية إسلامية، ولم أنتبه إلى أن هذا السؤال وذلك المنهج كانا مطروحين فى الدوائر الأكاديمية إلا بعد دخولى الجامعة.
فى الجامعة بدأت الدنيا تتغير تمامًا من حول نصر أبوزيد، درس فى السنة الأولى تاريخ الأدب العربى القديم، ودرسه التقليديون بشرح الظروف العامة، السياسية والاجتماعية، شرحًا سرديًا بغير تحليل، ثم بعد ذلك تحدثوا عن السيرة الذاتية للشاعر، وتحليل بعض النصوص وقراءتها قراءة تجزيئية بيتًا بيتًا دون قراءة وحدة كاملة.
فى السنة الثانية بالجامعة بعد ما رأى نصر من محاضرات اللغة العربية والفلسفة، كان يفكر فى قسم اللغة الإنجليزية، ولكنه نجح فى الإنجليزية بالكاد، فاختار قسم اللغة العربية.
يحدثنا نصر عن اكتشافاته فى الجامعة، يقول: بدأت الظروف تتغير فأصبحنا ما بين ثلاثين إلى خمسة وثلاثين طالبًا فى المحاضرة، واكتشفت د. شوقى ضيف آخر، ففى محاضرته يناقش ويسمح بالاختلاف ويطلب عمل أبحاث، طلب منا بعض أساتذة الأدب العربى القديم أن نعمل بحثًا لأعمال السنة، فقدمت بحثًا بعنوان «ظاهرة الغزل فى العصر الأموى.. ثلاثة مناهج فى دراستها»، قارنت بين منهج كل من طه حسين والعقاد وشوقى ضيف، وكان غضب الأستاذ علىّ جمًا، لوصفى منهج د. شوقى ضيف مقارنة بمنهجى العقاد وطه حسين بأنه منهج تقليدى، لكنى فوجئت بالدكتور شوقى ضيف يثنى على البحث ويعلن موافقته على أن منهجه تقليدى، بل وأكثر من ذلك يعلن أمام الطلاب جميعًا: ما الفائدة إذا لم تنقدوا أستاذكم؟ كيف يتقدم البحث العلمى إذا ظل الخلف يردد كلام السلف؟ وبدأت أظهر كطالب مجد ومجتهد، ويعرفنى أساتذة قسم اللغة العربية، وحصلت على تقدير عام جيد جدًا، وفزت بالمركز الثالث فى الشعر للسنة الثانية.
مع بداية السنة الثالثة أصبح نصر يذهب إلى الجامعة صباحًا، ومنها إلى وردية المساء بقسم شرطة العجوزة، كان جابر عصفور يدرس له تاريخ النقد الأدبى، وكان منخرطًا فى إعداد رسالته للدكتوراه عن «الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب» بعد رسالته للماجستير عن «الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر»، وكان قريبًا منه طوال الوقت، ومعجبًا بالنظرة الكلية التى ينظر بها لموضوع بحثه عبر مجالات التراث المختلفة.
تعرف نصر على أساتذة آخرين، فبدأ د. عبدالمنعم تليمة يدرس له محاضراته المرهقة عن نظرية الأدب من منظور ماركسى، ويدخل به فى رحاب بعيدة من الفكر الفلسفى للربط بين نظرية الأدب ونظرية المعرفة وارتباط ذلك بالمنظور الفلسفى.
ويحدث ما يحرك الماء الراكد، يقول نصر: «فى محاضرة الأدب المصرى وكان الأستاذ يشرح قصيدة مدح للشاعر تميم بن المعز لدين الله الفاطمى فى أخيه الأصغر منه الذى ولاه أبوهما الخلافة متخطيًا للشاعر، فمدح الشاعر أخاه الخليفة: يا ابن الوصى المرتضى/ يا ابن الإمام المجتبى/ يا ابن النبى المرسل/ ما بال مالك ليس يرميه الندى/ إلا يوافق منه موضع مقتل».
«والأستاذ يحاول أن يقنعنا أن مدح الشاعر لأخيه أيديولوجيا شيعية من تعظيم الإمام، وأشار إلىّ وقال: أنت يا جدع يا تخين أنت واضح أن القصيدة مش عجباك، قلت: فى الواقع يا دكتور مش عجبانى، هذا مجرد نفاق وترديد لكلام سابق، وليست بها عاطفة ولا إحساس، نظر لى الأستاذ وقال: وهتكتب دا فى ورقة الامتحان؟ قلت: بالطبع لا، وبدأت أذكر عليه الأحكام التى ذكرها هو على القصيدة، فقال الأستاذ: طيب إيه رأيك إنى قرأت الإلياذة ولم أعجب بها؟، تصور الأستاذ أن نقدى هو إهانة للأدب العربى، وليس مناقشة من أجل التعلم، فى هذه السنة حصلت على تقدير ممتاز، وكان إحساسًا لذيذًا على الرغم من مشكلات الوطن».
كان للجامعة وما جرى فيها فضل كبير على نصر، بدأ يدرس قضايا ومشكلات معاصرة مع أساتذة تجديديين حداثيين، بخلاف أساتذة التقليد، الجامعة نظمت له قراءاته، كما كان للحوار والجدل داخلها والخلافات السياسية والاجتماعية والتظاهر ضد حالة اللاسلم واللاحرب التى اتبعها الرئيس السادات فضل تنشيط كل خلايا التفكير فى عقله.
يقول نصر: فى هذه المرحلة بدأت أدرس الخطاب الدينى التقليدى، وبالتحديد العلاقة بين الأدب والدراسات الإسلامية فى صورة أوسع، واتسعت قراءاتى فى الفلسفات من الماركسية إلى الوجودية، ولم أتخل عن منظورى الإسلامى العام، والرغبة فى تحقيق عدالة اجتماعية، لكن وصلت إلى قناعة أنه لا يتقدم مجتمع أو يتأخر لأنه مجتمع مسلم أو غير مسلم، بل يتقدم أو يتأخر طبقًا لقوانين تدرس فى علوم أخرى، العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، والنظر فى بنية المجتمع فى تعقيداتها، والعلاقات بين الطبقات ووسائل الإنتاج، والعلاقة بين وسائل الإنتاج وأنماط الإنتاج، نحتاج إلى وسائل وآليات أخرى لبناء مجتمع متقدم.
بدأت تتسع نظرة نصر للتأثير الأدبى والفنى للقرآن وتتجاوز اهتمامات سيد ومحمد قطب التى تعتمد على الانطباعية، بدأت صلته تتوثق بفكر الشيخ أمين الخولى ومدرسته التى تعود بذورها إلى فكر الإمام محمد عبده، من أن القرآن كتاب هداية للبشر، وليس كتابًا فى التاريخ أو العلوم، الهدف الأول له هو هداية البشرية إلى الطريق المستقيم، ويستخدم القرآن اللغة العربية لتوصيل رسالته إلى المؤمنين، وكان رأى أمين الخولى أن القرآن الكريم هو كتاب العربية الأكبر، وقبل أن نستخرج منه أحكامًا قانونية أو فقهية أو جمالية يجب أن يدرس أدبيًا، وبدأت أقرأ فى جهود محمد عبده والشيخ على عبدالرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وطه حسين وكتابه «فى الشعر الجاهلى» والقضية التى أُثيرت حولهما وكتابات الشيخ أمين الخولى ومحنة مدرسته فى نفس قسم اللغة العربية.
كانت الجامعة هى الخطوة الأولى فى مشوار نصر أبوزيد الطويل، وكان هناك أستاذ آخر لعب الدور الأكبر فى حياة نصر أبوزيد وهو الدكتور حسن حنفى.
غدًا.. ماذا فعل حسن حنفى بنصر أبوزيد؟