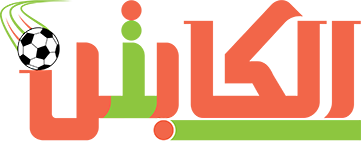«شهود على نهاية عصر».. ستة كتاب يرصدون أثر الانفتاح على مصر

مع نهايات عصر جمال عبدالناصر وبدايات عصر السادات، بدأ ظهور أنماط وسمات جديدة فى المجتمع المصرى، أطلق عليها بعض المثقفين وعلماء الاجتماع «عصر الانفتاح»، ويصف شكرى عياد هذه الظاهرة قائلًا: لعله قد آن الأوان لكى نحاول فهم كلمة ظهرت فجأة فى حياتنا، كما تظهر الوجوه الجديدة فى السينما، ولكنها لعبت، منذ أول ظهورها، أدوار البطولة.. فى الأفلام والمسلسلات، ولا تزال بعد عشر سنوات من بدايتها الباهرة، تشق طريقها الصاعد بين نجوم الكلمات، غير آبهة لصيحات الإدانة أو هتافات الإعجاب.. أقصد كلمة «الانفتاح».
وفى كتاب «شهود على نهاية عصر- تحول المجتمع المصرى عام ١٩٧٠» لشتيفان جوت، الصادر عن المركز القومى للترجمة، وترجمة أيمن شرف، يحاول الكاتب الإجابة عما حدث فى عصر الانفتاح، وما التوقعات التى كانت مأمولة منه؟ وكيف بدأ بالضبط؟ وما تأثيراته ونتائجه؟.
وبشكل موجز منصف، لخص شتيفان جوت أهم أحداث كل عصر، بداية من جمال عبدالناصر حتى عصر مبارك، موضحًا سلبيات وإيجابيات كل عصر، الذى كان بمثابة عامل مهم فى تغيير وجه وثقافة المجتمع المصرى.
ويبدى المؤلف رأيه فى عصر ناصر قائلًا: إذا كان نجاح إصلاحات ناصر الزراعية فيما يتعلق بتقليل التفاوت الاجتماعى متواضعًا، فإن إلغاء الإقطاع يُحسب لصالحه.
ويضيف شتيفان أن عبدالناصر قام بالاقتراض بكثافة قبل الحرب من الخارج؛ لكى يمكنه تمويل سياسات الرعاية الاجتماعية والتنمية، بالإضافة للنفقات العسكرية أثناء حرب يونيو، ثم تحدث بشىء من التفصيل عن الركود الاقتصادى المحلى، الذى ذكر له أسبابًا عدة، ومحاولة سداد الديون وإنعاش الاقتصاد، لكن المصادر الرئيسية فُقدت بسبب الحرب، ومع تزايد الأزمات التى ذكر الكاتب الكثير منها، بشكل مفصل، فقد نظام الحكم الناصرى ثقة الشعب، وأصبح موضع تساؤل على نحو متزايد، ثم يتقلد السادات الحكم بعد وفاة عبدالناصر، ويقول شتيفان: كانت البلاد تمر من نواحٍ كثيرة بأزمة لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الهزيمة فى حرب ١٩٦٧، لكن أيضًا من خلال العيوب المتأصلة فى النظام الناصرى، التى باتت واضحة بالفعل فى السنوات السابقة على الحرب.
وبدأ السادات فى اتخاذ عدة إجراءات إصلاحية، أهمها اكتساب ود طبقة أصغر لكنها أنشط، رغبة منه فى أن تكون عاملًا فى تنمية مصر اقتصاديًا، وتكون قاعدة جديدة للسلطة، فبدأت الطبقة العليا تستعيد مكانتها التى فقدتها فى العصر الناصرى.
وكان من أهم إجراءات سياسات الانفتاح التى اتخذها السادات، السماح «بمناطق التجارة الحرة» المعفاة من الجمارك المحلية والضرائب، والسماح للمستثمرين الأجانب بتأجيل دفع الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى حصول رأس المال الغربى، بالفعل عام ١٩٧٠، على حق الدخول الحر للأراضى المصرية.
وبالرغم من أن تلك السياسات أدت إلى طفرة هائلة فى إنشاء شركات استثمار لا حصر لها، وحققت تجارة الاستيراد أرباحًا ضخمة، لكن هذه التطورات لم يستفد منها سوى دائرة صغيرة نسبيًا، وهم الذين لديهم أموال، ولم يحدث تقريبًا أى تطور فيما يخص الطبقات العريضة من المواطنين.
ويُبدى شتيفان رأيه فى سياسات السادات قائلًا: كان من المفترض أن يوفر هذا الانفتاح، باعتباره أيديولوجيًا، استمرارًا للثورة «الحرية مرة أخرى»، بعد أن فُقدت بسبب التأثير الطاغى لمراكز القوى داخل الاتحاد العربى الاشتراكى فى الماضى، لكن كان هذا كله محض خيال، وبسببه تراجعت بشكل واضح سياسة الرعاية الاجتماعية التى كان يعطيها ناصر أهمية كبرى، مثلها مثل النمو الاقتصادى لصالح السادات.
ويستكمل الكاتب رؤيته لنظام السادات فى سياسته الخارجية والداخلية، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، للمواطن المصرى، حتى وفاة السادات وانتقال السلطة لمبارك، الذى حاول وقف النمو الرأسمالى الجامح فى عهد سلفه، والسير فى طريق وسط «للانفتاح الإنتاجى».
ثم ينتقل بنا الكاتب لتأثير هذا الانفتاح على شكل ومضمون الأدب، وكيف تأثر وهاجر وتوقف كثير من الكتّاب عن الكتابة بسبب سياسات عهد السادات ورؤيته للأدب والفن.
عصر الانفتاح وتأثيره على الأدب
كان الأدباء الذين نشأوا وبدأوا الكتابة فى عهد عبدالناصر، ينتمون فى غالبيتهم إلى الطبقة الوسطى، التى استفادت بشكل واضح من الإنجازات السياسية والرعاية الاجتماعية، والتى تأثرت بشكل واضح بسياسات الانفتاح فى عهد السادات، ويصف شتيفان الوسط الثقافى فى السبعينيات بالانكماش مقارنة مع عهد عبدالناصر، رغم تعرض الكتّاب المعارضين للاعتقال مرات كثيرة فى عهد ناصر، وممارسة الرقابة عليهم، لكن شهد الإنتاج الثقافى دعمًا حيويًا من جانب الدولة، فى حين أن هذا الدعم تردّى فى عهد السادات.
ووفقًا لدراسة أجراها جونزاليس كيخانو «عام ١٩٨٨»، فخصخصة كثير من دور النشر، رغبةً فى التوسع فى الانفتاح، جعلت كثيرًا من دور النشر كغيرها من شركات الانفتاح، موجهة نحو السوق وغير مدعومة، ما أدى هذا إلى طفرة فى الكتب الجديدة، لكنها طفرة لم يجد فيها الكتاب الجيد مكانه بسهولة.
واستمر الوضع حتى بداية الألفينيات، من سيادة الإعلام المقنن، واقتحام القيم الاستهلاكية، واختفاء القيم الاشتراكية التى أصبحت سيئة السمعة، وهجرة المثقفين المصريين، وظهور أزمة الهوية المصرية، وتضخم الغيبيات، واللواذ بمقولات متوهمة عن الماضى والسلفية النموذجية، التى وصفها شتيفان بأنها كانت شديدة السذاجة والتدمير للمجتمع، وصاحب كل هذا تذبذب ممارسات الديمقراطية التى ارتبطت بغياب المثقفين، سواء فى إعلان القرار أو اتخاذ القرار، وبالتالى انعكس كل هذا على الأدب.
ست حالات أدبية تلتقط سلوك التغيير والانكسار بالمجتمع المصرى
يتناول شتيفان فى كتابه «شهود على نهاية عصر» ستة أعمال روائية لفتحى غانم ونجيب محفوظ وعبده جبير وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطانى، كانت بمثابة تجسيد لتحولات مهمة فى المجتمع المصرى، ذكرنا بعضها سابقًا.
جدير بالذكر أن شتيفان جوت وقع اختياره بجانب أعمال كتّاب من جيل السبعينيات، لاثنين من الجيل السابق، هما «فتحى غانم ونجيب محفوظ» ليبزر مدى التأثير الذى فرض نفسه على كل الأجيال، بالإضافة لفهم وجهات نظر أجيال متباينة تجاه سياسات الانفتاح.
فى رواية «قليل من الحب.. كثير من العنف» لفتحى غانم، يحلل شتيفان رؤية فتحى غانم لظاهرة تحول بشر عاديين إلى وحوش، ومدى تأثير التفاوت الاجتماعى ودوره فى الصراع من أجل المال والنفوذ، وكيف يؤدى هذا كله فى النهاية لانتصار قوى الشر والعنف الاجتماعى، ففى السبعينيات كان الانتصار للوحشية والحيوانية داخل الإنسان.
ثم ينتقل لرواية «الحب فوق هضبة الهرم» لنجيب محفوظ، الذى يعد بمثابة مؤرخ حقيقى لشريحة مهمة فى المجتمع المصرى، ويحلل الكاتب هنا رؤية محفوظ لأهم المشاكل الأساسية التى يعانيها جيل السبعينيات، فنجد البطل عاجزًا عن تحقيق رغبة أساسية وهى الزواج، فيتمرد على العادات ويُنشئ علاقة غير رسمية، ثم يحاول سرقة المتعة التى هى حق طبيعى له، بممارستها فوق سفح الهرم، و«أهل القمة» التى تناقش نفس تلك القضايا الشائكة، ومحاولة التكيف فى مجتمع أصبحت فيه معايير الشرف مقلوبة.
ثم جبير فى «تحريك القلب»، الذى يمثل الجيل الثانى من الكتّاب الشباب فى السبعينيات، كما أنه يمثل الأدب التجريبى فى تلك الحقبة، فيسرد بشكل غرائبى أزمة مجموعة من السكان فى بيت يوشك على الانهيار، ليواجه هؤلاء البشر تلك الكارثة بالمبالاة والعزلة، فيحلل شتيفان كيف للمرء فى ظل تلك السياسات أن يتحول لحالة إنسانية غريبة، تتمحور حول ذاتها وتحلق فى فراغ مجرد.
ثم صنع الله إبراهيم ورواية «اللجنة»، وكيف ينزلق مواطن مثقف يسارى نحو التكيف مع سلطة الرأسمالية، وعجزه عن التكيف مع الوضع الذى وقع فيه.
وأخيرًا الغيطانى فى «رسائل البصائر فى المصائر»، ورسم صورة لخمسة عشر مصيرًا لبشر، تفقد قيمها الإنسانية، وتتخلى عن واجبها تجاه الوطن والآخرين، وتتنازل أمام السلطة والمال عن كل شىء، لتواجه مصيرها القبيح فى النهاية.