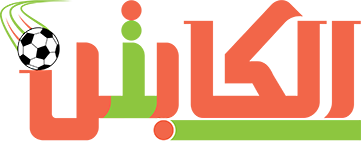«الدستور» تحتفل بالذكرى الـ150 لميلاده
د. أحمد مجاهد يكتب: حافظ إبراهيم: شاعر الشعب.. النيل سابقًا

أحمد شوقى لقبه بـ«شاعر النيل» لميلاده فى دهبية على شاطئ النهر
طه حسين قال عنه: «لم أعرف شاعرًا مصريًا أحبه الشعب كما أحب حافظًا»
مات أبوه وهو فى سن الرابعة وكفله خاله بمنزله وأدخله المدرسة الخيرية الابتدائية
شعوره باليتم ظهر فى قصائده العديدة التى تفيض ألمًا ورقة
فشل فى المحاماة فقرر الالتحاق بالمدرسة الحربية.. وأحيل للمعاش مرتين بسبب شعره السياسى
تمر هذا العام ١٥٠ سنة على ميلاد حافظ إبراهيم، وتسعون سنة على وفاته أيضًا، حيث ولد فى عام ١٨٧٢ ومات فى ٢١ يونيو ١٩٣٢. وقد عاش حافظ «شاعر النيل» ستين عامًا ذاق فيها عذابات اليتم والفقر والقهر السياسى حينًا، وكفالة الأيتام وكرم البكوات وشغل الوظائف العليا بالدولة حينًا آخر.
أما لقب شاعر النيل فقد أطلقه عليه صديقه أحمد شوقى لأكثر من سبب؛ الأول: أنه قد ولد فى دهبية راسية على شاطئ النيل عام ١٨٧٢، حيث كان والده المهندس إبراهيم فهمى أحد المشرفين على قناطر ديروط. والثانى: أن حافظًا أثناء فترة التحاقه بالجيش، قد خدم بالسودان لمدة عامين، وقد أشار شوقى إلى ذلك فى رثائه له، حيث قال:
يا مانح السودان شرخ شبابه/ ووليه فى السلم والهيجاءِ
لما نزلت على خمائله ثوى/ نبع البيان وراء نبع الماءِ
والثالث: أنه قد حصل على «وسام النيل» من الدرجة الرابعة.
أما السبب الرابع: فهو سبب غير معلن، وهو أن اللقب الآخر الذى كان يفضله حافظ فى حياته، وقد أزاحه لقب شاعر النيل، كان يقض مضجع شوقى شخصيًا، وهو اللقب الذى اختاره طه حسين عنوانًا لما كتبه عن حافظ بكتابه تقليد وتجديد، وهو «شاعر الشعب».
وقد قال العميد فى مقاله: «ولذلك لم أعرف شاعرًا مصريًا أحبه الشعب كما أحب حافظًا، ولم أعرف شاعرًا مصريًا استطاع أن يكون فى الشعراء ترجمانًا ناطقًا عن الشعب كما كان حافظ». هذا بالإضافة إلى أن حافظًا كان يحفظ قصائده ويلقيها بأداء مبهر على الجمهور الذى كان يعشق سماعها منه أكثر من حبه لقراءتها، أما شوقى فكان لا يستطيع إلقاء قصائده وكان يترك هذه المهمة لشخص آخر، فهو لم يكن شعبيًا أو جماهيريًا قط.
أما عذابات اليتم فترجع إلى أن حافظًا قد مات أبوه وهو فى الرابعة من عمره، فعادت به والدته من ديروط إلى القاهرة، وكفله خاله بمنزله وأدخله المدرسة الخيرية الابتدائية بالقلعة ثم مدرسة المبتديان ثم المدرسة الخديوية ثم انتقل مع خاله مهندس التنظيم إلى طنطا والتحق بمدرسة ثانوية فيها، لكن حافظًا لم يهتم بدراسته التى تركها، بل اهتم باللغة العربية وبقراءة الشعر والأدب، ولم يبحث لنفسه عن مورد رزق وقد بلغ عامه السادس عشر، فغضب عليه خاله، وكتب له حافظ ذات صباح:
ثقلت عليك مؤونتى/ إنى أراها واهية
فافرح فإنى ذاهبٌ/ متوجهٌ فى داهية
فعمل حافظ بالمحاماة التى لم تكن تتطلب شهادة حينها، بل كانت تتطلب متحدثًا مفوهًا، لكنه فشل أيضًا. فقرر العودة إلى القاهرة والالتحاق بالمدرسة الحربية التى كانت تقبل الحاصلين على الشهادة الابتدائية وفقًا لنصيحة صهره الضابط محمد كانى، وقد تخرج فيها عام ١٨٩١ وكان فى العشرين من عمره تقريبًا.
وقد ترتب على هذا اليتم شيئان؛ الشىء الأول فى الشعر: وهو وجود قصائد عديدة لحافظ تفيض ألمًا ورقة فى افتتاح دور الأيتام، وفى الدعوة للتبرع لها، ومنها قوله فى حفل دار رعاية الأطفال بالأوبرا عام ١٩١٠:
شبحًا أرى أم ذاك طيف خيالى/ لا، بل فتاةً بالعراء حيالى
أمست بمدرجة الخطوب فما لها/ راع هناك وما لها من والِ
ما خطبها، عجبًا، وما خطبى بها؟/ مالى أشاطرها الوجيعة مالى؟
دانيتها ولصوتها فى مسمعى/ وقع النصال عطفن إثر نصالِ
ولا يخفى على القارئ هنا على المستوى الموضوعى تأثره الأسيان بحال الفتاة اليتيمة التى ذكرته بحاله هو فى طفولته، وتأثره على المستوى الفنى بقول المتنبى مع اختلاف الوزن وتطابق القافية:
رمانى الدهر بالأرزاء حتى/ فؤادى فى غشاء من نبالِ
فصرت إن أصابتنى سهام/ تكسرت النصال على النصالِ
والشىء الثانى نجده فى الواقع المعيش نفسه، حيث قام حافظ بكفالة طفلتين يتيمتين بمنزله، برعاية زوجة خاله التى لم تجد من يكفلها بعد وفاة زوجها، فأخذها حافظ وأكرمها وأصبحت سيدة الدار والقيّمة عليه، وبخاصة أنه لم يتزوج سوى مرة واحدة، وقد استمر زواجه لمدة أربعة أشهر فقط.
أما عذابات الفقر فقد ارتبطت باليتم حينًا، وبالقهر السياسى حينًا آخر. فحين خرج حافظ إلى المعاش من الجيش عام ١٩٠٣ بناءً على طلبه بعد أن خدم به ١٣ سنة، أحيل خلالها للاستيداع مرتين بسبب شعره السياسى، كان ما زال برتبة ملازم أول، وكان راتبه أربعة جنيهات فقط وهو الكريم المسرف. وكيف لا وهو القائل عام ١٩٠٠ أثناء خدمته بالجيش، على سبيل المثال:
لقد غدت مصر فى حال إذا ذكرت/ جادت جفونى لها باللؤلؤ الرطبِ
أيشتكى الفقر غادينا ورائحنا/ ونحن نمشى على أرضٍ من الذهبِ
كأننى عند ذكرى ما ألم بها/ قِرْمٌ تردد بين الموت والهربِ
إذا نطقت فقاع السجن متكأ/ وإن سكت فإن النفس لم تطبِ
وقد نجحت السلطة متمثلة فى المستعمر الإنجليزى والقصر معًا، فى إسكات حافظ القرم الشجاع الصنديد، بعد أن أراقت ماء وجهه وأرهقته فى البحث عن لقمة العيش حتى عام ١٩١١، حين ساعده أحمد حشمت باشا، ناظر المعارف العمومية، وعينه رئيسًا للقسم الأدبى بدار الكتب المصرية تحت الاختبار بمرتب ٣٠ جنيهًا، ثم ثبته، وطلب له رتبة البكوية من الدرجة الثانية التى حصل عليها عام ١٩١٢، ثم أنعم عليه بوسام النيل من الدرجة الرابعة، وأخذ يترقى فى دار الكتب مقابل صمته عن كتابة الشعر السياسى لمدة عشرين سنة، هى ثلث عمره الناضج بالتمام والكمال.
وعندما طلب حافظ فى سن الخامسة والخمسين الإحالة للمعاش بمرتب ٥٠ جنيهًا نظرًا لمكانته الأدبية الرفيعة، رفض طلبه خشية من عودته للشعر السياسى، على الرغم من أن مرتبه فى ذلك الوقت كان ٤٠ جنيهًا، وأن مرتبه قد وصل عند إحالته للمعاش فى فبراير عام ١٩٣٢ إلى ٨٠ جنيهًا كاملة.
على أن حافظًا فور إحالته للمعاش وفى الأشهر القليلة المتبقية من عمره قد عاد إلى سيرته الأولى، ومن بين ما كتب قصيدة طويلة تبلغ نحو مئتى بيت وصلنا منها أقل من عشرين، كمعظم شعر حافظ الذى لم يصل إلينا؛ لأنه كان يحفظه ولا يدونه، ولم يجمع شعره من الجرائد وينشر فى ديوان إلا بعد وفاته، هذا بخلاف الشعر الذى كتبه وكتمه معه فى قبره لأسباب سياسية، وهو يقول فى مطلعها:
قد مر عامٌ يا سعاد وعامُ/ وابن الكنانة فى حماه يضامُ
صبوا البلاء على العباد فنصفهم/ يَجْبى البلاد، ونصفهم حُكامُ
ويقول مخاطبًا الإنجليز:
أمن السياسة والمروءة أننا/ نشقى بكم فى أرضنا ونضامُ؟
إنا جمعنا للجهاد صفوفنا/ سنموت أو نحيا ونحن كرامُ
كما يقول مخاطبًا إسماعيل صدقى رئيس الوزراء حينها:
ودعا عليك اللهَ فى محرابه/ الشيخُ والقسيسُ والحاخامُ
حتى قصيدته الرائعة عن مظاهرة النساء التى كتبها فى ثورة ١٩١٩ تم توزيعها عندئذ بوصفها منشورًا سياسيًا مجهولًا، ولم يتم نشرها باسمه سوى عام ١٩٢٩ بعد أن تغيرت الأوضاع السياسية وسمحت بذلك، والتى يقول فيها:
خرج الغوانى يحتججن/ ورحت أرقب جمعهنه
وأخذن يجتزن الطريق/ ودار سعد قصدهنه
يمشين فى كنف الوقار/ وقد أبَنّ شعورهنه
ويبدو أن حافظًا كان مشغولًا بقضايا المرأة عمومًا وبقضية الحجاب بصورة خاصة، حيث يؤكد فى البيت الأخير أن كشف السيدات شعورهن لم يخرجهن عن «كنف الوقار». فقد أدرك حافظ مبكرًا أن تحرير المجتمع رهن بتحرير المرأة، حيث يقول فى قصيدة أخرى:
من لى بتربية النساء فإنها
فى الشرق علة ذلك الإخفاقِ
ليست نساؤكم أثاثًا يقتنى
فى الدور بين مخادع وطباقِ
ولهذا فليس غريبًا عليه أن يقوم برثاء قاسم أمين، موضحًا رأيه فى قضية الحجاب، ومشيرًا إلى أنه رأى يسبق زمنه، وسوف تثبت الأيام صحته، حيث يقول:
إن رِيت رأيًا فى الحجاب ولم
تعصمْ، فتلك مراتب الرسلِ
الحكم للأيام مرجعه
فيما رأيت فنم ولا تسلِ
وكذا طهاة الرأى تتركه
للدهر ينضجه على مهلِ
ويفهم مما سبق أن حافظًا كان من أنصار السفور وإن لم يذكر ذلك صراحة. كما أنه قد قام أيضًا برثاء سيدة فى ديوانه، وهذا أمر نادر فى ذلك الوقت، وهى ملك حفنى ناصف. وقد أعلى فى رثائه لها من قيمتى العقل والعلم بوصفها إنسانًا نابهًا لا يعانى من التمييز النوعى، حيث قال:
وتريك حكمة نابهٍ
عرك الحوادث واختبرْ
بالعلم حلت صدرها
لا باللآلئ والدررْ
على أن رأى ملك حفنى ناصف نفسها فى قضية الحجاب هو الأفضل من وجهة نظرى الشخصية، حيث قالت:
فدعوا النساء وشأنهن فإنما
يدرى الخلاص من الشقاوة من شقى
وأمامكم غير القناع مآزق
أولى بها التفكير من ذا المأزقِ
ليس السفور مع العفاف بضائرٍ
وبدونه فرط التحجب لا يقى
حيث ترى ملك أن لبس الحجاب أو خلعه اختيار شخصى حر للمرأة ولا يجب أن يشغل الرجل نفسه به، كما ترى أن العبرة بجوهر الأخلاق وليس بشكل الثياب، وأن هناك قضايا مجتمعية أخرى أكثر أهمية علينا أن نشغل أنفسنا بها.
وعلى الرغم من تمسك حافظ الشديد بإسلامه أولًا وبعروبته ثانيًا، وكتابته نشيد جمعية الشبان المسلمين الذى يقول فى مطلعه:
أعيدوا مجدنا دنيا ودينا
وذُودوا عن تراث المسلمينا
فمن يعنوا لغير الله فينا
ونحن بنو الغزاة الفاتحينا
فإن حافظًا لم يكن متعصبًا دينيًا فى يوم من الأيام، حيث يقول مثلًا مخاطبًا الخديوى عباس عقب عودته من دار الخلافة لعرض ما كان فى مصر من خلاف بين المسلمين والأقباط عام ١٩١١:
مولاى أمتك الوديعة أصبحت
وعُرى المودة بينها تتفصمُ
نادى بها القبطى ملء لهاته
أن لا سلام وضاق فيها المسلمُ
وهمٌ أغار على النهى وأضلها
فجرى الغبى وأقصر المتعلمُ
فهموا من الأديان ما لا يرتضى
دينٌ، ولا يرضى به من يفهمُ
كما أنه يذهب إلى أبعد من ذلك كثيرًا فى إيمانه بحرية العقيدة، حيث يقول عام ١٩١٠ فى رثائه للمبدع الكبير تولستوى، الزاهد الذى عاش يزرع أملاكه ويقسم ما تنتجه بينه وبين فلاحيه قبل أن يوزع أرضه عليهم. لكن كل هذا لم يشفع له، فقد اتهم بالخروج عن الكنيسة، وحكم بكفره فى آخر حياته:
ولست أبالى حين أبكيك للورى
حوتك جنان أم حواك سعيرُ
فإنى أحب النابغين لعلمهم
وأعشق روض الفكر وهو نضيرُ
دعوت إلى عيسى فضجت كنائس
وهز لها عرش وماد سريرُ
وقال أناس إنه قول ملحدٍ
وقال أناس إنه لبشيرُ
وأيقنت أن الدين لله وحده
وأن قبور الزاهدين قصورُ
كما أنه لم يكن يصمت عن نقد ما يراه من عادات المسلمين التى يعدها من البدع، مثل التبرك بأضرحة الأولياء ورصد النذور لهم، حيث يقول:
أحياؤنا لا يرزقون بدرهمٍ
وبألف ألفٍ تُرزق الأمواتُ
من لى بحظ النائمين بحفرةٍ
قامت على أحجارها الصلواتُ
يسعى الأنام لها، ويجرى حولها
بحر النذور، وتُقرأ الآياتُ
ويقال: هذا القطب باب المصطفى
ووسيلةٌ تقضى بها الحاجاتُ
كما أنه لا يمتنع عن نقد الشيوخ أنفسهم إذا لزم الأمر، وتصويرهم فى صورة كاريكاتورية ساخرة، حيث يقول:
وفقيه قومٍ ظل يرصد فقهه
لمكيدةٍ أو مُستحل طلاقِ
يمشى وقد نصبت عليه عمامةٌ
كالبرج لكن فوق تل نفاقِ
أما قمة استنارته الدينية فتتمثل فى دفاعه عن طه حسين وكتابه (فى الشعر الجاهلى)، حيث وصل الأمر إلى حد الاتهام بتكفير العميد وخروجه عن الإسلام، بل طالب بعضهم بإهدار دمه، وكان منهم الدكتور عبدالحميد سعيد، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية الشبان المسلمين وقتئذ، فقال حافظ:
إن صح ما قالوا، وما أرجفوا
وألصقوا زورًا بالعميدِ
فكفر (طه) عند دَيَّانه
أحب من إسلام عبدالحميدِ
فقد كان حافظ من أنصار التعليم المدنى، وكان لا يوافق على التوسع فى إنشاء الكتاتيب لتعليم مبادئ القراءة والكتابة فقط، بل كان يطالب بدعم الجامعة المصرية، حيث يقول مثلًا فى حفل خصص إيراده لمشروعها عام ١٩٠٧:
إن كنتم تبذلون المال عن رهبِ/ نحن ندعوكم للبذل عن رغبِ
ذر الكتاتيب منشيها بلا عدد/ ذر الرماد بعين الحاذق الأربِ
فأنشأوا ألف كتابٍ وقد علموا/ أن المصابيح لا تُغنى عن الشهبِ
ولا يخفى على القارئ الحصيف أن حافظًا قد اتفق بقصيدته هذه مع قصيدة أبى تمام الشهيرة: «السيف أصدق أنباءً من الكتب/ فى حده الحد بين الجد واللعب» فى الوزن «بحر البسيط» والقافية، لكنه قد قصد مخالفته فى المضمون، حيث يرى حافظ أن الكتب والعلم أهم من السيف فى بناء نهضة الدول وتقدمها.
وقد كان حافظ منحازًا للتناص مع المتنبى من التراث الشعرى العربى كما رأينا سابقًا، حتى إنه كان يشير إليه أحيانًا بالاسم فى متن القصيدة، حيث يقول مثلًا:
وكم ذا بمصر من المضحكات/ كما قال فيها أبو الطيبِ
أمورٌ تمرُّ وعَيشٌ يُمِرُّ/ ونحن من اللهو فى ملعبِ
مع ملاحظة أن البناء اللغوى للشطر الذى يقول فيه حافظ «أمور تمر وعيش يمر» يذكرنا بالبناء اللغوى فى مطلع قصيدة شوقى الشهيرة «سنون تعاد ودهر يعيد»، وبخاصة أن القصائد الثلاث من بحر المتقارب.
أما اللافت للنظر حقًا فهو تناص شاعر الشعب مع الأمثال الشعبية العامية، حيث يقول مثلًا متأثرًا بالمثل الشعبى «اللى بيته من قزاز، ما يحدفش الناس بالطوب»:
يا ساكن البيت الزجاج
هبلت، لا ترمى الحصونا
أرأيت قبلك عاريًا
يبغى نزال الدارعينا؟
كما أنه يتناص أيضًا مع الألفاظ الشعبية الشائعة التى تعبر عن عادات المصريين المحبوبة والمذمومة أيضًا، حيث يقول مثلًا:
ما هدَّ عزم القادرين
بمصر إلا قول: باكرْ
كم ذا نحيل على غدٍ
وغد مصير اليوم صائرْ
ولهذا نجد التناص الأكبر مع شعر حافظ قد جاء من شعراء العامية، حيث يقول مرسى جميل عزيز مثلًا متناصًا مع المقطع السابق:
مهما تواعدنى حأقول لك بكره
ويجى بكره حأقول لك بكره
وعندما قال حافظ فى سياق رثائه لملك: «وتركت شيخك لا يعى/ هل غاب زيد أم حضر؟» مشيرًا إلى حزن والدها حفنى ناصف الذى كان مشهورًا بعلم النحو واللغة، وكان مدار الأمثلة فى النحو على «زيد»، تأثر به حسين السيد فى أغنيته «أبجد هوز» الساخرة مستخدمًا العبارة ذاتها:
إن غاب زيد أو حضر
طب واحنا مالنا، إنشالله ما حضروا
أما صورة الأبنودى الشهيرة المدهشة التى يشبه فيها رغيف الخبز بالقمر بالنسبة للفقير الجائع، حيث يقول:
يا قمر يا رغيف بعيد
النهار ده الحد عيد
الغناى ليه مبسوطين
والفقير ليه مش سعيد
فإنك تجدها بنصها فى قصيدة حافظ، وفى السياق نفسه أيضًا، حيث يقول:
وغدا القوت فى يد الناس كالياقوتِ
حتى نوى الفقير الصياما
ويخال الرغيفَ فى البعد بدرا
ويظن اللحوم صيدًا حراما
وقد حاول حافظ كتابة المسرح الشعرى كما فعل شوقى صديقه اللدود، فنظم قصيدة تمثيلية عام ١٩١٢ عقب ضرب الأسطول الإيطالى مدينة بيروت فى حربهم مع الأتراك. وهى تقع فى ثمانى صفحات من الديوان، ولا تحتوى على أى إرشادات مسرحية، بل هى مجرد حوار شعرى فى أحسن أحوالها. وشخصيات هذه الرواية التمثيلية أربع: الجريح اللبنانى، وزوجته ليلى، والطبيب، ورجل عربى. لكنه لم يكرر هذه التجربة أو يطورها، فقد كان يفضل أن يكون هو النجم الأوحد فى تقديم إبداعه البسيط الساخن لجمهوره الجائع لصوت يعبر عن مشاكله فور وقوعها.
ولا يعنى هذا أن شوقى أفضل من حافظ أو العكس، فقد حاول بعضهم توريط العميد فى المفاضلة بينهما، لكنه لم يفعل قط، بل عدد المناقب التى تميز بها إبداع كل منهما، قبل أن يجمعهما فى سياق واحد يفخر فيه بهما، بعد أن نجحا مع مجايليهم فى سحب بساط ريادة الشعر إلى مصر لأول مرة فى تاريخ الأدب العربى.