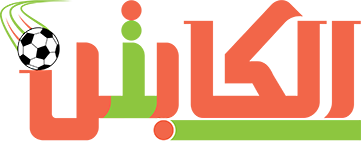معركة نبيل عبدالفتاح ضد التسليم بالأفكار القديمة عبر اللغة

قد يكون من المدهش أن يكرس باحث جاد رسالة علمية عن دور اللغة فى مقالات مفكر من أبرز مفكرى علم الاجتماع فى أيامنا هو نبيل عبدالفتاح. المصدر الأول للدهشة هنا هو انصراف الجامعة منذ زمن عن حركة الأفكار وضجيج التحولات السادرة حولها، سواء فى عالمنا العربى أو العالمى، ومن ثم بدا غريبًا ومحمودًا فى الوقت نفسه أن يحدث مثل هذا التحول. أما المصدر الثانى للدهشة فهو ما استقر فى الأذهان من أن البحث السوسيو ثقافى فى تجلياته المختلفة، سياسيًا واجتماعيًا، إنما يسير بوتيرة لغوية ذات طبيعة أدائية أو وظيفية كمادة لنقل المعنى ليس أكثر، غير أن قارئ نبيل عبدالفتاح ستفاجئه بنية لغوية مدهشة فى تماسكها واتساع مدى دلالاتها، وتركيبيتها، وانفتاحها على فكرة طالما رددها مفكرنا تدور حول دور اللغة فى تجديد المعانى، وهو منحى ربما كان يقف وراء ولع مفكرنا الكبير بالفنون كافة وبالفنون اللغوية على نحو خاص، لا سيما الشعر. ومن خلال متابعتى معظم ما كتب المفكر نبيل عبدالفتاح أستطيع القول إن معظم مؤلفاته تكرس فصلًا أو فصولًا عن اللغة، رغم أنه ليس من رجال اللغة، لذلك فإن تلك الاهتمامات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفكرته الراسخة عن أن تجديد الأفكار لا بد أن يستتبعه تجديد اللغة ومن ثم تجديد وضبط المصطلح النقدى، لا سيما فى العلوم الإنسانية، لكن ذلك أيضًا لا بد، حسب عبدالفتاح، أن يمر عبر ارتباط اللغة بمحيطها الحركى الضاج بالتحولات المعرفية، ولا يمكنه أن يتم عبر عزلة أفاض فى الحديث عنها ألسنيون من مدارس عدة. ونستطيع أن نتبين الموقف السلبى من هذه القضية لدى عبدالفتاح فى أكثر من موضع مثل موقفه من مدرسة فيينا على سبيل المثال التى تعتبر اللغة هى العالم، لأنه يرى أن اللغة يجب ألا تكون الأداة الوحيدة لتشكيل وفهم العالم، لكنها فى الواقع أكثر ارتباطًا بالمعرفة البرهانية التى لا تقع موقعًا صحيحًا إلا من خلال اللغة، وهذا المنحى يعد استكمالًا لإدانته فكرة تديين اللغة عبر إحياء بلاغة قديمة تجاوزها الزمن، ويرجع ذلك، حسب عبدالفتاح، إلى الخوف الرهابى، على الموروث الدينى، تحت دعوات فارغة من المعنى مثل فكرة الدفاع عن الهوية. فاللغة الدينية لغة توحيدية أيضًا مثلها مثل الأديان ومن ثم ينظر لها باعتبارها كائنًا لا متناهٍ، بينما المفكر والفنان لا يفكر على هذا النحو لا سيما فى عصورنا الحديثة. أيضًا يرى عبدالفتاح أن تسييس اللغة واحد من معضلات تطورها، حيث يتم توظيفها فى الصراعات السياسية، وهو أمر ينتهى بمزيد من فرض الوصاية على اللغة والفكر معًا. أما أخطر ما يشير إليه المفكر نبيل عبدالفتاح فهو العوائق التى تلاقيها فكرة تجديد اللغة فى العلوم بصفة عامة، وفى مجال العلوم الاجتماعية على نحو خاص، حيث تنتج التصورات المحافظة اصطلاحات مشوهة وجامدة رغم أنها تتناول واقعًا استقر بعض ظواهره ولم يعد موضعًا لأى التباسات.
لذلك أتصور أن الباحث «إسلام صلاح الدين» قد أقدم على عمل جليل وفائق الوعى عندما أدرك فرادة الخطاب اللغوى لدى نبيل عبدالفتاح، فسهر على تقديم رسالة علمية حصل بها على درجة الماجستير من الجامعة الفرنسية بالقاهرة وصدرت قبل أيام عن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان «الخطاب الحجاجى.. آلياته ووظائفه فى مقالات نبيل عبدالفتاح». نظرة الباحث، بطبيعة الحال تختلف عن نظرة المفكر أو الكاتب الذى يعتمد على فكرة الكشف والابتكار، غير أن الباحث يأتى دوره فى تقعيد تلك التصورات وبحث مرجعياتها وردها إلى أصولها والكشف عن توجهاتها الجمالية والفكرية. وهو ما تقدمه الرسالة بطبيعة الحال. والحجاج، حسب التعريف العلمى والمعجمى الذى قدمه الباحث هو منازعة الحجة، ومن هنا فإن الحجاج يطلق عليه اسم البلاغة الحديثة، لأنها- حسب الباحث- تقصد إلى دراسة الآليات الموظفة فى الخطاب لجذب انتباه المتلقى وإقناعه، ويراها الباحث بهذا المعنى امتدادًا لبلاغة أرسطو. وقد قدم الباحث إسلام صلاح الدين تمثيلات شتى على صورة البلاغة ومدلولاتها لدى نبيل عبدالفتاح وحلل استخداماته آليات مثل التكرار والاستعارة واستخداماته الأفعال، فضلًا عن أساليب القصر والتعليل. وربما هذا البحث يأتى تفسيرًا لدعوة نبيل عبدالفتاح الباحثين إلى ابتكار ما يسمى باللغة الانتقالية الجديدة، مع اللغة المابعدية التى واكبت التغيرات الثقافية والسياسية فى إطار مقاربات موضوعية للقضايا التى تتناولها حسب تعبير مفكرنا. غير أن ثمة ملاحظات يمكن رصدها فى تلك الرسالة وهى عدم تطرق الباحث إسلام صلاح الدين لصورة الخطاب السوسيو ثقافى لدى كبار العلماء بالمقارنة بخطاب عبدالفتاح مثل: ماكس فيبر ودوركايم وبيير بورديو وأنتونى جيدنز، أقصد البحث فى منهجيتهم فى استخدام اللغة وتوظيفاتها فى نصوصهم البحثية. وقد أجرى الباحث العديد من المقاربات بين مفهوم نبيل عبدالفتاح للغة وبين بعض البلاغيين واللسانيين فى الثقافتين العربية والغربية، لكن ثمة مدارس لسانية مهمة وجديرة بالتنويه فى هذا الصدد ربما كانت تحتاج إلى المزيد من النقاشات فى مواجهة تجربة مفكرنا، فما طرأ على العقل طرأ أيضًا على اللغة، كما أشار عبدالفتاح فى أكثر من كتاب له. فعلمنة العقل الأوروبى كان لا بد أن تتبعها أيضًا علمنة اللغة، لكن وعى نبيل عبدالفتاح أخذه بعيدًا جدًا عن فكرة البنيويين عن اللغة باعتبارها نسقًا مكتفيًا بذاته. نبيل يعرف جيدًا أن اللغة أساس لكل أنظمة الدلالة، لأن جميع المذاهب الإنسانية والكون كله يشتركان فى بنية عقلية متحركة بعكس ما يقول به البنيويون عن الأنساق الثابتة، وأظن أن هذا الجمود خرج من بين أيدى ألسنيين كبار مثل تودروف وتشومسكى وليفى شتراوس، لكنهم عادوا وتراجعوا عن فكرة الفصل المنهجى للغة بقصد دراستها، وغابت عن الأذهان النزعة الموضوعية التى اعتبرت اللغة نظامًا ثابتًا مستقلًا عن فاعلية البشر. وهو ما أدركه نبيل عبدالفتاح مبكرًا من أن اللغة لا يمكنها أن تتشكل فى المجامع ولا فى مراكز التقطير البحثى ومعازله بل تتشكل كما، قال بورخيس، فى أفواه الفلاحين فى الحقول وفى أفواه الصيادين فى البحار التى تضج بالموج والانفلات. هذا التصور المرن لدى مفكرنا الكبير منحه المزيد من المرونة فى التعامل مع الأنساق الرجعية التى تحتاج إلى الكثير من التقويم، لذلك كان دائمًا ضد خطاب الأنماط البطريركية التى تؤمن بما يسمى بالوعى الكلى أو المطلق. من هنا سنجد مصطلحات نبيل عبدالفتاح تقفز فى الزمن إلى المابعديات بالنقد والنقض أحيانًا وبالتعضيد أحيانًا أخرى، كما نقرأ فى مناقشاته لما بعد الحداثة ولما بعد اللغة ولما بعد الحقيقة التى تعرض لها عبدالفتاح وناقشها بصرامة الباحث الذى يضرب بإزميل من نار على رأس جبال من الرجعية والثبات والجمود. وطالما تحدث مفكرنا عن اضطراب مفهوم ما بعد الحقيقة باعتباره تعبيرًا عن موت الواقع الحقيقى تحت وطأة تمثيلاته ونسخته الأصلية أو تحت النماذج المتخيلة، كما يقول جان بودريار، وهو ما أشار إليه تعريف معجم أكسفورد، كما نقله عبدالفتاح من أن ما بعد الحقيقة تعنى أن تصبح الحقيقة الموضوعية أقل تأثيرًا فى الرأى العام من الحقائق المزيفة أو الجزئية التى تعد مجرد صورة من الأصل.
وفى النهاية لا بد من أن نثنى بشدة على جهد الباحث الجاد إسلام صلاح الدين وكذلك الجامعة والأساتذة الذين أشرفوا على البحث وناقشوه، وهو دور لا بد أن تستعيده جامعاتنا لتحقيق المزيد من التأثير فى محيطها الفكرى والاجتماعى والخروج من عزلة الدرس المنهجى المغلق والأكثر نمطية.