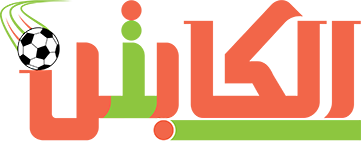أن تكون صلاح عبدالصبور.. أحمد مجاهد يكشف أسرارًا جديدة عنه فى ذكراه الأربعين

تظل واقعة موت صلاح عبدالصبور حادثة درامية دالة ومعبرة عن مسيرته ومأساته، على الرغم من مرور أربعين سنة على وفاته.
كانوا مجموعة من الأصدقاء فى سهرة منزلية يفترض أن تكون حميمة، بمنزل الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى احتفالًا بعيد ميلاد ابنته، ولكن هل كانت بصيرة صلاح تستشرف المستقبل حين قال فى إحدى قصائده: «كانت بيننا صداقة عميقة كفجوة»؟
لا شك فى أن هذه الكوكبة كانت من كبار المثقفين المحترمين: «جابر عصفور، أمل دنقل، بهجت عثمان» بالإضافة إلى حجازى وصلاح، وأنهم جميعًا كانوا- بصورة أو بأخرى- من ضحايا صراع المثقف والسلطة فى تلك الحقبة السياسية. ولكن كيف كان يرى كل منهم طبيعة الدور المنوط به فى ظل هذا الصراع؟ تلك هى المشكلة.
لم يكن صلاح منتميًا لأى فصيل سياسى، وقد كرهه الإخوان المسلمون والشيوعيون والناصريون، ولهذا لم يجد من يناصره فى زمن نفخت فيه أبواق الأيديولوجيا النقدية فى أنصاف وأرباع المواهب، وحولتهم إلى بالونات ضخمة ملونة فى سماء الإبداع، وقد انفجرت تلك الفقاعات وتحللت بعد ذلك بلا رجعة.
لم يكن صلاح مهادنًا، ولا مواجهًا كذلك. وكان يعتمد على مهارته الإبداعية فى توصيل رسالته، دون مباشرة لا تأمن حسن العواقب. حيث يقول:
إنى أتكلم بالأمثال، لأن الألفاظ العريانة
أقسى من أن تلقيها شفتان
لكن الأمثال الملتفة فى الأسمال
كشفت جسد الواقع
وبدت كالصدق العريان
وعلى الرغم من ذلك فإن دواوينه كلها لم تضم من هذا الشعر السياسى الرمزى سوى قصيدة واحدة هى: «عودة ذى الوجه الكئيب» بديوانه الأول (الناس فى بلادى) الصادر عام ١٩٥٧، والتى أشار فيها إلى خلافه المبكر جدًا مع جمال عبدالناصر.
وقد كان هذا الخلاف متعلقًا بغياب الحرية واعتقال أنصار اليمين وأنصار اليسار فى الوقت نفسه، حيث يشير فيها إلى ذلك القائد ذى الأنف المقوس، الذى أقعى على باب المدينة يسأل سؤالًا واحدًا: من خالق الدنيا؟ وينتظر الإجابة:
الملتحون تهللوا، وأجاب رائدهم بصوت مستفيض:
الله خالقها! وهذا لا يصح به السؤال
وعوى أبوالهول المخيف، وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار
ورمى بجمع الملتحين إلى الدمار
والأمردون تأملوا، وأجاب رائدهم بصوت مستفيض:
لا نستطيع! بل نحن نعرف! إنه قدم الطبيعة
وعوى أبوالهول المخيف، وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار
ورمى بجمع الأمردين إلى الدمار
وتقدم الدجال والقواد والقراد والحاوى الطروب
وتضعضعوا! قالوا: معاذك! أنت خالقها، أجل
أنت الزمان، أنت المكان، أنت الذى كان
أنت الذى سيكون فى آتى الأوان
وعوى أبوالهول المخيف، وقلب الوجه الكئيب إلى اليمين
وأشار، ثم تواثبوا فوق الآرائك جالسين
فصحيح أن صلاح لم يرفع رماح الرفض المسنونة مثل أمل دنقل وبهجت عثمان سوى فى هذه القصيدة، لكنه أيضًا لم يمدح الزعيم فى سلطانه، ولم يغن للاتحاد الاشتراكى، كما أنه قد خصص مسرحه الشعرى كله- خمس مسرحيات- لمهاجمة الوضع السياسى فى الحقبة الناصرية، وبخاصة مع عامل التذاكر «عشرى السترة» فى مسافر ليل، و«السمندل» فى الأميرة تنتظر، ثم مع «الملك» فى «بعد أن يموت الملك».
لقد كان صلاح عبدالصبور يتفق تمامًا مع لوسيان جولد مان فيما كتبه بمقال: «المادية الجدلية وتاريخ الأدب»، حيث يقول: «إن العمل الأدبى نفسه هو بالنسبة للفنان، وبخاصة بالنسبة للمفكر، ليس مجرد فعل، بل هو أيضًا أكثر الأفعال فاعلية من بين ما يستطيع أن يفعله». أليس هو القائل:
أقول لكم:
بأن الفعل والقول جناحان عليان
وأن القلب إن غمغم
وأن الحلق إن نطقت
فقد فعلت، فقد فعلت!
ولهذا لم يتنازل صلاح عبدالصبور قط عن ممارسة دوره التنويرى فى كل ما كتب من أنواع أدبية، ولا فى مسيرته الوظيفية أيضًا، فهو مؤسس مجلات: «فصول وإبداع والقاهرة» على سبيل المثال لا الحصر، وقت أن كان رئيسًا لهيئة الكتاب فى عصر الرئيس السادات. لكنه كان مكتفيًا بممارسة هذا الدور العميق والمهم فى إطار إنسانى عام، دون أن يكون مناضلًا ثوريًا.
فغاية الأصدقاء واحدة، وهى مواجهة السلطان المستبد من أجل تحقيق الحرية والعدل، لكن رؤية صلاح عبدالصبور تعى أن سلاح السلطان لا يتمثل فى السيف فقط، حيث يقول على لسان «الأستاذ» رئيس التحرير فى مسرحية (ليلى والمجنون):
يا أصحابى الشجعان
يشتد علينا سيف السلطان وذهب السلطان
وأطالبكم أن تقفوا جنبى
لا أخشى أن يصرعكم سيف السلطان
لكنى أخشى أن يفسدكم ذهبه
فلماذا كل هذه القسوة التى لا تعترف بالضعف الإنسانى ولعبة التوازنات، وبخاصة أن بعضهم قد قبل مناصب مماثلة وأكثر، فى ظروف مشابهة على الأقل؟ ولماذا قال بهجت عثمان لصلاح عبدالصبور: «أنت بعت القضية يا صلاح لتنعم بالمناصب» بعد عدم تمكنه من منع مشاركة إسرائيل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام ١٩٨١، فأصابه بأزمة قلبية قاتلة، على الرغم من أن بهجت عثمان نفسه كان قد توقف عن رسم الكاريكاتير السياسى بعد معاهدة كامب ديفيد؟ وهل كانت عبارة بهجت عثمان وحدها هى سبب هذه الأزمة التى أدت لوفاته؟.
لقد تعلمنا فى الدراما أن هناك نوعين من الصراع: الصراع الخارجى، والصراع الداخلى.
والصراع الخارجى هنا يتمثل فى طبيعة العلاقة بين هذه المجموعة من الأصدقاء، والتى قد تحتوى على بعض الاختلافات الأيديولوجية، أو المنافسة الإبداعية، أو الغيرة الوظيفية، وكل هذه النوازع النفسية الطبيعية لا تنفى المحبة والاحترام المتبادل، وهو ما ظهر واضحًا فى ردود أفعالهم عقب الوفاة، وبخاصة فى قصيدة رثاء حجازى له التى بدأها قائلًا فى صدق بالغ: «ما حيلتى؟ وخطايا أقصر من خطاك».
أما الصراع الداخلى، وهو الأقوى والأشد تأثيرًا، فيكون بين الإنسان ونفسه. وهو ما يتجلى بوضوح فى قصيدة دالة بديوان صلاح عبدالصبور الأخير «الإبحار فى الذاكرة»، وهى قصيدة «الموت بينهما»، حيث تعد هذه القصيدة الدرامية بامتياز، من المسكوت عنه فى شعر صلاح عبدالصبور.
وأنا لا أملّ من تكرار قول إن انتقال «صلاح» من كتابة الشعر العمودى إلى شعر التفعيلة لم يكن قفزة عروضية فى الهواء، كما هو الحال عند بعضهم، بل كان انتقالًا نوعيًا واعيًا بقصيدته من الغنائية الخالصة نحو الدرامية، ولهذا كان من الطبيعى أن يتوج رحلته الإبداعية بكتابة المسرح الشعرى.
وفى هذه القصيدة الطويلة يقدم لنا الشاعر حوارًا جريئًا متخيلًا بين الشاعر وخالقه، فى إطار من التصوف. فهى تقوم بالتوالى على ذكر مقطع من النص القرآنى تحت عنوان «صوت عظيم»، يليه مقطع يمثل حوار الشاعر معه تحت عنوان «صوت واهن».
والصوت العظيم الأول هو بداية سورة الضحى، حتى قوله تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فترضى»، ثم يبدأ الصوت الواهن بقول الشاعر:
أين؟
أين عطائى يا رب الكون
ها أنذا أتعثر بين البابين
ها أنذا أسقط فى المابين
قربت، فأعطيت،
حتى بللت الشفتين بماء التسنيم،
وأنبت الريحان على الكتفين
ثم منعت:
فيا وقد الجفوة فى القلب، ويا حرق العينين.
وعلى الرغم من استكمال الشاعر للمقطع الشعرى فى إطار الحديث الصوفى عن العشق الموصول بين العبد وربه، فإنه يشتكى فيه من انقطاع المدد الربانى عنه مؤخرًا، قبل أن يأتى المقطع الثالث ممثلًا للصوت القرآنى العظيم مرة أخرى، من خلال آيات سورة البقرة التى يقول فيها سبحانه وتعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم».
وإذا كان استكمال الآية فى القرآن الكريم هو: «فلما أنبأهم بأسمائهم»، فإن الشاعر الذى أدخلته يد الله فى التجربة، فعلم قيمة الكلمة وخطورتها، يشفق على نفسه من تحمل هذه المهمة الشاقة التى قبلها آدم عليه السلام عند بدء الخليقة وصفاء الكون، حيث يبدأ المقطع التالى قائلًا:
لا.. لا..
لا أجرؤ يا رباه،
وكيف أسمى كل الأسماء؟
هل تكرهنى، يا ربى، حتى تنفخ فى قصبة جسمى الناحل..
ما صنت زمانًا من أسماء
اصرف تكليفك عنى يا فياض الآلاء
وتخير كأسًا غيرى لكريم الأنداء
فأنا منذ زمان،
مذ هجرتنى شمس عيونك
وألفت الظل الرواغ
أتخفى أحيانًا تحت جدار التشبيه
أو فى جحر التورية، وشق الإيماء
إن الشاعر يعترف مرة أخرى بأنه لا يقدر على المواجهة، ولا يقدر على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، بل أقصى ما يستطيعه هو الاكتفاء بالتلميح والمواربة. ولهذا فهو يشرع فى توضيح سبب رفض هذا التكليف الذى أصبح صعبًا للغاية فى زماننا المعاصر، حيث يقول:
ماذا تبغينى.. يا رباه؟
هل تبغينى أن أدعو الشر باسمه؟
هل تبغينى أن أدعو القهر باسمه؟
هل تبغينى أن أدعو بالأسماء الظلم؟
وتمليق القوة، والطغيان،
وسوء النية، والفقر الروحى،
وكذب القلب، وخدع المنطق،
والتعذيب، وتبرير القسوة،
والإسفاف العقلى،
وزيف الكلمات، وتلفيق الأنباء..
لا.. لا..
لا أقدر يا رباه
لا أقدر يا رباه
لذلك كان من الطبيعى فى التسلسل الدرامى لحوار القصيدة، أن يكون الصوت العظيم التالى لرفض تنفيذ الشاعر للتكليف الإلهى هو قوله تعالى: «اخرج منها فإنك رجيم».
ليعود الشاعر فى المقطع الأخير من النص محاولًا الاستعانة بحبيبته لحمايته من محنة هذا التكليف الذى يعجز على حمله، حيث يقول:
دثرينى.. دثرينى!
زمّلينى.. زمّلينى!
حتى يصل إلى قوله فى نهاية المقطع والقصيدة:
لا تضيعينى، وقد ضاع يقينى
حيث تصور هذه القصيدة صراع الشاعر الداخلى مع ضميره حول قضيته الوجودية التى تلح عليه دائمًا: هل يمكنه أن يكتفى فى صراعه من أجل الحرية والعدل باستخدام الكلمات الرمزية التنويرية فقط فى مشروعه الإبداعى، أم أن عليه مواجهة السلطة المستبدة وتسمية الأشياء بأسمائها؟
كان الخيار الأول هو يقين صلاح عبدالصبور طوال حياته، وخيار قرينه الإبداعى حلاج مسرحيته، التى كرر مؤلفها مأساة بطلها فى حياته ومماته أيضًا.
فالمشهد الأول من المسرحية يظهر فيه الحلاج مصلوبًا، قبل أن يتوالى ظهور جماعة الفقراء، ثم جماعة شباب الصوفية، ثم صديقه الشبلى، وكل منهم يعتذر لجثته، مؤكدًا أنه قد قتل الحلاج بالكلمات على الرغم من حبه له!
حيث تقول مجموعة شباب الصوفية فى حوارها مع الواعظ والفلاح والتاجر، على سبيل المثال:
مجموعة الصوفية: نحن القتلة
أحببناه، فقتلناه
الواعظ: لا نلقى فى هذا اليوم سوى القتلة
ولعلكم أيضًا حين قتلتم هذا الشيخ المصلوب..
المجموعة: قتلناه بالكلمات
الفلاح: زاد الأمر غرابة!
المجموعة: أحببنا كلماته، أكثر مما أحببناه
فتركناه يموت لكى تبقى كلماته
التاجر: من أنتم؟
المجموعة: أصحاب طريق مثله
أما الحلاج نفسه فقد اكتفى فى صراعه مع السلطة التى سجنته وقتلته باستخدام الكلمات فقط أيضًا، رافضًا فكرة المقاومة الثورية ورافعًا شعار: «من لى بالسيف المبصر؟».
وكما تسبب خطأ الحلاج التراجيدى المتمثل فى خلطه بين الخطاب الصوفى والخطاب السياسى، فى مأساة قتله؛ تسبب خطأ «صلاح» التراجيدى المتمثل فى حيرته بين الاكتفاء باستخدام الخطاب التنويرى المهادن وضرورة الانتقال للخطاب الثورى المواجه، فى مأساة وفاته أيضًا.
لأن هذه الحيرة لم تفارق ضميره قط، وكانت تلح عليه فى كل لحظة كقنبلة موقوتة، عبث بها الأصدقاء ذات مساء، فانفجرت فى قلبه.