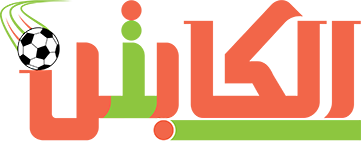محمود خليل يكتب:حارة نجيب محفوظ.. ومجتمع «سلطة يوليو 1952»

بادر أغلب مثقفى العصر الملكى- كما حكيت لك- إلى إعلان الولاء لمجلس قيادة الثورة، لكن الضباط الأحرار، خصوصًا عبدالناصر، كانوا فطنين إلى الطابع الانتهازى الذى يحكم علاقة المثقفين بالسلطة، لذا اختار «ناصر» من أفراد النخبة الموروثة من يمكن أن يفيد فى خدمة أهداف الثورة، وهمّش غير المفيد.
وكان من بين المثقفين القدامى من آثر تهميش نفسه بنفسه، وفضّل الابتعاد عن المشهد الذى يبادله توجسًا بتوجس. من أبرز النماذج على هذا القطاع من النخبة الروائى الكبير نجيب محفوظ، الذى قدم نموذجًا مختلفًا عن «المثقف المندمج» الذى عبّر عنه عميد الأدب العربية الدكتور طه حسين، وهو نموذج «المثقف المنسحب».
قدم نجيب محفوظ روايته «السكرية» عام ١٩٥٧، ودخل بعدها فى «نوبة صمت» تواصلت خمس سنوات كاملة. ثم صدرت له رواية «اللص والكلاب». وتقدم محاكاة لحادثة شهيرة شغلت المجتمع المصرى حينذاك «حادثة السفاح محمود أمين سليمان»، وأخطر ما فى الرواية تلك الفلسفة التى تعلمها سعيد مهران- بطل العمل- من أستاذه الصحفى رءوف علوان، وتلخصها عبارة: «ما أُخذ بالسرقة لا يُسترد إلا بالسرقة». فالأغنياء جمعوا المال بالسرقة، ولا بد من استرداده بالسرقة من جديد وتأميمه لحساب الفقراء! هل كان نجيب محفوظ يرمى بذلك إلى وصف المشهد فى مصر بصورة رمزية؟
صدرت لنجيب محفوظ بعد ذلك رواية «السمان والخريف» التى تحكى قصة أحد موظفى العهد الملكى البائد، أُثرى من وظيفته واستفاد من ارتباطاته الحزبية، لكنه فى الوقت نفسه كان وطنيًا ويؤمن بتحرير البلاد من المستعمر الإنجليزى، بعد قيام الثورة يتعرض للمحاكمة ويُحال إلى التقاعد، ليسير فى طريق الحيرة ولا يعرف ماذا يفعل، هذه الحالة كانت تعبر عن جانب من حياة نجيب محفوظ، والحيرة التى سقط فيها وهو يبحث عن طريق بعد قيام الثورة.
بعدها أصدر رائعته «أولاد حارتنا». وأول ما يلفت نظر قارئ هذه الرواية هو لجوء نجيب محفوظ إلى الرمز، خلافًا لرواياته التى سبقت ثورة يوليو، التى غلب عليها رسم صورة دقيقة للمجتمع المصرى وتحولاته، وأنماط استجابته للأحداث المختلفة التى يشهدها. ثلاثية نجيب محفوظ أبرز مثال على هذا التوجه فى الكتابة. فقد عالجت حركة المجتمع المصرى- قبل وبعد ثورة ١٩١٩، وتفاعل أسرة مصرية عتيدة مع التحولات الاجتماعية والسياسية التى طرأت على المصريين بعد الثورة، وتواصل خط الحكى حتى وصل إلى مرحلة صعود جماعات الرفض الاجتماعى والسياسى- كما يصفها الدكتور على الدين هلال- التى تبنت اتجاهًا راديكاليًا جديدًا داخل المشهد السياسى المصرى. وأبرز جماعاتها: الإخوان ومصر الفتاة وحدتو.
آثر نجيب محفوظ الابتعاد عن «المباشرة» التى تعوّد عليها وهو يرصد حركة المجتمع بعد ثورة يوليو، وعندما عاد لجأ إلى الرمز، واستدعى صراع البشر من أجل الحياة العادلة، منذ آدم، عليه السلام، حتى عصر العلم والمعرفة، وكان العدل الذى تبحث عنه الشخصيات الإصلاحية داخل «أولاد حارتنا» متناغمًا مع الرؤية الاجتماعية لنجيب محفوظ للحارة «المجتمع» التى سادها الظلم وسحق الضعفاء.
تستطيع أن تجد صورة رمزية أخرى لواقع الحياة فى مصر فى رواية «ثرثرة فوق النيل» (١٩٦٦). وهى تعرض مجموعة من الشخصيات التى قررت الهروب من الواقع عبر الدخول فى «غيبوبة الحشيش». ولو أنك فتشت فى سطور الرواية عن الأسباب التى دفعت أبطالها إلى الهروب من الواقع فستجد أنها تتحلق حول فكرة «الإحساس بالفشل» المغروس فى نفوس الجميع، رغم ما يتمتعون به من نجاح ظاهرى فى الواقع.
فهناك الناقد الحائر بين جذوره المحافظة فى الريف والحياة التى يعيشها فى القاهرة، والموظف الذى يلعن الوظيفة التى يعبد أصحابها «إله الأقدمية» ويأمل كل موظف منهم فى أن يزيح من يسبقه عن طريقه حتى يتمكن من الولوج إلى جنة «الترقية» أو الحصول على «حافز». والفنان الشهير الذى تنغص وظيفة أبيه «الحلاق» ما وصل إليه من مجد عبر ما يقدمه من أعمال تافهة، والصحفية التى تبحث عن فكرة لمسرحية جديدة قررت كتابتها.
ظلت شخوص الرواية على إدمانها الهروب من الواقع حتى واجهت لحظة حقيقة، حين دهست سيارتهم إحدى الفلاحات فى الطريق إلى «سقارة». حاول بعضهم- كما تعود-الهروب من الجريمة التى شاركوا فى ارتكابها، لكن الحدث هذه المرة كان مزلزلًا، ولم يكن من السهولة بمكان القفز عليه بالتحليق مع دخان الحشيش المتصاعد. الهروب أصبح جريمة أكبر وأخطر من جريمة القتل، وحانت لحظة المواجهة. الحكى داخل الرواية كان يؤشر- بصورة رمزية- إلى النكسة التى واجهتها مصر عام ١٩٦٧.
عاد نجيب محفوظ إلى التعبير المباشر عن أوجاع المجتمع المصرى وحركته أوائل السبعينيات، يمكنك أن تستدل على ذلك من رواية «الحب تحت المطر» التى صدرت عام ١٩٧٣، وعالجت نكسة ١٩٦٧ وما فعلته بالمجتمع المصرى بصورة مباشرة، وكيف أن الجميع سقط فى اللحظة التى تمكن فيها العدو من النيل من البلاد واحتلال أرضها.
واتجه الأديب الكبير ثانية إلى روايات الأجيال أوائل الثمانينيات. ومن أبرز ما أنتج فى هذا السياق رواية «يوم قتل الزعيم» (١٩٨٥)، ومن قبلها رواية «الباقى من الزمن ساعة» الصادرة عام ١٩٨٢. والرواية الأخيرة تحكى بشكل مكثف وعميق «حدوتة مصر» من خلال أسرة تتكون من أب وأم وثلاثة أبناء، تتدفق بهم الحياة عبر عدة أجيال، بدءًا من عام ١٩٣٦ حتى نهاية عصر الرئيس السادات.
الأب «حامد برهان» وفدى حتى النخاع، شارك فى ثورة ١٩١٩ ويفخر بأنه لعب دورًا فى تحريض زملائه الموظفين على المشاركة فى الثورة. والابن محمد حامد برهان الذى نشأ وفديًا مثل أبيه، لكنه انخرط فى جماعة الإخوان بعد حين، وأصبح عضوًا فيها، لم يرض أبوه الوفدى عن توجهه الجديد، لأنه كان جامدًا عند ساعة «ثورة ١٩١٩»، ينظر حوله فلا يبصر غيرها، يتحسس موضع قلبه فلا يسمع إلا دقاتها. انطلق محمد مع الإخوان يهتف بالحل الإسلامى، فى حين كان العمر يزحف بأختيه، كوثر ومنيرة، فتزوجت الكبرى من أحد أثرياء العهد الملكى، وتزوجت الصغرى الجميلة بشاب حصل على مؤهل متوسط، ويعمل أخوه ضابطًا بالجيش.
طورد محمد حامد برهان مع غيره من كوادر الإخوان وتم القبض عليه، فمكث فى السجن بضع سنين، ثم أُفرج عنه. تحوّل محمد بعد خروجه من السجن إلى كتلة من الحقد على الواقع، لا يعرف فى قاموس اللغة إلا كلمات اللعنة، يمكث دائمًا فى انتظار ساعة سقوط لخصمه، يشعر فيها بالتشفى فيه. باغته أمل كبير عندما وقع العدوان الثلاثى على مصر، وحلم بساعة خلاص، لكن الزعيم خرج من المعركة منتصرًا وأقوى مما كان. عندما وقعت حرب اليمن تحدث إلى سليمان بهجت، شقيق الضابط، ضاحكًا: هل سمعت أغنية أم كلثوم الجديدة «هسيبك لليمن»؟! يغمز بقوله إلى خسائر المصريين فى حرب اليمن.
جاءت لحظته عندما وقع الزلزال الكبير فى يونيو ١٩٦٧، أخذ حظه كاملًا من الشماتة والتشفى، وقال إن تلك هى نهاية أى نظام يقوم على «الكفر والفساد». وصف نجيب محفوظ حالة الذهول العام التى عاشها المصريون بعد النكسة، وكأنهم «مخبوطين على رءوسهم» ودخولهم فى حالة هلوسة تاريخية، تختلط فيها الضحكة بالبكاء، والنكتة بجلد الذات، حالة من انعدام الوزن ضربت الجميع، وسحابات من اليأس والإحباط ظللت رءوسهم.
وفى خضم الأحاسيس التى ولدتها الهزيمة ووصفها بدقة «نجيب محفوظ» فى «الباقى من الزمن ساعة»، قدم تلخيصًا مثيرًا للحالة التى أصبحت تعكس إحساس الجيل الجديد- من أحفاد حامد برهان- بالبلاد بعد النكسة، احتضنته عبارة «لقد تحول البلد إلى مرحاض عمومى كبير».