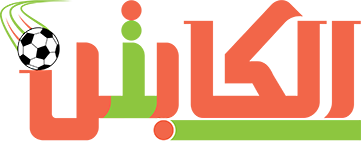محمود خليل يكتب: الصراع على حجاب النساء وتجديد الخطاب الدينى

تعد النظرة إلى المرأة معيارًا جيدًا ومساحة شديدة الخصوبة للتمييز بين مدرسة «التدين التقليدى»، ومدرسة «التدين التنويرى».. فرواد التنوير الفكرى وجدوا فى تعديل الأوضاع الاجتماعية للمرأة بوابة جيدة لتغيير أنماط التفكير الدينى التقليدى داخل المجتمع المصرى. والطريقة الأولى لرواد هذه المدرسة جاءت على يد الشيخ محمد عبده، ثم تواصلت على يد تلامذته.. وقد شرحت لك مقدار اهتمام الإمام بقضية المرأة وسعيه إلى تصحيح أوضاعها داخل الأسرة، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة النظرة إلى الزوجة وإشكالية تعدد الزوجات، لكنه خطا بعد ذلك خطوة أوسع حين تناول قضية الحجاب.. وقد كانت مسألة الحجاب من المسائل التى أثارت حفيظة أصحاب نظرية «التدين التقليدى»، فاعتبروا أن المرأة هى البوابة التى يحاول أن ينفذ منها الاستعمار لضرب الدين، خالطين ما بين مسألتى «التدين» و«الدين»، فقاوموا التحوّل الذى أراد الإمام إحداثه معتمدين على سلاح «الموروث الفقهى»، وخاض الإمام المعركة معهم متسلحًا بسلاح «العقلانية».
تبنى الإمام محمد عبده نظرية تذهب إلى أن إعادة النظر فى الموروث الفقهى تمثل البوابة الكبرى للإصلاح الاجتماعى، لذلك لم يهتم فقط بإعادة قراءة هذا الموروث فيما يتعلق بمسألة الزواج ومفهومه وتعدد الزوجات وجدواها فى الواقع المعاصر، بل تسحب عقله إلى مسألة أخرى شديدة الحساسية تتعلق بـ«حجاب المرأة المسلمة»، فأشار فى مقال له بعنوان: «حجاب النساء من الجهة الدينية» إلى أن الحجاب عادة أكثر منه عبادة أو جزء من الأمور الشرعية التى تنظم حركة المرأة فى المجتمع، ويقول فى ذلك: «لو أن فى الشريعة الإسلامية نصوصًا تقضى بالحجاب، على ما هو معروف الآن عند المسلمين، لوجب علىّ اجتناب البحث فيه، ولما كتبت حرفًا يخالف تلك النصوص مهما كانت مضرة فى ظاهر الأمر، لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها بدون مناقشة، لكننا لا نجد نصًا فى الشريعة يوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة، وإنما هى عادة عرضت عليهم من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التى تمكنت فى الناس باسم الدين والدين منها براء».
واستدل الإمام من آية غض البصر: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» على أن المرأة لم تكن محجبة وأن أعضاء من جسدها كانت تظهر على حسب العادة حينذاك، وهى الوجه والكفان والقدمان، ويتأكد هذا المعنى بمراجعة الآية الكريمة: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، فمن حق المرأة أن تتحرك بين الناس وتكشف ما سمح لها الشرع بكشفه، كما أكد الإمام أن مسألة التبرقع أو التنقب ليست من الإسلام فى شىء بناء على الآيات القرآنية الكريمة.
الكثير من الأفكار التى طرحها الإمام محمد عبده فى كتاباته الاجتماعية تشهد على أنه لم يقف من التراث الفقهى موقف المسلّم به، بل موقف الناقد والمفند له، فقبل منه ما يتسق مع الفهم الصافى لآيات القرآن الكريم وما يتناغم مع روح العصر وتطوراته.. ورغم احتفائه بالسلف الصالح من أعلام الصحابة فإن ذلك لم يعنِ بالنسبة له الانقياد غير المبصر لكل ما هو موروث أو لفهم السالفين النص القرآنى، لأنه كان يؤمن بالعصرنة بنفس درجة إيمانه بأفضلية الجيل الأول من المسلمين على ما لحق به من أجيال.. ويرى أن كل جيل من المسلمين يتمتع بحقه الكامل فى الاجتهاد والإضافة.
نظرة الشيخ الإمام إلى السلف كانت نظرة استلهام أكثر منها نظرة تبعية، كما كانت الحال بالنسبة للشيخ محمد بن عبدالوهاب.
والفارق بين التبعية والاستلهام هو ببساطة الفارق بين مُجدد يفهم مسألة تجديد الخطاب الدينى كمحاولة للعودة بالناس إلى الخلف، وتجميد التاريخ عند لحظة معينة، يحاول بكل جهده استعادتها فى واقع مغاير وظروف وأزمنة وسياقات مختلفة كل الاختلاف، منطلقًا من رؤية سلفية تجمد العقل كما تجمد التاريخ، وبين مُجدد آخر يفهم أن تجديد الخطاب يعنى استلهام الماضى وقراءته- بصورة عقلانية- فى ضوء مستجدات ومتطلبات العصر، منطلقًا من رؤية واقعية.
ألقى الشيخ محمد عبده حجرًا فى ماء العقل المصرى الراكد، فحرّكه واعتبر إعمال العقل وتشغيله الأداة الوحيدة للإصلاحين الدينى والاجتماعى، وأن حكمة الله اقتضت أن يكون العقل هو العنصر الأهم فى حياة الإنسان، ويقول فى ذلك: «وكل الله بالعقل منبهًا لا يغفل، وحسيبًا لا يهمل، وكالئًا لا ينام، يزعج الواقف، ويحث المتريث، ويمسك الواجف»..
والفارق بين التبعية والاستلهام هو ببساطة الفارق بين مُجدد يفهم مسألة تجديد الخطاب الدينى كمحاولة للعودة بالناس إلى الخلف، وتجميد التاريخ عند لحظة معينة، يحاول بكل جهده استعادتها فى واقع مغاير وظروف وأزمنة وسياقات مختلفة كل الاختلاف، منطلقًا من رؤية سلفية تجمد العقل كما تجمد التاريخ، وبين مُجدد آخر يفهم أن تجديد الخطاب يعنى استلهام الماضى وقراءته- بصورة عقلانية- فى ضوء مستجدات ومتطلبات العصر، منطلقًا من رؤية واقعية.
ألقى الشيخ محمد عبده حجرًا فى ماء العقل المصرى الراكد، فحرّكه واعتبر إعمال العقل وتشغيله الأداة الوحيدة للإصلاحين الدينى والاجتماعى، وأن حكمة الله اقتضت أن يكون العقل هو العنصر الأهم فى حياة الإنسان، ويقول فى ذلك: «وكل الله بالعقل منبهًا لا يغفل، وحسيبًا لا يهمل، وكالئًا لا ينام، يزعج الواقف، ويحث المتريث، ويمسك الواجف»..
والعقل فى نظر الشيخ أداة للنقد، وقد جعل الحق فى النقد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان المسلم، واعتبره أداة كبرى لتحسين الحياة ودفعها إلى الأمام، وقال فى ذلك: «لولا الانتقاد ما شب علم عن نشأته، ولا امتد ملك عن منبته، أترى لو أغفل العلماء نقد الآراء، وأهملوا البحث فى وجوه المزاعم، أكانت تتسع دائرة العلم؟ وتتجلى الحقائق للفهم؟ ويعلم مَنْ المحق ومَنْ المبطل؟». هكذا آمن الإمام محمد عبده بالعقل والحق فى النقد، وقدّم تجربة عملية شجاعة فى النقد الاجتماعى الهادف إلى الارتقاء بسلوك الفرد والجماعة بشكل يؤدى إلى تطوير الأمة.
الحجج العقلانية التى اعتمدت عليها أطروحات الشيخ محمد عبده فى التجديد كانت من القوة بمكان، بحيث رجت تفكير معارضيه من أنصار «التدين التقليدى»، لكن شخصيته القوية وإيمانه بضرورة الإصلاح جعلته يواجه الجميع بصلابة وقوة.. ولما لم يجد خصومه من سبيل لدحض آرائه المتناغمة مع الواقع وتطور عجلة الحياة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بادروا إلى الغمز واللمز فى حقه بشتى الطرق، فغمزوا فى علاقته باللورد كرومر، المعتمد البريطانى فى مصر، وكان الأخير مشهورًا بعدائه للإسلام، وأخذوا يثرثرون فى أن المستعمر يريد تفريغ الشعب المصرى من ثقافته الإسلامية، وأن الشيخ يلعب دورًا فى ذلك، واستدلوا على الفرية بالحديث عن «الحجاب» وموقف محمد عبده منه، وأن سيطرة الاستعمار على الشعوب تبدأ من بوابة المرأة، وغمزوا ولمزوا فى علاقة الإمام بالأميرة نازلى فاضل، وأنه من رواد صالونها الثقافى الذى تظهر فيها سافرة بلا حجاب، وتمارس فيه العادات الأوروبية، وغير ذلك من مطاعن حاولوا من خلالها تشويه صورة محمد عبده- مفتى البلاد والعباد- أمام الجمهور المصرى، لكن قناعة الشيخ بقضيته فى «إصلاح الفكر الدينى» كانت أقوى من أن تهزها هذه العوارض.. فقد آمن الرجل بأن مستقبل الإسلام كعقيدة والمسلمين كمؤمنين بها رهين بالتخلى عن التدين الشكلانى والاحتفالى، والاعتماد على العقل كأساس لفهم الدين وقراءة الموروث الفقهى، وعلى التجديد كطريق يمكن أن يأخذ بيد الأمة نحو المستقبل.. وظل على قناعته تلك حتى لقى وجه ربه عام ١٩٠٥ عن ٥٦ عامًا.