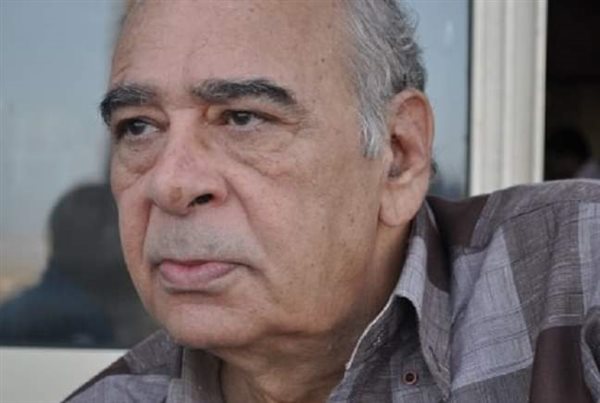الدور المعرفى للأدب
يوثق التأريخ الأحداث الكبرى والمعارك، لكنه لا يقدّم إليك تفاصيل الحياة الاجتماعية التى يقدمها الأدب. عام ١٩٢٢ فتحت حركة التأريخ دفاترها تسجل تصريح بريطانيا بإلغاء الحماية على مصر، لكنك لن تجد مؤرخًا يرصد أن المرأة المصرية كانت فى ذلك العام نفسه ١٩٢٢ ترتدى المايوه بحرية وتغيّر ملابسها فى كبائن أُقيمت خصيصًا على شاطئ الإسكندرية من غير أن يكدر ذلك صفو أحد.
هذه الصورة أو المعلومة ستجدها فى رواية عيسى عبيد «ثريا» التى نُشرت فى ذلك العام لتؤكد أن للأدب جانبًا معرفيًا، نقرأه فنرى فى التفاصيل الاجتماعية الصغيرة تاريخنا من زاوية أخرى، ونعلم أنه منذ مائة عام لم يكن المايوه يغضب أحدًا! حتى إن عيسى عبيد يمر فى قصته على تلك الصورة مرور الكرام كأنها من بديهيات الحياة.
وتتضح أهمية ذلك الدور المعرفى للأدب، كلما باعد الزمن بيننا وبين الأحداث والأزمنة. سيتضح لنا على سبيل المثال أن مهنة الأدب حتى العشرينيات كانت مخجلة حتى إن محمد حسين هيكل استنكف عام ١٩١٤ أن يضع اسمه مؤلفًا على روايته «زينب» فنشرها باسم «فلاح مصرى»! وقد أشار نجيب محفوظ إلى ذلك فى حديثه له قائلًا: «كان الجانب المحترم فى الحياة الأدبية المقال، أما القصة فغير محترمة، ولهذا كنت لا أفكر فى التفرغ للأدب»!
ويسجل توفيق الحكيم ملاحظة مشابهة فى سيرته «سجن العمر» حين يقول إنه وضع اسمه «حسين توفيق» من غير اسم العائلة على أولى مسرحياته لكى لا يعرف أهله أنه يمتهن الكتابة! ولا أظنك ستجد فى كل كتب التاريخ ملاحظة وثيقة الصلة بطبيعة الوعى الاجتماعى كتلك التى سجلها الحكيم فى سيرته حين قال إنه فى عام ١٩٢٥: «قابلنى بعض المعارف من غير أهل الفن ونظر فى وجهى ثم صاح: أين شاربك؟، فرد عليه أحد العارفين بهوايتى المسرح: عامل فنان يا سيدى! ذلك أن إطلاق الشوارب وفتلها وتبريمها كان هو الطبيعى المألوف، أما ذلك الذى يزيل شاربه فهو الخارج على إجماع الناس، المنخرط فى زمرة أهل الفن والعياذ بالله!». لكن لدى توفيق الحكيم صورة أخرى لوضع المرأة تخالف ما قدمه عيسى عبيد، إذ يشير الحكيم إلى أنهم عندما كانوا يقومون بتعريب مسرحية أجنبية، كان عليهم أن يخترعوا صلة قرابة ليست موجودة فى النص الأصلى بين كل أبطال المسرحية الرجال وكل بطلاتها السيدات! لأنه لا يجوز عند المتفرج المصرى أن يرى امرأة تتعامل مع غير أقربائها! ويواصل الحكيم: «كان من المستحيل أن نجعل زوجة فلان تنكشف على زوج علانة، فكنا نتحايل بشتى الطرق، فنجعل هذه المرأة ابنة عم ذلك الرجل، أو أنه ابن خالتها.. وهكذا كان الرجال والنساء فى جميع مسرحيات ذلك العصر تجمعهم صلة القرابة».
وفى كتابه «حياتى» يسجل عبدالحميد جودة السحار لقطة من الفرحة بأول فيلم مصرى ناطق، شاهده المصريون بعد الأفلام الأجنبية، فيقول: «أعلنوا عن قرب عرض فيلم (ليلى) فى سينما متروبول خلف محل شيكوريل وتجمع الناس أمام دار العرض ودخلنا فرحين مستبشرين وبدأ العرض وكانت كل لقطة تهزنا، وأخذنا جميعًا نصيح مأخوذين كلما ظهر شىء فيه الطابع المصرى: الله.. قلة! طبلية! ملوخية! طربوش»! بمثل تلك التفاصيل الدقيقة قام الأدب ويقوم بدوره المعرفى المميز حين يمدنا بتفاصيل صغيرة نقرأ بها ما لا يسجله التاريخ الذى لا يسيل قلمه إلا مع قصف المدافع والحروب وعزل الملوك والمؤامرات الدولية. وكلما باعد الزمن بيننا وبين الحياة المنصرمة زادت أهمية وقيمة ذلك الجانب المعرفى فى الأدب.