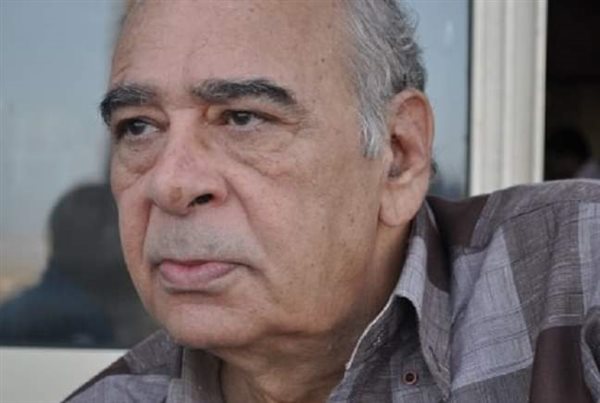عنف الديكتاتورية
يمثل ستيفان زفايج صفحة عبقرية فى تاريخ الأدب العالمى، سواء من حيث قدراته الفنية التى لا يخبو بريقها أو من حيث حياته التى انتهت نهاية مأساوية، فقد قرر عام ١٩٤٢، وكان قد تجاوز الستين، أن ينهى حياته وشاركته قراره زوجته الشابة التى تجاوزت الثلاثين بقليل، فابتلعا قدرًا كبيرًا من الحبوب المنومة، وأعطى كلبه الذى رافقه سنوات طويلة كمية من تلك الحبوب.
كان زفايج يخشى انتصار النازية الألمانية على أوروبا وما سيعقب ذلك من تدمير كل القيم الإنسانية، إلا أنه كان قد نشر كتابًا بعنوان «ضمير ضد العنف»، تُرجم إلى العربية باسم «عنف الديكتاتورية»، عالج فيه تصدى ضمير الإنسان الأعزل للديكتاتورية المسلحة.
يقول زفايج فى كتابه: «لا بد للحرية من سلطة وإلا أمست فوضى، ولا بد للسلطة من حرية وإلا أصبحت طغيانًا».. وحسب ما نشرته «أسوشيتد برس» فإن عدد المعتقلين فى مظاهرات الاحتجاج الأمريكية على مقتل «جورج فلويد» وصل إلى أكثر من عشرة آلاف، ما يعنى أن السلطة تميل إلى الطغيان، ويستدعى ذلك مراجعة المفهوم الأمريكى للحرية السياسية، الذى يرتكز على أوهام الديمقراطية الشكلية التى روّجت لها أمريكا باعتبار أنها تقوم على وجود برلمان وعدة صحف معارضة، وتنشط بعض الأحزاب مع دستور مكتوب ببلاغة، وخلال ذلك فإن أجهزة الدولة من شرطة وغيرها تقوم بدور محايد للتحكيم فى أى صراع وفضّه.
وفى أمريكا يوجد كل ذلك، دستور وصحف وأحزاب وقنوات، وكل شىء آخر حلاوة وديمقراطية، وما من حرف وما من قانون فى بلد الحريات يسمح بسحل المتظاهرين فى الشوارع ثم الزج بعشرة آلاف منهم إلى السجون.. إلا أن ذلك السلوك يعرى الأوهام الديمقراطية، ويبين أن الدساتير وقاعات البرلمانات تحتوى عادة على أروع الحقوق على ورق، أما فى الواقع فإن الأمر يختلف تمامًا.
على سبيل المثال، فإنه من حق كل مواطن أمريكى دستوريًا أن يترشح للرئاسة، لكن فعليًا لا يتمتع بذلك الحق إلا من كانت جيوبه محشوة بالملايين لتغطية الدعاية الانتخابية أو تقف خلفه شركات كبرى.. دستوريًا من حق كل مواطن إصدار صحيفة، فعليًا يتمتع بهذا الحق فقط من معه المال الكافى.. دستوريًا ونظريًا المواد كلها تساوى بين المواطنين، لكن فعليًا وعند تفسير أى مادة فإن أقسام الشرطة والمحاكم سوف تنحاز إلى الأقوى.
وحتى لو افترضنا أن ذلك النوع من الديمقراطية لا ينقصه شىء، فسوف يبقى أن تلك الديمقراطية ليست سوى ديمقراطية سياسية، وما نفعها إذا كانت تخفى تفاوتًا اقتصاديًا ضخمًا؟ وبِمَ تفيد الفقير مساواته بالأغنياء فى الدستور؟.. تظل المشكلة فى السلطة السياسية والطبقة التى تعبّر عنها، فإن كانت السلطة فى أيدى طبقة تتناقض مصالحها مع مصالح الأغلبية فإن الأشكال الدستورية والحقوقية التى تدعى تمثيل الأغلبية تصبح مجرد هياكل ورقية، وما إن تحين ساعة الجد حتى تلقى الدولة بكل الهراء الديمقراطى خلف ظهرها وتدفع إلى الشوارع بقوات الشرطة لسحل المتظاهرين فى مختلف المدن الأمريكية، فيرى الجميع أن الشرطة ليست كما يدعون جهازًا محايدًا لفض النزاعات..وقد شهدنا على امتداد سنين طويلة فى مختلف دول العالم، بما فى ذلك فرنسا وروسيا وغيرهما، الدور القمعى الذى يتزيّن بالديمقراطية، وتابعنا عشرات الاحتجاجات الشعبية التى تتدخل فيها رجال الشرطة والجيش أحيانًا لتحطيم الإضرابات أو كسر المظاهرات، لكن أحدًا منا لا يعرف حالة واحدة تدخلت فيها الشرطة لمحاسبة أصحاب المصانع حين يُسرّحون العمال أو لا يدفعون لهم أجورهم.
إن ما يجرى فى أمريكا أمر سوف يحسمه المواطنون هناك، لكن ما يهمنا هنا هو مراجعة مفهوم الحرية الأمريكى، والخواء الكامن وراء المساواة السياسية.. إن ما كتبه ستيفان زفايج منذ نحو مائة عام عن عنف الديكتاتورية ما زال صالحًا للقراءة إلى يومنا هذا.. فى كتابه يحدد ستيفان زفايج قطبى الصراع حول قضية الديكتاتورية، قائلًا: «التسامح ضد اللا تسامح، الحرية ضد الوصاية، الإنسانية ضد التعصب، وكل هذه التسميات تعبّر عن قرار شخصى، أيهما الأهم بالنسبة لكل فرد: الإنسانى أم السياسى؟ الفردى أم الجماعى؟».