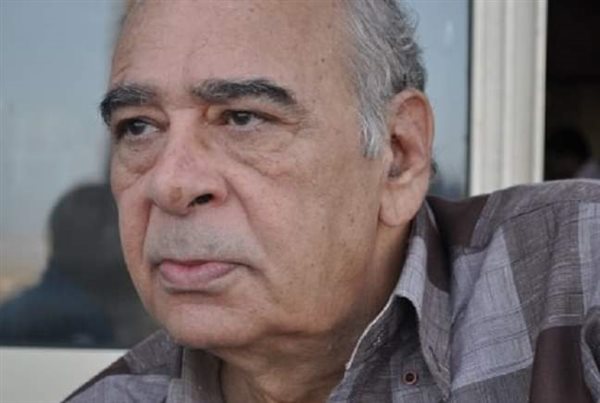من أوراق الغربة
سافرت إلى روسيا فى أغسطس 1972. كانت أول مرة أسافر فيها إلى خارج الوطن. ركبت الباخرة من الإسكندرية إلى لبنان. عبأت حقيبتين بملابسى وكتبى ودفاتر بأفكار قصصية وإبرة وفتلة ونعناع وكيس ملوخية ناشفة وأزرار وأقلام وصور أخواتى وأرقام هواتف أصدقائى وكل ما «يجرجره مصرى» إذا خطا شبرًا واحدًا بعيدًا عن موطنه.
حقيبتان منتفختان حشرت فيهما مصر. استندت بمرفقى إلى سور الباخرة أودع الإسكندرية وأهلى. بدأت الباخرة تنسحب مبتعدة تدريجيًا وغروب الشمس الأحمر المشوب باللون البنفسجى يلقى لهبه على أمى وأخواتى الواقفات على رصيف الميناء. وصلت الباخرة بيروت ومن هناك ركبت الطائرة إلى موسكو. إلا أن سفرى إلى روسيا بدأ قبل ذلك بزمن طويل عن طريق الأدب، منذ أن كنت فى العاشرة وأخذت أمد يدى إلى مكتبة والدى وأسحب من على رفوفها كل ما كتب فوقه رواية أو قصة. حينذاك قرأت «ملكة البوستونى» لبوشكين، و«طفولتى» لمكسيم جوركى وغيرها. وانطبعت روسيا فى خيالى مثل ياقوتة متوهجة بألوان الوجع والانتفاض والندم والعنف.
كانت معظم الشخصيات الأدبية الروسية كثيرًا ما تنتحر أو تندفع إلى الرصاص لتغيير الواقع باغتيال القياصرة، أو تغرق يأسها فى الخمر وقرب شموع الكنائس، أو تسمو متطهرة فوق كل شىء، لكنها فى كل الأحوال كانت شخصيات «أيديولوجية» ذات مشروع للصدام مع العالم، ضده ومن أجله. مع هبوطى إلى مطار موسكو حل علىَّ أول شعور بالغربة. سرت حاملًا حقائبى، عاجزًا عن فهم أى شىء مما يقال لى وحولى بالروسية. تذكرت أننى لست أول طالب مصرى يصل هنا للدراسة، ففى عام 1845 أرسل محمد على باشا طالبين مصريَّين اثنين إلى روسيا هما: إيليا داشورى، وعلى محمد، لدراسة استخلاص الذهب فأثار الاثنان بملامحهما الإفريقية دهشة الروس سكان الأورال، وفى مطلع 1847 عاد الاثنان وقد أصبحا مهندسى تعدين ودون إبطاء أرسلهما محمد على إلى النوبة وشرق السودان لاستخلاص الذهب من الرمال هناك، أقمت السنة الأولى فى بيت الطلاب بمدرسة تحضيرية لدراسة اللغة. بيت قديم من خمسة طوابق، الأول والثانى منها لقاعات الدراسة، الثلاثة الأخرى حجرات نوم ومعيشة الطلاب. لم أكن أعرف كلمة روسية واحدة، لهذا لم أجرؤ على القيام بخطوة خارج البيت.
عكفت على كتب اللغة الروسية إلى أن جاءنى ذات يوم شاب فلسطينى اسمه وليد كان يدرس معنا وقال لى: «يا رجل حرام عليك، أنت لك شهرين ما خرجت من البيت ولا شفت الشارع؟ أنا أخى يدرس هنا منذ عامين فى جامعة باتريس لومومبا وأنا أحفظ الطريق والمواصلات لزيارته. تعال معى نقوم بزيارته، ويبقى اسمك خرجت تتهوى شوية». لخوفى من الضياع اشترطت على وليد أن نأخذ عنوان المسكن من السيدة العجوز المناوبة الموجودة فى مدخل البيت، لكى نتمكن من الرجوع إن حدث شىء. سجلت لنا المرأة الطيبة العنوان ودسه وليد فى جيبه وانطلقنا. خرجت إلى شوارع موسكو للمرة الأولى، مذهولًا أتطلع بسعادة لوجوه الناس فى الشوارع. ركبنا تروماى، وهبطنا، وسرنا قليلًا حتى محطة تروللى باص. جاء التروللى وركب وليد وقبل أن ألحق بالركوب كان باب التروللى قد انغلق أمامى وأنا ما زلت واقفًا فى الشارع! هتفت مذعورًا «العنوان يا وليد»! لكن وليد غاب مع التروللى بعيدًا عن عينى. خطر لى أن أركب التروللى باص التالى بأمل أن وليد سينتظرنى فى المحطة القادمة. هكذا فعلت. ركبت ووقفت بجوار السائق أتطلع إلى وجه وليد ملتصقًا بالزجاج الخلفى للتروللى الذى أمامى وهو ينظر نحوى. قلت لنفسى المحطة القادمة نلتقى. لكن التروللى الأمامى انحرف يمينا وانعطف التروللى الذى أنا بداخله يسارا!!
ومضى كلّ منا فى اتجاه مختلف! هبطت عند أول محطة وظللت واقفًا. أمطرت علىَّ ساعتين، وأنا كلما اقترب أحد من المحطة أسأله «الأخ عربى؟». بمعجزة ظهر شاب لبنانى. شرحت له أننى تائه. قال: «بسيطة أوصلك. أين تسكن؟» قلت له: «العنوان مع وليد»! وكان طيبًا إلى درجة أنه اصطحبنى فى تاكسى وظل يدور به على كل بيوت الطلاب الأجانب لأنتقى من بينها بالشبه مسكنى! صعدت إلى حجرتى مبللًا مرهقًا. فتحت الباب ورأيت وليد جالسًا على طرف سريره، وجهه بين كفيه، مثل فأر مذنب ضبط بجريمة. قلت له: «مش قلت لك؟». نهض ودق كفًا بكف وقال بذهول: «لا.. بس هاى والله عجيبة. شو ها النحس؟! عمرها ما حصلت معى يا زلمى»! فى كل الأحوال كان ذلك خروجى الأول من بيت بخمسة طوابق فى روسيا إلى روسيا على اتساعها، فانفتحت أمامى حياة أخرى كاملة، تعرفت خلالها شيئًا فشيئًا إلى الإنسان الروسى، بتكوينه الإنسانى الفريد، لكن شيئًا لم يستطع أن يصد عنى الشعور بالغربة وبالاقتلاع، وبأن أحدًا قص جذورى من أرضى، ومنع عنِّى الماء والشمس.