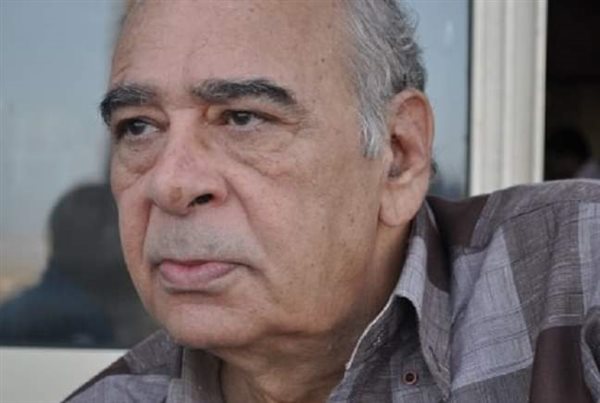الموسيقيون الذين علمونى الأدب
راح نصف سنوات حياتى المبكرة فى القراءة، وكنت أنتهى من روايتين فى اليوم. فى الصباح أذهب إلى المدرسة، وعندما أخرج منها لا أرجع إلى البيت، بل أتجه إلى سور فيلّا قديمة مهجورة صفت على حافته البارزة كتب مهترئة للبيع، يقف إلى جوارها «عم حجازى»، بذقنه الطويل وجلبابه والجاكتة، وأمامه حامل خشبى، وينهمك بريشة فى يده فى رسم صور نجوم الغناء والشاشة، ويعد نفسه فنانًا مظلومًا لم يلق التقدير. وقد شغفت بالكتابة الأدبية فى تلك السنوات، بعد أن طالعت «ذات الرداء الأبيض» لويلكى كولنز فى روايات الهلال، مع ذلك حين بدأت الشخبطة الأدبية كان عبدالحليم حافظ هو النموذج الذى أتطلع إلى تقليده فى الكتابة.
ليس يوسف إدريس ولا نجيب محفوظ بل عبدالحليم، فقد وجدت فى عبدالحليم جوهر الكتابة، الصوت الصافى، وهو المطرب الوحيد الذى إذا سمعته لا تسمع صوته من شدة صفائه، بل تسمع نفسك، كأن كل مهمته أن يفتح لك حدائق روحك الداخلية لتراها. وكان أملى وما زال أن أكتب بمثل هذا الصفاء بحيث لا يرانى القارئ، بل يرى نفسه. وأظن أن لدينا قلة من الأدباء من ذوى الأصوات الصافية منهم يحيى حقى، وبهاء طاهر، ومحمد المخزنجى. كان عبدالحليم أول الموسيقيين الذين وضعوا يدى على جوهر الأدب: صفاء المخاطبة.
الموسيقى الثانى الذى لقننى درسًا مهمًا يتصل بالأدب هو المطرب عبدالعزيز محمود الذى علمنى فى صغرى أن الموهبة الأدبية تحتاج إلى كفاح واستقتال لكى لا تنطفئ. كان ذلك فى عرس ابنة عمتى بأحد النوادى وعبدالعزيز محمود هو مطرب الحفل. غنى دون ميكروفون وغطى صوته القاعة الطويلة من أولها إلى آخرها. ولأننى لم أكن قد رأيت مطربًا من قبل، فقد وقفت بجوار التخت الموسيقى، أتأمل من الجنب المطرب والعازفين لوحة واحدة. غنى المطرب بحرارة أغنيته الشهيرة «بلدى وحبيبى وقريبى من جهة»، غناها بلوعة، وكان الطبال المخمور ينقر الطبلة من خلفه ويشاكسه مبتسمًا قائلًا: «يا راجل، أنت كبرت خلاص.. حبيبى إيه؟ هو لسه فيه حبيبى؟». ونظرت إلى المطرب أترقب رد فعله على الجملة التى قيلت. ظننت أنه لن يعير الطبال اهتمامًا، وسيواصل غناءه الملتاع الشجى. لكنى فوجئت به- من دون أن يخرج من اندماجه الفنى- يلعب أصابع يده خلف ظهره للطبال استهزاء بما قاله!. أدهشنى ذلك دهشة ظلت معى طول العمر، لأن الفنان جمع فى لحظة واحدة بين انخراطه العميق فى الفن وبين الدفاع عن فنه ومجابهة الحياة بكل مستلزماتها.
كان ذلك هو الدرس الثانى. على المبدع أن يكون فى الوقت نفسه فنانًا ومقاتلًا. وقد ترسخ هذا الدرس فى ذاكرتى، خاصة بعدما رأيت مواهب كبيرة تذوى، لأن أصحابها افتقدوا القدرة على القتال فى الحياة. الدرس الثالث فى الكتابة الأدبية علمنى إياه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذى كان يثب إلى ذهنى كلما واجهتنى قضية الشكل الفنى، فأسأل نفسى: أليس هذا الشكل قديمًا؟، ألم يكن ذلك مستخدمًا من قبل؟، ألا يستحسن البحث عن شكل جديد؟. فى تلك الحالات كنت أتذكر أن محمد عبدالوهاب ألف موسيقاه فى كل الأشكال منذ أن بدأ حياته الفنية بالالتحاق بفرقة فوزى الجزايرلى عام ١٩١٧، ثم درس العود فى معهد الموسيقى العربية، وحلق فى سماء الإبداع، وكان فى طفولته يهرب من والده الشيخ المؤذن محمد أبوعيسى إلى الموالد والأفراح، ليستمع إلى الشيوخ والمطربين، فتطارده أسرته من مكان إلى آخر، فيهرب مع فرقة سيرك إلى دمنهور، وحين يجد والده أنه لا فائدة من قمع الطفل الموسيقى يلحقه بفرقة عبدالرحمن رشدى المحامى، لأنها على الأقل «فرقة محترمة».
وقد عاصر عبدالوهاب سيد درويش الذى أثنى عليه وتنبأ له بمستقبل واعد، وعاصر بالطبع القصبجى والسنباطى، ثم المدرسة الموسيقية اللاحقة من شباب الأربعينيات، ثم الستينيات مثل الموجى والطويل وغيرهما، واستطاع عبدالوهاب أن يستوعب كل تلك التيارات، ويبتلعها متقدمًا إلى الأمام. وخلال رحلته الطويلة تلك، لم يأبه عبدالوهاب بقضية الشكل، هل هو قديم أم حديث، بل بحث عما يناسب ما يريد هو التعبير عنه. هكذا ألف الموشحات «مضناك جفاك مرقده»، والأغانى الحوارية مثل «طبيب عيون»، والطقطوقة، والمونولوج الغنائى، والقصيدة، والأغانى الثنائية، وقدم إيقاع الفالس فى قصيدة الجندول ١٩٤١، وكتب الأناشيد الوطنية، والموسيقى البحتة للأفلام والرقصات، ولم يدع شكلًا إلا وأبدع فيه دون خوف من الشكل الفنى.
وبفضل محمد عبدالوهاب أدركت أنه لا يجب على الكاتب أن يخشى الشكل، لأن الموضوع هو الذى يختار شكله. هؤلاء هم الموسيقيون الثلاثة الذين أدين لهم بتعلم بعض القضايا الرئيسية فى عالم الأدب، وقد علمونى بحيث إننى لا أنسى فضلهم، وأظل أحتفظ بصورهم وأغنياتهم عرفانًا بالفضل ومحبة لما قدموه.